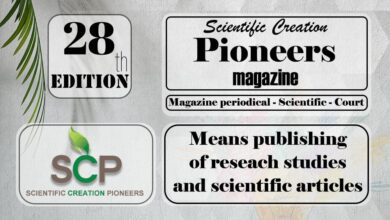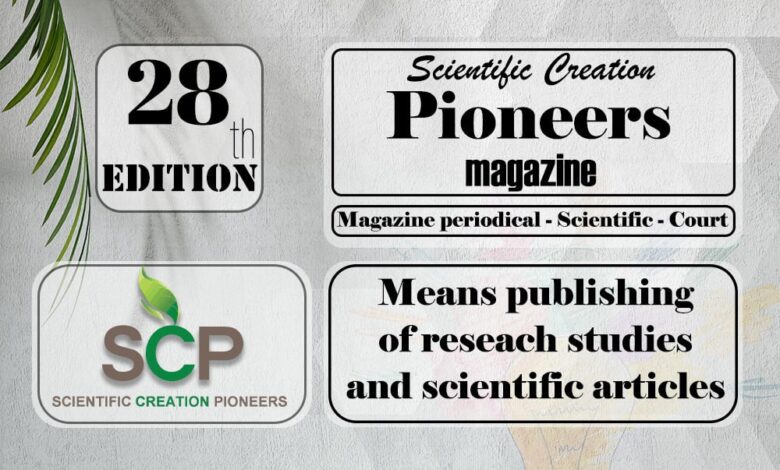
مخالفة الرسم في القراءات الشاذة، ضوابطه وآثاره،كتاب التلخيص للكواشي أنموذجًا
المستخلص
هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على الركن الثاني من أركان القراءات الصحيحة، وهو موافقة الرسم العثماني، جمعت القراءات التي خالفت الرسم من أول سورة الفاتحة حتى الآية 61 من سورة البقرة.
وسؤال البحث: ما القراءات الشاذة الواردة في كتاب التلخيص التي خالفت رسم المصحف؟ وما أثر ذلك على الحكم على القراءة؟
وقسَّمتُ البحث إلى مقدمة وتمهيد عن القراءات الشاذة وعن مخالفة رسم المصحف.
ثم في الدراسة التطبيقية عرضت للقراءات التي خالفت رسم المصحف، وقمت بعزوها وتوجيهها، وهدفي في ذلك البحث عن ضوابط مخالفة المصحف وأثره في الحكم على القراءة.
وبعد دراسة للقراءات التي خالفت رسم المصحف، وجد الباحث أن صور هذه المخالفة هي: استبدال كلمة بأخرى، وهي أكبر درجات الشذوذ، وبلغت 50 % من نسبة القراءات المدروسة، استبدال حرف بآخر. وبلغت 12.5 % من نسبة القراءات المدروسة، التبادل بين الضمائر بين الإفراد وجمع المؤنث. عرضها وعرضهن، وبلغت 12.5 % من نسبة القراءات المدروسة، تبادل الموقع بين القاف والعين. الصواقع، وبلغت 12.5 % من نسبة القراءات المدروسة، زيادة ياء لم يحتملها وبلغت 12.5 % من نسبة القراءات المدروسة.
ثم خاتمة فيها أهم النتائج وثبت بالمصادر والمراجع، وفهرست بالموضوعات.
واعتمدت فيه على المنهج الإحصائي الوصفي التحليلي النقدي القائم على الجمع والدراسة ، ويوصي الباحث بدراسة باقي الأركان على سائر القراءات في التفسير، وعلى سائر كتب التفاسير.
الكلمات المفتاحية: القراءات الشاذة، رسم المصحف، توجيه القراءات، التفسير، التلخيص، الكواشي.
Violating the drawing in irregular readings, its controls and effects, the book of summary by Al-Kawashi as an example
Abstract
This study aims to shed light on the second pillar of the correct readings, which is conformity with the Uthmanic drawing. It collected the readings that violated the drawing from the beginning of Surat Al-Fatihah until verse 61 of Surat Al-Baqarah. The research question: What are the abnormal readings mentioned in the Book of Summary that violate the script of the Qur’an? What effect does this have on the judgment of reading?
I divided the research into an introduction and a preface about irregular readings and violations of the Qur’an’s design. Then, in the applied study, I presented the readings that violated the instructions of the Qur’an, and attributed and directed them. My goal in that was to search for the controls of violating the Qur’an and its impact on judging the reading. After studying the readings that violated the pattern of the Qur’an, the researcher found that the forms of this violation are: replacing one word with another, which is the largest degree of abnormality, and amounted to 50% of the percentage of readings studied, replacing one letter with another. 12.5% of the studied readings included the exchange between singular and feminine plural pronouns. Their presentation and presentation, and amounted to 12.5% of the percentage of readings studied, the location was exchanged between the Qaf and the Ayn. Al-Salak, which amounted to 12.5% of the percentage of readings studied, an increase that J could not bear and amounted to 12.5% of the percentage of readings studied. Then a conclusion containing the most important results, supported by sources and references, and an index of topics. It relied on the statistical, descriptive, analytical, and critical approach based on collection and study, and the researcher recommends studying the rest of the pillars on all other readings in interpretation, and on all other books of interpretations
Keywords: irregular readings, drawing the Qur’an, directing the readings, interpretation, summary, and Quashi.
مقدمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من تنزلت ببعثته الرحمات، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى والنجوم النيرات.
أما بعد
فإن القرآن الكريم قد نزل على الرسول فخاطب به أمة كانت متعددة اللهجات، لقد كانت القبائل العربية تتحدث العربية بلهجات مختلفة. ولم يستطع الرسول الكريم أن يغير لهجات هذه القبائل بين يوم وليلة، فهذا من غير المعقول.
وعليه جاءت القراءات القرآنية جامعة في طياتها اللهجات المتنوعة لقبائل العرب.
ثم نشأ علم القراءات القرآنية، وبرزت جهود متضافرة من علماء الأمة لدراستها.
وهذا بحث بعنوان: مخالفة الرسم في القراءات الشاذة، ضوابطه وآثاره، كتاب التلخيص للكواشي أنموذجًا
أهمية البحث:
- أنه متعلق بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم، مصدر التشريع.
- إسهام القراءات الشاذة في الجوانب اللغوية والنحوية والبلاغية، التي تبين ما تمتاز به اللغة العربية من خصائص لا تتوفر في غيرها.
- أن مصطلح الشذوذ في القراءات مستغلق أمره، وغامض مفهومه، فبينت مفهومه وطبقت ذلك على ما أوردته من قراءات شاذة.
- أن العلماء السابقين نصوا على القراءات الشاذة، وفي أغلبها لم يبينوا أسباب الشذوذ، والبحث حرص على هذه النقطة.
- في هذا البحث إلقاء الضوء على الركن الثاني من أركان القراءة الصحيحة وهو موافقة الرسم العثماني.
أهداف البحث:
- تعريف القراءات الشاذة.
- تعريف مخالفة الرسم.
- تجميع القراءات الشاذة التي خالف الرسم.
- توجيه هذه القراءات لغويًا.
- البحث عن صور مخالفتها للرسم.
- بيان أثر هذه الصور لمخالفة الرسم على الحكم على القراءات الشاذة.
خطة البحث:
قسَّمتُ البحث إلى مقدمة، وفيها: وأهمية الموضوع، وخطة البحث ومنهجه.ثم تمهيد، وفيه التعريف بالقراءات الشاذة، وبمخالفة الرسم العثماني، ثم فصل تطبيقي عرضت فيه للقراءات التي خالفت الرسم في كتاب التلخيص، ثم خاتمة وفيها أهم النتائج.
منهج البحث:
سأتبع في هذا البحث المنهج الإحصائي الوصفي التحليلي النقدي القائم على الجمع والدراسة وفق الخطوات التالية:
أولاً: رتَّبت مواضع القراءات الشاذة محل الدراسة التي خالفت الرسم حسب ترتيب سورها وآياتها في المصحف الشريف.
ثانيا: كتبت الآية القرآنية التي فيها القراءات الشاذة بالرسم العثماني.
ثالثاً: أثبتُ ما قاله الإمام الكَواشي من كتاب (التلخيص في تفسير القرآن العزيز) في الآية المذكورة من قراءات شاذة.
رابعاً: استخرجت القراءات الشاذة من كلام الإمام الكَواشي المنقول، وأصفتُها ليتبيَّن الفرق بينها وبين المتواتر.
خامساً: عزوت القراءات الشاذة إلى كل من نُسبت له في المصادر المعتنية بالقراءات الشاذة، وحاولت الاستقصاء ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
سادساً: أعربت عن وجه شذوذ القراءة.
سابعاً: وجهت القراءة مستعيناً بكتب توجيه القراءات، وكتب التفسير، ومعاني القرآن، والأعاريب، والمعاجم، وسؤال المختصين، بحسب ما اقتضته الحاجة.
ثامنًا: والتزمت بالموضوعية البعيدة عن أي هوى أو عصبية عند الاختلاف في الحكم على القراءة.
تاسعًا:
وتم ما سبق وفق الخطوات المنهجية العامة التالية:
- كتبتُ الآيات القرآنية بالرسم العثماني.
- وضعت الآيات القرآنية بالقراءات المتواترة بين قوسين مزهرين ﴿﴾، ووضعت القراءات الشاذة بين قوسين هلالين ( ).
- اعتمدت في ذكر الآيات على العدّ الكوفي.
- وثقت النقول والأقوال من مصادرها الأصيلة.
تمهيد: مفهوم القراءات الشاذة
ويشمل عددًا من النقاط، وهي:
- مفهوم القراءات الشاذة لغة واصطلاحًا.
- مفهوم مخالفة رسم المصحف العثماني.
أولًا: مفهوم القراءات الشاذة لغة واصطلاحًا
مفهوم القراءات لغة واصطلاحًا:
القراءات جمع (قراءة), وهي في اللغة مصدر بمعنى التلاوة، ومنه قولنا: قرأتُ الكتابَ قراءةً وقُرْآنًا، ومنه سمِّي القرآن، وقد تكون بمعنى الجمع، كقولنا: قرأتُ الشيءَ قرآنا: جمعتُه وضممتُ بعضَه إلى بعض([1]).
وفي الاصطلاح: “مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفًا به غيره، في النطق بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروايات والطرق عنه, سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها”([2]).
تعريف الشذوذ لغة: الجذر اللغوي (ش ذ ذ) “يدل على الانفراد والمفارقة، شـذ الـشيء يشذ شذوذاً، وشذاذ الناس الذين يكونون في القــوم وليســـوا مــن قبائلهــم ولا منازلهم، وشذان الحصى المتفرق منه”([3]).
و”شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه، وكذلك كل منفرد فهو شاذ، وشذاذ الناس الذين ليسوا في قبائلهم، وشذاذ الناس متفرقوهم”([4])، و”شذ يشذ شذا وشذوذا: ندر عن الجمهور، والشذاذ القلال، والذين لم يكونوا حيهم ومنازلهم”([5]).
و”شذذ شذ عنه يشذ ويشذ : انفرد عن الجمهور، وندر فهو شاذ، وأشذه غيره .. وشذان الحصى ما تطاير منه”([6]).
من هذا يتبين أن هذه المادة (ش ذ ذ) يدور معناها حول المعاني التالية:
- التفـرد والتفرق.
- الغرابة والندرة والتشريد.
- القلة.
- المخالفة.
فالقراءة الشَّاذَّة على هذا المعنى اللغوي هي: القراءة التي انفردت وخرجت عما عليه الجمهور، وهي في الوقت نفسه نادرة وغريبة.
وإذا كان الاصطلاح مواضعة جماعية، أملتها ظروف زمانية ومكانية بقصد التواصل والفهم والإفهام، فإن الشذوذ من حيث هو مصطلح، لا يخرج عن كونه له دلالة لغوية ما، وجاءت العلماء بعدُ، فأخرجته من معناه اللغوي الأعم، واستعملته في علوم شتى بمعنى أخص، وتواضعت على ذلك.
فالقراءة الشاذة إذن هي كل قراءة فقدت أحد أركان القراءة الصحيحة الثلاثة التي سنذكرها بعد قليل. وكفى بهذه التسمية – أي: الشاذ – تنبيهًا على انفراد الشاذ وخروجـه عمـا عـلـيـه الجمهور ([7]).
ثانيًا: مفهوم مخالفة رسم المصحف العثماني
أصبحت موافقة خط المصحف العثماني أحد أركان القراءة الصحيحة، وما خالفها عُدّ شاذًا، قال ابن الجزري: “ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم فهذه القراءة تسمى شاذة، ولا يجوز القراءة بها”([8]).
ولا تعني موافقة الرسم جواز القراءة بأي وجه يوافقه، فيجب أن تكون تلك الأوجه صحيحة من حيث الرواية؛ لئلا يعمد بعض القراء فيُصحف أو يُحرف بحجة موافقة القراءة لخط المصحف الإمام.
ومن أمثلة ما صح نقله عن الآحاد، وصح في العربية، وخالف لفظه خط المصحف قراءة ابن مسعود وغيره: (والذكر والأنثى) في قوله تعالى: ﵟوَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ﵞ [الليل: 3]([9]).
تنبيه: لا يُعد ما وقع من اختلاف في المصاحف العثمانية من باب الخروج عن رسم المصحف العثماني؛ لأنه مجمع عليه، وإنما يُعد ما خرج على هذه المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار شاذًا؛ لمخالفته الرسم المجمع عليه.
وقد علّق الفراء أكثر من مرة على قراءة مخالفة لرسم المصحف بقوله: ” ولست أشتهي ذلك ولا آخذ به. اتباع المصحف إذا وجدت له وجها من كلام العرب وقراءة القراء أحب إلي من خلافه”([10]).
الدراسة التطبيقية
وفيه ذكرت المواضع التي وردت فيها قراءات شاذة خالفت رسم المصحف، وهي:
الموضع الأول: ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ [سورة الفاتحة:4]
قال الإمام الكواشي (“وقرئ: ….ومليك رفعاً ونصباً وجراً”).([11])
عزو القراءة الشاذة:
قرأ عمرو بن العاص (مليكُ) على وزن (فعيل) إلَّا أنَّه ضم الكاف، و (مليكَ) بالنصب، وقرأ أبو هريرة، والحسن، وأبيّ بن كعب، وأبو رجاء العطاردي (مليكِ) بالجر([12]).
التوجيه:
(مليك، رفعاً ونصباً وجراً): بالرفع والنصب والجر على وزن فعيل، وجمع (مليك) مُلَكاء، وهذه القراءات: هي عبارة عن لهجات للعرب في هذه الكلمة، ولكل قبيلة لهجتها الخاصة بها.([13])
قال العكبري: ” و(مليك) بالياء أبلغ من (مالك)، وكذلك كل فعيل يجوز فيه فاعل، فعيل أبلغ”([14]).
جمعت المزاوجة بين الحدوث والتكرار، فالقراءة المتواترة باسم الفاعل تدل على أنه مالك يوم الدين الآتي.
والقراءة بصيغة المبالغة تدل على كثرة الملك في هذا اليوم، لذا فهي أبلغ كما سبق في كلام العكبري.
لكن القراءات المتواترة ليست بصيغة اسم الفاعل فقط، بل جاءت بصيغة الصفة المشبهة أيضًا في قراءة (مَلِكِ) التي تدل على الثبات، فالثبات مع الحدوث من أكمل الأوصاف، وأفادت القراءة الشاذة الكثرة.
وجه شذوذ القراءات الواردة:
القراءة بالياء (مليك) سبب شذوذها ظاهر، وهو مخالفة الرسم، قال ابن خالويه: “ولم يقرأ به أحد لأنه يخالف المصحف ولا إمام له”([15]).
قال ابن الجزري: “وهي موافقة للرسم أيضا كتقدير الموافقة في جبريل وميكائيل بالياء والهمزة وكقراءة أبي عمرو (وأكون من الصالحين) بالواو”([16]).
قال الآركاتي: ” والرسم يحتمل جميع الوجوه إلا (مليك)، وإن تكلف الجزري توفيقه بحمله على (جَبْرَئل)، وليس بظاهر”([17]).
تعقيب:
تمثلت مخالفة الرسم في هذا الموضع في زيادة ياء لم يحتملها الرسم.
الموضع الثاني: القراءات الشَّاذَّة في قوله تعالى: ﵟصِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَﵞ الفاتحة آية7.
قال الكَواشي: “وقرئ: ﴿وغَيۡرِ ٱلضَّآلِّينَ ﴾ “.([18])
عزو القراءة الشاذة:
(غيرِ الضالين): قرأ بها عمر، وعليّ، وأُبيّ بن كعب رضي الله عنهم ([19]).
توجيه القراءة الشاذة:
(غير الضالين): دلَّت على أن المغضوب عليهم هم غير الضَّالين، وأنَّ (غير) بمعنى النفي، ولو ذُكرت (غير) بدلاً لـ (لا) فهي أيضاً لتأكيد النفي([20]).
وجه القراءة الواردة:
شذّت هذه القراءة لمخالفتها الركن الثالث من أركان القراءة المقبولة، وهو موافقة الرسم العثماني ولو تقديرا؛ مما أدى إلى شذوذها.
تعقيب:
تمثلت مخالفة الرسم في هذا الموضع في زيادة كلمة غير موجودة في الرسم العثماني.
الموضع الثالث: قوله تعالى: ﵟأَوۡ كَصَيِّبٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٞ وَرَعۡدٞ وَبَرۡقٞ يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَﵞ [سورة البقرة:19].
قال الكَواشي: “وقرئ: (الصواقع) لغتان.([21])
عزو القراءة الواردة:
_ (الصواقع): قرأ بها الحسن ([22]).
التوجيه:
وردت كل من (الصواعق)، و(الصواقع) في معاجم اللغة في مادتين مختلفتين ، فالأولى مادتها (ص ع ق)، والثانية (ص ق ع)، وهذا الاختلاف بينهما في المادة اللغوية ترتب عليه اختلاف المعنى وتنوع الدلالة، وهذا ما تؤكده لنا المعاجم اللغوية:
يقول ابن فارس في (صعق): “الصاد والعين والقاف أصل واحد يدل على صلقة وشدة صوت، من ذلك الصعق، وهو الصوت الشديد. يقال: حمار صعق الصوت، إذا كان شديده. ومنه الصاعقة، وهي الوقع الشديد من الرعد. ويقال إن الصعاق الصوت الشديد. ومنه قولهم: صعق، إذا مات، كأنه أصابته صاعقة”([23]).
والصواعق: الصوت الشديد من الرعدة يسقط معها قطعة نار([24])
ويقول أيضًا في (صقع): «الصاد والقاف والعين أصول ثلاثة: أحدها: وقع شيء على شيء، كالضرب ونحوه، والآخر: صوت، والثالث: غشيان شيء لشيء.
فالأول: الصقع وهو الضرب ببسط الكف. يقال: صقعه صقعًا، وأما الصوت فقولهم صقع الديك يصقع … وأما الأصل الثالث في غشيان الشيء الشيء … ومن الباب الصاقعة، فممكن أن تسمى بذلك لأنها تغشى. وممكن أن يكون من الضرب ([25]).
وفي اللسان: “صَقَعَه يَصْقَعُه صَقْعًا: ضربه ببسْط كفِّه. وصَقَع رأْسَه: علاهُ بأَيِّ شيء”([26]).
وعلى الرغم من وجود اختلاف في المعنى بين القراءتين، إلا أنهما يتلاقيان: فالصواعق تصور لنا شدة الصوت الصادر من الرعد، والصواقع تصور لنا هذه الأصوات وهي تضرب في آذانهم وتغشاهم. ولهذا نجد القرآن الكريم يستخدم لفظة ﵟأَصَٰبِعَهُمۡ ﵞ ولم يقل مثلًا (أناملهم)، مع أن الإنسان إذا أراد أن يسد أذنيه فإنما يضع طرف أصبعه أو أنمله ـ وذلك مبالغة في تصوير تأثير الرعد عليهم. فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل إصبعه في أذنه. ليحميه من هذا الصوت المخيف. فكأنهم يبالغون في خوفهم من الرعد([27]).
وهذا دليل على أن صوت الصاعقة مزعج قد يخرق طبلة الأذن، ودليل على أن ازعاج الصاعقة فوق طاقة الانسداد بطرف الأصبع. فقد بلغ من شدة ازعاج الصوت أنهم كلما وضعوا أناملهم في آذانهم لم يمتنع الصوت المزعج([28]).
وجه شذوذ القراءة الواردة:
شذَّت هذه القراءة بسبب مخالفتها الركن الأساس وهو الشهرة والاستفاضة، فحكم عليها بالشذوذ، ومخالفة الرسم العثماني.
تعقيب:
تمثلت مخالفة الرسم في هذا الموضع في تبادل الموقع بين القاف والعين.
الموضع الرابع: القراءات الشَّاذَّة في قول الله تعالى: ﵟيَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَﵞ [سورة البقرة آية 21].
قال الكَواشي: “وقرئ: (وخلق من قبلكم)،”([29]).
عزو القراءة الشاذة:
_ (الذي خلقكم وخلق من قبلكم): قرأ بها ابن السميفع اليماني، وطلحة ([30]).
توجيه القراءة الشاذة:
(الذي خلقكم وخلق من قبلكم): جعله على العطف.([31])
وجه شذوذ القراءة الشاذة:
شذَّت هذه القراءة بسبب مخالفتها الركن الثالث من أركان القراءة المقبولة وهو موافقة الرسم العثماني ولو تقديرًا؛ مما أدى إلى شذوذها وقلة نقلها عند القراء.
تعقيب:
تمثلت مخالفة الرسم في هذا الموضع في زيادة كلمة غير موجودة في الرسم، وهي كلمة (وخلق).
الموضع الخامس: القراءات الشَّاذَّة في قول الله تعالى: ﵟوَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَﵞ [سورة البقرة آية31].
قال الكَواشي: “وقرئ: (عرضهن) و(عرضها)، أي المسميات؛ لأنَّ عرض الأسماء لا يصح، والعرض: إظهار الشيء، وأن تمر به عرضًا لتعرف حاله”.([32])
عزو القراءتين الشاذة:
_ (عرضهن بجمع المؤنت): قرأ بها عبد الله بن مسعود ([33]).
_ (عرضها بالإفراد): قرأ بها أُبيّ بن كعب ([34]).
التوجيه:
اختلفت القراءات بين إفراد الضمير المنصوب المسند إليه الفعل، وبين جمعه جمع مذكر للعقلاء، وجمعه جمع مؤنث.
أما القراءتان الشاذتان بالإفراد وجمع المؤنث ففيه وجهان:
أحدهما: أنه أعاد الضمير على الأسماء، وهي جمع تكسير لمؤنث غير عاقل، وفي ضميره وجهان جائزان: أن يكون مفردًا مؤنثًا، وأن يكون نون النسوة الدالة على جمع الإناث. نحو: (الكتُب نفعت) أو: نفعْن، والجذوع انكسرت، وكسرتها، أو انكسرن وكسرتهن([35]).
الثاني: أنه أراد أشخاص ومسميات تلك الأسماء، وفي تلك المسميات العقلاء وغيرهم، فغلب غير العقلاء، ولهذا جاء الضمير مؤنثًا مفردًا ومجموعًا.
وأما قراءة الجمهور بجمع المذكر للعقلاء: فلأنه أراد الأشخاص والمسميات وهي إما للعقلاء فقط فيكون إذ ذاك المعني بالأسماء أسماء العاقلين، أو يكون فيهم غير العقلاء وغلب العقلاء([36]).
وجه شذوذ القراءة الواردة:
شذَّت هذه القراءة بسبب مخالفتها الركن الأساس وهو الشهرة والاستفاضة، ومخالفتها رسم المصحف، فحكم عليها بالشذوذ.
تعقيب:
تمثلت مخالفة الرسم في هذا الموضع في التبادل بين الضمائر بين الإفراد وجمع المؤنث.
الموضع السادس: القراءات الشَّاذَّة في قول الله تعالى: ﵟوَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَﵞ [سورة البقرة آية48].
قال الكَواشي: “وقرئ: (نسمة عن نسمة)”.([37])
عزو القراءة الشاذة:
نسمة عن نسمة: قرأ بها أبو السوار الغنوي ([38]).
توجيه القراءة الشاذة:
يقول الآلوسي: “وهي بمعنى النفس”([39]).
ويؤكد هذا الترادف ما ورد في المعاجم اللغوية من معنى كل منهما: فالنَّفْس هي الروح أو ذات الإنسان وحقيقته: يقول الخليل بن أحمد: “النفْس: الروح الذي به حياة الجسد، وكل إنسان نفْس حتى آدم ، الذكر والأنثى سواء. وكل شيء بعينه نفْس”([40]).
ويقول ابن سيده: «النفْس في كلام العرب تجري على ضربين: أحدهما قولك: خرجت نفْس فلان وفي نفْس فلان يفعل كذا وكذا، والضرب الآخر معنى النفْس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته، تقول: قتل فلان نفْسه وأهلك نفْسه، أي: أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته»([41]).
فالنسمة تعني: النَّفَس بفتح الفاء يخرج من الريح الضعيفة، وتطلق أيضا على النفْس بسكون الفاء.
يقول ابن فارس: «النون والسين والميم أصل صحيح يدل على خروج نَفَس، أو ريح غير شديدة الهبوب. ونَفَس الإنسان نسيم. وكذا الريح اللينة الهبوب. ويقولون: من أين منسمك؟ أي من أين وجهتك. والقياس واحد؛ لأنه إذا أقبل أقبل نسيمه. ولذلك سميت النَّفْس نسمة»([42]).
ويقول الفيومي:«النسيم نَفَس الريح والنسمة مثله ثم سميت بها النفس بالسكون والجمع نسم مثل قصبة وقصب. والله بارئ النسم، أي: خالق النفوس»([43]).
وجه شذوذ القراءة:
شذَّت هذه القراءة بسبب مخالتها الركن الثاني من أركان القراءة المقبولة وهو موافقة الرسم العثماني ولو تقديرا؛ مما أدى إلى شذوذه.
قال الآركاتي: ” ولا يحتملها الرسم”([44]).
تعقيب:
تمثلت مخالفة الرسم في هذا الموضع في استبدال كلمة بأخرى.
الموضع السابع: القراءات الشَّاذَّة في قول الله تعالى: ﵟوَإِذۡ نَجَّيۡنَٰكُم مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ يَسُومُونَكُمۡ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمۡۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٞ مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِيمٞﵞ [سورة البقرة آية 49].
قال الكَواشي: ” … وقرئ: (يقتلون)” ([45]).
عزو القراءة الشاذة:
(يذْبحون بفتح الياء وسكون الذال وفتح الباء): قرأ بها الزهري، وابن محيصن، وزيد بن علي ([46]).
(يقتلون): قرأ بها ابن مسعود ([47]).
توجيه القراءة الشاذة:
_ (يقتلون، بالتشديد):
وجَّهها أبو حيَّان في البحر المحيط: “يُقَتِّلون بالتشديد مكان يذبحون، والذبح قتل”.([48])
وجه شذوذ القراءتين:
شذَّت قراءة (يقتِّلون) بسبب مخالتها الركن الثالث من أركان القراءة المقبولة وهو موافقة الرسم العثماني ولو تقديرا؛ مما أدى إلى شذوذها.
تعقيب:
تمثلت مخالفة الرسم في هذا الموضع في استبدال كلمة بأخرى.
الموضع الثامن: القراءات الشَّاذَّة في قول الله تعالى: ﵟوَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصۡبِرَ عَلَىٰ طَعَامٖ وَٰحِدٖ فَٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُخۡرِجۡ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ مِنۢ بَقۡلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاۖ قَالَ أَتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدۡنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيۡرٌۚ ٱهۡبِطُواْ مِصۡرٗا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلۡتُمۡۗ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَﵞ [سورة البقرة آية61].
قال الكَواشي: “وقرئ: (وثومها)”.([49])
عزو القراءة الواردة: قرأ بها الأعمش عن علقمة عن ابن مسعود، وابن عباس ([50]).
توجيه القراءة الشاذة:
وردت القراءة الشاذة (وثومها) بالثاء، وقد أبدلت فاء في القراءة المتواترة، وساغ إبدال الثاء فاء لما بين الحرفين من تقارب في المخرج والصفة.
فأما التقارب في المخرج فنرى الثاء تخرج مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، والفاء تخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى([51]).
وأما التقارب في الصفة فإن الثاء: «صوت مهموس، رخو (احتكاكي)، مستفل، منفتح، مصمت، خفي، والفاء: «صوت مهموس، رخو، مستفل، منفتح، ذلق، خفي»([52]).
فكلا الصوتين يشترك في جميع الصفات فيما عدا صفة واحدة هي الإصمات في الثاء والذلاقة في الفاء، فهما متقاربان مخرجًا وصفة.
وقد اختلف العلماء في تفسير معنى (الفوم) على أقوال ستة([53]):
أحدها: قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسُّدِّي: أنه الحنطة. ووافقهم في ذلك الزجاج حيث يقول: “الفوم: الحنطة، ويقال الحُبوب، وقال بعض النحويين إِنه يجوز عنده (الفُومُ) ههنا (الثوم)، وهذا ما لا يعرف أن الفوم الثوم، وههنا ما يقطع هذا. محال أن يطلب القوم طعامًا لا بُرَّفيه، والبرُّ أصل الغذاءِ كله، ويقال: فوِّمُوا لنا، أي: اخْبِزُوا لنا، ولا خلاف عند أهل اللغة أن الفُوم الحنطة، وسائر الحبوب التي تخبز يلحقها اسم الفوم”([54]).
وممن ذهب إلى ذلك أيضًا ابن جني حيث يرى أن الفاء ليست مبدلة من الثاء؛ لأن اتحاد المعنى شرط عنده في الإبدال قال: «وذهب بعض أهل التفسير ف يقوله عز اسمه: [وَفُومِهَا] إلى أنه أراد الثوم، فالفاء على هذا بدل عنده من الثاء. والصواب: أن الفوم الحنطة وما يختبز من الحبوب، يقال: فومت الخبز، أي: خبزته، وليست الفاء على هذا بدلًا من الثاء»([55]).
ثانيها: أنه الثَّوم، وهو قول الكسائي والنضر بن شميل([56]).
ثالثها: أنه الحبوب كلها.
رابعها:أنه الخبز، قاله مجاهد وابن عطاء وابن زيد.
خامسها: أنه الحمص.
سادسها: أنه السنبلة.
وقد رجح الدكتور أحمد علم الدين الجندي القول الثاني وهو أن المراد الثوم؛ مستدلًا بورودها بالثاء في كثير من اللغات، فالثوم في العبرية وبالآرامية ـ توما بالشين والتاء الناشئتين عن الثاء. وقد رد على ابن جني بقوله: «ولهذا جانب ابن جني الصواب، حيث قال: والصواب عندنا: أن الفوم الحنطة، وكأنه يرى الفاء أصلًا، وليست بمبدلة من الثاء، والحق أن إبدال الفاء من الثاء كثير في تاريخ اللغات»([57]).
والقول بالإبدال ـ كما قال الدكتور أحمد علم الدين ـ أولى وأرجح ، وذلك للأسباب الآتية:
1ـ أن قراءة ابن مسعود جاءت بالثاء.
2ـ أن الثوم أوفق للعدس والبصل.
3ـ أنه لو كان المراد الحنطة لما قال ﵟأَتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدۡنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيۡرٌۚﵞ والحنطة هي أشرف الأطعمة([58]).
4ـ أنه ورد عن العرب إبدال الفاء من الثاء في أمثلة أخرى، يقول الفراء: والعرب تُبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدث وجَدَفٌ، ووقعوا فِي عاثُور شَرٍّ وعافُور شرٍّ، والأثاثي والأثافيّ. وسمعت كثيرًا من بني أسد يسمّي (المغافير: المغاثير)»([59]).
وورد ذلك في شعرهم من ذلك قول أمية ابن أبي الصلت:
«كانت منازلهم إذ ذا كظَاهِرَةً *** فِيهَا الْفَرَادِيسُ وَالْفُومَانُ وَالْبَصَلُ»([60]).
وقول حسَّان:
«وَأَنْتُم ْأُنَاسٌ لِئَامُ الْأُصُولِ *** طَعَامُكُمُ الْفُومُ وَالْحَوْقَلُ
يَعْنِي الثُّومَ وَالْبَصَلَ»([61]).
وفي هذا الإبدال نوع من السهولة بإحلال الصوت الأمامي وهو الفاء في محل ما هو أسبق منه في المخرج وهو الثاء([62]).
هذا وقد نسب الفيومي النطق بالثاء إلى أهل تهامة وبالفاء إلى نجد فقال: «الْجَدَثُ الْقَبْرُ، والْجمع أَجداث، مثل: سبب وأَسباب، وهذه لغة تِهامة،وأَمَّا أَهل نجْد فيقولون (جَدَفٌ) بالفاء»([63]).
وجه شذوذ القراءة:
شذَّت هذه القراءة بسبب مخالتها الركن الثاني من أركان القراءة المقبولة وهو موافقة الرسم العثماني ولو تقديرا؛ مما أدى إلى شذوذه.
قال الآركاتي: ” ولا يصلح له الرسم”([64]).
تعقيب:
تمثلت مخالفة الرسم في هذا الموضع في استبدال حرف بآخر.
الخاتمة، وفيها أهم النتائج
فقد انتهيت بفضل الله ومنته من هذا البحث المتواضع، أسأل الله تعالى أن يجعل عملي فيه خالصًا لوجهه تعالى وأن يمن علي فيه بالقبول؛ إنه تعالى أكرم مسؤول وأرجى مأمول.
- ظهر أن بعض القراءات الشاذة التي جاءت مخالفة لرسم المصحف، هي من قبيل التفسير.
- احتفظت القراءات الشاذة ببعض اللهجات التي لم يرد ذكر لها في المعاجم الكبرى.
- كتاب التلخيص ثروة تفسيرية جمعت الكثير من القراءات المتواترة والشاذة مع توجيهها.
- معنى مخالفة القراءة الشاذة للرسم المجمع عليه: أن تكون على خلاف جميع المصاحف العثمانية، بزيادة أو نقص أو إبدال.
- أوضح البحث اشتمال القراءات على فروق دلالية ناتجة عن اختلاف المادة وأخرى عن اختلاف الحركة، وثالثة على اختلاف الصيغة، وهي على الرغم من اختلافها، إلا أن بعضها يجمعها قرب المعنى، وبعضها الآخر يظهر قيمة القراءات القرآنية في تعدد المعنى وتنوعه.
- بعد دراسة للقراءات التي خالفت رسم المصحف، وجد الباحث أن صور هذه المخالفة هي:
- استبدال كلمة بأخرى، وهي أكبر درجات الشذوذ، وبلغت 50 % من نسبة القراءات المدروسة.
- استبدال حرف بآخر. وبلغت 12.5 % من نسبة القراءات المدروسة.
- التبادل بين الضمائر بين الإفراد وجمع المؤنث. عرضها وعرضهن، وبلغت 12.5 % من نسبة القراءات المدروسة.
- تبادل الموقع بين القاف والعين. الصواقع، وبلغت 12.5 % من نسبة القراءات المدروسة.
- زيادة ياء لم يحتملها وبلغت 12.5 % من نسبة القراءات المدروسة.
المصادر والمراجع
- إعراب القراءات الشواذ، لأبي البقاء العُكْبَري (ت 616 ه)، تح: د/ محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، ط 1، 1417 ه.
- إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت 338هـ)، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة: الأولى، 1421 هـ.
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله (ت 370هـ)، الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية (1360هـ -1941م).
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف: الإمام البيضاوي (685هـ) ، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ـ دار إحياء التراث العربيـ بيروت ـ طـ 1: ( 1418 هـ).
- البحر المحيط (في التفسير)، محمد بن يوسف، الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت 754 هـ)، بعناية: صدقي محمد جميل العطار وآخرين، الناشر: دار الفكر – بيروت، عام النشر: 1420 هـ – 2000 م.
- تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: الإمام مرتضى الزَّبيدي (1205هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين ـ دار الهداية.
- تفسير الإمام الشعراوي تأليف: الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي (1418هـ) ، مطابع أخبار اليوم ـ عام النشر: (1997 م).
- التلخيص في تفسير القرآن العزيز، تأليف الإمام العالم/ أبي العباس الكُوَاشي أحمد بن يوسف بن الحسين (680 ه)، تحقيق دكتور/ عماد قدري العياضي، دار البشير الإمارات، ودار ابن حزم ، ط1، 2019م.
- تهذيب اللغة، الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي ، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، 2001م.
- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري (ت671ه)، تح: أحمد عبدالعليم البردوني، أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، دار الكاتب العربي – القاهرة، 1387هـ-1967م، ط 3.
- جمال القُرّاء وكمال الإقراء، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي (ت643هـ)، تحقيق: د. مروان العطيَّة (ت 1444 هـ)- د. محسن خرابة (ت 1440 هـ)، الناشر: دار المأمون للتراث – دمشق – بيروت، ط: 11418 هـ – 1997 م.
- الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف، تح: د/ أحمد محمَّد الخرّاط، دار القلم، دمشق، 1406هـ-1986م.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي (ت:1270هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية ـ طـ الأولى: دار الكتب العلمية – بيروت، (1415هـ).
- سر صناعة الإعراب ـ تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (392هـ)، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ـ ط: 1(1421هـ = 2000م).
- شواذ القراءات تأليف: الشيخ رضيّ الدين محمد بن أبي نصر الكرماني من علماء القرن السادس الهجري (ص: 63)ـ تحقيق: شمران العَجلي ـ مؤسسة البلاغ ـ بيروت ـ لبنان.
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ـ دار العلم للملايين – بيروت ـ الطبعة: الرابعة (1407 هـ – 1987 م).
- عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة ـ تأليف: الأستاذ الدكتور عبد العزيز أحمد علام (د.ت).
- العين – تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (170هـ): (قدر) ـ تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي.
- فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 1250هـ)، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت، ط: 1- 1414 هـ.
- القاموس المحيط ـ تأليف: مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ( 817هـ) ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ـ بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي ـ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان ـ الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005 م.
- الكتاب، سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، تح: عبدالسـلام هارون، الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب، 1395 هـ، 1975م.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 3، 1407هـ.
- الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تأليف: أبي إسحاق محمد بن إبراهيم الثعلبي (427هـ): (1/ 119) – تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور ـ مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان/ط: 1(1422، هـ = 2002 م).
- لسان العرب – تأليف: جمال الدين = = ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ( 711هـ): (س ر ط) ـ طـ الثالثة: دار صادر – بيروت ـ (1414 هـ).
- اللهجات العربية في التراث، تأليف: د. أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب (1983 م).
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت ٣٩٢ هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف – المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، تحقيق: علي النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، عام النشر:١٣٨٦ – ١٣٨٩ هـ، ١٩٦٦ – ١٩٦٩م.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي، تح: عبدالسلام عبدالشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 – 1422هـ.
- المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458هـ)، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2000م.
- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ـ تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي (نحو 770هـ)، المكتبة العلمية – بيروت.
- معاني القرآن – تأليف: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ( 207هـ) ، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي ـ دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر، الطبعة: الأولى.
- معاني القرآن وإعرابه ـ تأليف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج (311هـ)، عالم الكتب – بيروت ـ الطبعة الأولى (1408 هـ = 1988 م).
- معجم القراءات القرآنية، تأليف: أ.د/أحمد مختار عمرـ كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أ.د/عبد العال سالم مكرم ـ قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الكويت، الطبعة الثانية، (1408هـ = 1988م).
- معجم القراءات، تأليف: الدكتور عبد اللطيف الخطيب (1/112) ـ دار سعد الدين ـ دمشق (2000م).
- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرّازيّ(ت395ه) ، تح: عبدالسلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ – 1979م.
- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت 606هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1420 هـ.
- مقاييس الأصالة والفرعية في الإبدال لابن السكيت، تأليف: الأستاذ الدكتور أحمد طه حسانين سلطان، أستاذ أصول اللغة ـ جامعة الأزهر ـ كلية اللغة العربية بالقاهرة ـ دار البشرى للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: (1419هـ = 1999م).
- مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ( 1367هـ): – مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه – الطبعة الثالثة.
- النحو الوافي – تأليف: عباس حسن (1398هـ)، دار المعارف ـ الطبعة: 15.
- نثر المرجان في رسم نظم القرآن، ناصر الملة محمد غوث الآركاتي، تح: د/ خالد حسن أبو الجود، دار اللؤلؤة، ط1، 1442ه.
- النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ( 833 هـ)، تحقيق: علي محمد الضباع ( 1380 هـ) ـ المطبعة التجارية الكبرى.
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي (911هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ـ طـ: المكتبة التوفيقية – مصر
([1]) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1/65، ( ق ر أ).
([2]) مناهل العرفان في علوم القرآن، 1/412.
([3]) ينظر: معجم مقاييس ، (3/ 180) (ش ذ ذ).
([4]) ينظر: تهذيب اللغة، (11/ 271)، (ش ذ ذ).
([5]) ينظر: القاموس المحيط ، (ص: 1355) ـ
([6]) ينظر: لسان العرب ، (٣/ 494-٤٩٥). (ش ذ ذ).
([7]) ينظر: جمال القُرّاء وكمال الإقراء، (١/ ٢٣٤).
([8]) النشر في القراءات العشر 1/60.
([9]) النشر في القراءات العشر 1/7.
([10]) معاني القرآن للفراء، 2/293.
([11]) ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز (1/49).
([12]) ينظر: المحرر الوجيز (1/68)، البحر المحيط (1/36).
([13]) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (13)، البحر المحيط (1/36).
([14]) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (1/92).
([15]) ينظر: إعراب ثلاثين سورة في القرآن، ص23.
([17]) ينظر: نثر المرجان (1/294)
([18]) ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز (1/52).
([19]) ينظر: الكشَّاف (1/30)، المحرر الوجيز (1/78)، شواذ القراءات للكرماني (1/45)، البحر المحيط (1/51).
([20]) ينظر: معاني الزجاج (1/54)، البحر المحيط (1/52).
([21]) ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز (1/67).
([22]) ينظر: مختصر ابن خالويه (11)، إعراب القرآن للنحاس (1/ 34) ، الكشاف (1/55)، المحرر الوجيز (1/102)، شواذ القراءات (1/53)، تفسير البيضاوي (1/ 52) ، البحر المحيط (1/141). معجم الخطيب (1/55)، معجم مختار عمر (1/32).
([23]) مقاييس اللغة (ص ع ق)، وينظر: العين (ص ع ق).
([24]) لسان العرب (ص ع ق)، تاج العروس (ص ع ق).
([27]) ينظر: تفسير الشعراوي (1/ 178).
([29]) ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز (1/71).
([30]) ينظر: الكشاف (1/57)، شواذ القراءات للكرماني (1/54)، البحر المحيط (1/154).
([31]) ينظر: البحر المحيط (1/154).
([32]) ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز (1/84).
([33]) ينظر: معاني القرآن للفراء (1/ 26)، مختصر ابن خالويه (12)، الكشاف (1/17)، المحرر الوجيز (1/120)، شواذ القراءات للكرماني (1/57)، تفسير القرطبي (1/ 283)، البحر المحيط (1/236). الدر المصون (1/ 263)، فتح القدير للشوكاني (1/ 77)، معجم الخطيب (1/75)، معجم مختار عمر (1/42).
([34]) ينظر: معاني القرآن للفراء (1/ 26)، مختصر ابن خالويه (12)، الكشاف (1/17)، المحرر الوجيز (1/120)، شواذ القراءات للكرماني (1/57)، تفسير القرطبي (1/ 283)، البحر المحيط (1/236). الدر المصون (1/ 263)، فتح القدير للشوكاني (1/ 77)، معجم الخطيب (1/75)، معجم مختار عمر (1/42).
([35]) ينظر: همع الهوامع (1/234)، النحو الوافي ، (1/ 264).
([36]) ينظر: معاني القرآن للفراء (1/ 26)، الكشاف (1/ 126)، المحرر الوجيز (1/ 120)، إعراب القراءات الشواذ (1/145)، تفسير القرطبي (1/ 283)، البحر المحيط (1/ 236).
([37]) ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز (1/95).
([38]) ينظر: مختصر ابن خالويه (13)، الكشاف (1/75)، البحر المحيط (1/308). ،روح المعاني (1/ 253)،معجم الخطيب (1/94) )، معجم مختار عمر (1/53).
([41])المحكم والمحيط الأعظم، مادة (ن ف س).
([43]) المصباح المنير مادة (ن س م).
([44]) ينظر: نثر المرجان 1/402.
([45]) ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز (1/97).
([46]) ينظر: مختصر ابن خالويه (13)، إعراب القرآن (1/40)، المحتسب (1/65)، المحكم والمحيط الأعظم (الحاء والذال والباء)، تفسير الثعلبي (1/ 191)، الكشاف (1/76)، المحرر الوجيز (1/140)، شواذ القراءات للكرماني (1/61)، البحر المحيط (1/313). الدر المصون (1/ 346)، معجم الخطيب (1/96)، معجم مختار عمر (1/54).
([47]) ينظر: الكشاف (1/76)، البحر المحيط (1/313).
([48]) ينظر: البحر المحيط (1/313).
([49]) ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز (1/107).
([50]) ينظر: مختصر ابن خالويه (14)، المحتسب (1/74)، الكشاف (1/79)، المحرر الوجيز (1/153)، شواذ القراءات (1/63)، البحر المحيط (1/376).
([51]) ينظر: الكتاب لسيبويه (4/ 433)، سر صناعة الإعراب (1/ 61).
([52]) ينظر: عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة ـ تأليف: الأستاذ الدكتور عبد العزيز أحمد علام (د.ت): (ص: 156، 157).
([54]) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 143).
([55]) سر صناعة الإعراب (1/ 262).
([56]) تفسير القرطبي (1/ 425).
([57]) اللهجات العربية في التراث (2/417).
([59]) معاني القرآن للفراء (1/ 41).
([60]) تفسير القرطبي (1/ 425).
([62]) مقاييس الأصالة والفرعية في الإبدال لابن السكيت (ص: 175).