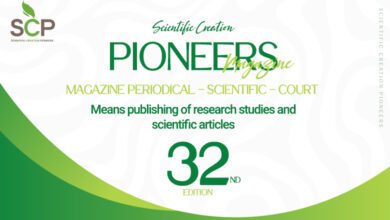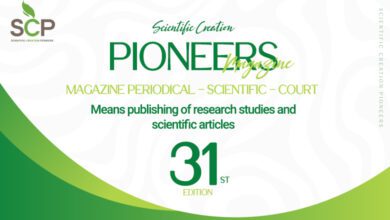استدراكات الإمام الرافعي في كتابه (الشرح الكبير) على الإمام الغزالي في كتابه (الوجيز): دراسة تحليلية
الملخص
تناول هذا البحث استدراكات الإمام الرافعي في كتابه “الشرح الكبير” على الإمام الغزالي في كتابه “الوجيز”، مسلطًا الضوء على الجنايات الشرعية المتعلقة بالقذف والسرقة، وهدفت الدراسة إلى تحليل الاستدراكات التي قدمها الإمام الرافعي لتصويب النصوص الفقهية وتوضيح الجوانب التي أغفلها الإمام الغزالي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي لجمع الاستدراكات، والمنهج التحليلي لتفسير أوجه النقد والتصويب، حيث بلغ عدد الاستدراكات المدروسة تسعة وسبعين استدراكًا، شملت تصويبات وإضافات دقيقة للمسائل الفقهية، وركزت الدراسة على بيان الشروط الشرعية لتحقق جريمة السرقة، بما في ذلك النصاب واحترام المال، إضافة إلى الشروط اللازمة لإثبات القذف، خاصة الشهادة وعدالة الشهود، وقد تناول البحث هذه الشروط من منظور شرعي دقيق، مما أبرز أهمية الاستدراكات في توضيح الأحكام وتحقيق الدقة، وأظهرت الدراسة الأثر الكبير لهذه الاستدراكات في تصحيح النصوص الفقهية وضبطها بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مع إظهار مرونة الفقه الإسلامي وارتباطه بمقاصد العدالة الشرعية.
الكلمات المفتاحية: الاستدراك الفقهي، الإمام الرافعي، الإمام الغزالي، الشرح الكبير، الوجيز.
Abstract
This research focuses on the study of Imam Al-Rafi’i’s amendments in his book “Al-Sharh Al-Kabir” to the book “Al-Wajiz” by Imam Al-Ghazali, particularly in the Islamic criminal laws related to slander (qadhf) and theft (sariqa). A total of seventy-nine amendments were analyzed using inductive and analytical methodologies, where Imam Al-Rafi’i provided significant corrections and additions to clarify what Al-Ghazali overlooked in his jurisprudential texts. These amendments included precise conditions for the establishment of theft, such as the minimum threshold (nisaab) and respect for property, as well as the requirements for testimony and the integrity of witnesses in cases of slander. The study highlights the central role of Imam Al-Rafi’i in developing the Shafi’i school of thought through his corrections and additions, which contributed to refining the jurisprudential texts in alignment with the objectives of Islamic law in achieving justice and protecting rights, reflecting the methodological precision of the Shafi’i school in addressing jurisprudential issues.
Keywords: Jurisprudential critique, Imam Al-Rafi’i, Imam Al-Ghazali, Al-Sharh Al-Kabir, Al-Wajiz.
المقدمة
تُعد الأحكام الفقهية الإسلامية من أعظم الأدلة على شمولية الشريعة الإسلامية وقدرتها على تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق. ومن أبرز العلوم التي تناولتها الشريعة علم الفقه الإسلامي الذي اهتم ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، ومنها الجرائم والعقوبات. ولأن النصوص الشرعية تستند إلى نصوص قطعية من الكتاب والسنة، فقد أُحيطت بمقاصد دقيقة تحرص على تحقيق العدالة ومنع الظلم.
أولى الفقهاء اهتمامًا خاصًا بجريمة السرقة باعتبارها من الجرائم التي تستوجب حدًا شرعيًا يُنفذ بشروط دقيقة، وذلك لما لها من تأثير على أمن المجتمع واستقراره. تناول الفقهاء هذه الجريمة من زوايا متعددة، بما في ذلك شروط تحققها، ومن أبرز هذه الشروط النصاب واحترام المال، حيث ركزوا على ضرورة تحديد قيمة المال المسروق وما إذا كان هذا المال محترمًا شرعًا.
في هذا السياق، لعب الإمام الرافعي دورًا بارزًا في إثراء الفقه الإسلامي من خلال كتابه “العزيز شرح الوجيز”، حيث استدرك على الإمام الغزالي في كتاب “الوجيز” بعض الجوانب التي لم تُفصل بالقدر الكافي. شملت استدراكاته توضيحات دقيقة حول النصوص المتعلقة بجريمة السرقة، خاصة فيما يتعلق بالنصاب وشروط الملكية واحترام المال. وقد اعتمد الرافعي في استدراكاته على الأدلة الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة وأصول المذهب الشافعي.
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الاستدراكات الفقهية في تطوير النصوص الشرعية، مع التركيز على استدراكات الإمام الرافعي على الإمام الغزالي في مسائل السرقة، من أجل تسليط الضوء على المنهج الفقهي الدقيق الذي يجمع بين النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
المشكلة البحثية
تمثل جريمة السرقة إحدى الجرائم الحدودية التي اهتم بها الفقه الإسلامي لضمان تحقيق العدالة وحفظ الأمن في المجتمع. ومع ذلك، تواجه النصوص الفقهية المتعلقة بجريمة السرقة تحديات تتمثل في عدم تفصيل بعض الجوانب المهمة كالنصاب وشروط الملكية واحترام المال، مما قد يؤدي إلى سوء فهم للأحكام الشرعية أو تطبيقها بشكل غير دقيق. وفي هذا السياق، تبرز استدراكات الإمام الرافعي على الإمام الغزالي في كتاب “العزيز شرح الوجيز”، حيث تناول تلك الجوانب بتفصيل ودقة، مما يجعل الحاجة إلى دراستها أمرًا ضروريًا لتوضيح منهج الشريعة في التعامل مع هذه الجريمة.
أهمية الدراسة
- تسليط الضوء على دور الاستدراكات الفقهية في تطوير النصوص الشرعية وضبطها بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
- إبراز الإسهامات العلمية للإمام الرافعي في تصويب وتفصيل المسائل الفقهية المتعلقة بجريمة السرقة.
- المساهمة في توضيح الشروط الدقيقة التي حددها الفقهاء لتحقيق العدالة في تطبيق الأحكام المتعلقة بالحدود.
- دعم الدراسات الفقهية التي تهدف إلى ربط النصوص الفقهية بمقاصد الشريعة الإسلامية.
أهداف الدراسة
- تحليل الاستدراكات التي أضافها الإمام الرافعي على الإمام الغزالي في مسائل السرقة.
- توضيح الشروط التفصيلية التي حددها الفقه الإسلامي لتحقق جريمة السرقة، مثل النصاب واحترام المال.
- إبراز أثر الاستدراكات الفقهية في تحقيق الدقة والوضوح في النصوص الشرعية.
- دراسة الخلافات الفقهية بين الإمام الرافعي والإمام الغزالي في هذه المسائل، وبيان الرأي الراجح.
- المساهمة في تقديم رؤية شاملة للباحثين حول أهمية استكمال النصوص الفقهية وتطويرها.
منهجية الدراسة
- المنهج التحليلي: تحليل النصوص الفقهية الواردة في كتاب “العزيز شرح الوجيز” للإمام الرافعي، ومقارنتها بما ورد في “الوجيز” للإمام الغزالي.
- المنهج المقارن: مقارنة الآراء الفقهية للإمامين الرافعي والغزالي فيما يتعلق بجريمة السرقة.
- المنهج الاستنباطي: استنباط أثر الاستدراكات الفقهية على تحقيق العدالة وتطوير النصوص الشرعية.
- منهج الدراسة النصية: دراسة النصوص الفقهية المتعلقة بجريمة السرقة في سياقها الشرعي، مع التركيز على الأدلة المستمدة من الكتاب والسنة.
هيكل البحث
المبحث الأول: تعريف الاستدراك الفقهي
- المطلب الأول: تعريف الاستدراك لغةً واصطلاحاً
- المطلب الثاني: أنواع الاستدراك
المبحث الثاني: الشهادة في القذف
- المطلب الأول: شهادة العبد والذمي في القذف
- المطلب الثاني: الشهادة في غير مجلس القضاء
المبحث الثالث: شروط تحقق جريمة السرقة
- المطلب الأول: النصاب وشروط الملكية
- المطلب الثاني: احترام المال
المبحث الأول: تعريف الاستدراك الفقهي
تمهيد
يمثل الاستدراك الفقهي أحد العلوم المهمة التي تضفي على النصوص الشرعية المزيد من الدقة والوضوح. يعمل هذا العلم على تصحيح الأخطاء وتدارك النقص، مما يجعل النصوص الشرعية قادرة على تلبية احتياجات الزمان والمكان. وقد لعب هذا العلم دورًا رئيسيًا في تأصيل الفقه الإسلامي وإظهار مرونته وقدرته على معالجة المستجدات.
المطلب الأول: تعريف الاستدراك لغةً واصطلاحًا
تمهيد
لفهم مفهوم الاستدراك الفقهي لا بد من تعريفه من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، بما يوضح أبعاده وأهميته في السياق الشرعي.
أولاً: تعريف الاستدراك لغةً
الاستدراك في اللغة يعني الإلحاق أو التدارك. يُقال: “استدرك الأمر” إذا لحقه بعد فواته لتصحيحه أو لتدارك النقص فيه. ومن معانيه أيضًا: بلوغ الشيء غايته، والإصلاح بعد وقوع خطأ، أو تكميل ما كان ناقصًا. يدل المصطلح على تدخل لاحق يراد به التصحيح أو الإضافة[1]
ثانيًا: تعريف الاستدراك اصطلاحًا
الاستدراك اصطلاحًا يُعرف بأنه: “تصحيح أو تعديل لما ورد في النصوص الفقهية بهدف إزالة الغموض، تصحيح الخطأ، أو توضيح معنى ناقص”. يشمل هذا التعريف جميع أنواع الإضافات أو التعديلات التي تجعل النصوص الشرعية أكثر وضوحًا ودقة، كما يعكس حرص الفقهاء على تحقيق الأهداف الشرعية بدقة[2]
أهمية تعريف الاستدراك
- توضيح المفهوم: يساعد في فهم طبيعة العلم وتطبيقاته.
- ضبط النصوص الشرعية: يُسهم في تحسين النصوص وتطويرها بما يناسب الواقع[3].
- مرونة الفقه الإسلامي: يُظهر قدرة الفقه على مواجهة التحديات العلمية والفكرية.
- تحقيق مقاصد الشريعة: يُبرز أهمية النصوص الشرعية في تحقيق العدالة والدقة.
المطلب الثاني: أنواع الاستدراك
تمهيد
تناول الإمام الرافعي في كتابه “العزيز شرح الوجيز” أنواع الاستدراكات التي اعتمدها لتصويب النصوص الفقهية وتوضيح ما قد يكون ناقصًا أو غامضًا. استدراكاته لم تكن عشوائية بل تميزت بالتنظيم والدقة، حيث شملت الجوانب المختلفة للأحكام الشرعية. سنستعرض فيما يلي أهم أنواع الاستدراك التي ذكرها الرافعي مع بيان أهدافها وأهميتها.
أولًا: الاستدراك التصحيحي
أوضح الإمام الرافعي أن الاستدراك التصحيحي يهدف إلى تصويب الأخطاء التي قد ترد في النصوص الفقهية، سواء في صياغة المسائل أو في النقل عن الأئمة. ومن أمثلة ذلك:
- تصحيح الروايات التي تُنسب إلى الإمام الشافعي إذا وردت بطريقة غير دقيقة.
- مراجعة الأقوال الفقهية التي اعتمدها الغزالي في “الوجيز” وإثبات ما يتوافق منها مع أصول المذهب.
- ضبط المصطلحات الفقهية التي قد يساء فهمها، مثل تعريف الحدود والشروط اللازمة لها.
أكد الرافعي أن هذا النوع من الاستدراك يعزز من دقة النصوص، ويضمن مطابقتها للواقع الشرعي الذي يُبنى على أصول ثابتة[4]
ثانيًا: الاستدراك التوضيحي
تناول الإمام الرافعي الاستدراك التوضيحي كوسيلة لإضافة الإيضاحات التي أغفلها النص الأساسي. يتضمن هذا النوع من الاستدراك:
- شرح المصطلحات الفقهية الغامضة التي لم يفصلها الغزالي.
- تقديم الأمثلة الواقعية التي تعين على فهم القضايا الفقهية.
- توضيح السياقات التي وردت فيها الأحكام الشرعية، مما يُزيل اللبس ويوفر فهمًا شاملًا³.
ومن الأمثلة التي ذكرها الرافعي، توضيح شروط الحرز في جريمة السرقة التي أغفلها الغزالي، حيث أضاف تفصيلات تتعلق بالعرف والعادة في تحديد مفهوم الحرز[5].
ثالثًا: الاستدراك التكميلي
أضاف الإمام الرافعي استدراكات تكمل ما ورد في النصوص الفقهية، حيث ركز على الجوانب التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ. ومن أمثلة ذلك:
- ذكر شروط جديدة لبعض الأحكام الشرعية التي لم تُفصل في النص الأصلي.
- إضافة الأدلة الشرعية التي تدعم الأحكام الواردة، سواء كانت من القرآن الكريم أو السنة النبوية.
- بيان الخلافات داخل المذهب الشافعي حول بعض القضايا، مثل مسائل الشهادة وحدودها.
أكد الرافعي أن هذا النوع من الاستدراك يظهر مرونة النصوص الفقهية وقدرتها على التطور لمواكبة التغيرات الاجتماعية والشرعية[6].
رابعًا: الاستدراك النقدي
يُعد الاستدراك النقدي أبرز ما قدمه الإمام الرافعي، حيث أظهر قدرته على تحليل النصوص الفقهية ونقدها بطريقة بناءة. يتمثل هذا النوع في:
- مناقشة الأقوال الضعيفة التي اعتمدها الغزالي وتقديم البدائل الأقوى.
- نقد ترتيب المسائل في النصوص الفقهية وإعادة تنظيمها بما يخدم الفهم.
- مراجعة الأدلة المستخدمة وتقديم الأدلة الأقرب إلى أصول المذهب[7].
المبحث الثاني: الشهادة في القذف
تمهيد
تناولت كتب الفقه مسألة الشهادة في القذف باعتبارها وسيلة لإثبات جريمة القذف وتطبيق الحد على القاذف. غير أن الإمام الرافعي استدرك على الإمام الغزالي في كتابه “الوجيز” الذي أغفل بعض الجوانب المهمة المتعلقة بشهادة العبد والذمي، حيث قدم الرافعي توضيحات شاملة وتفصيلات دقيقة تعكس حرصه على ضبط النصوص الشرعية وإظهار أوجه الدقة في تطبيق الأحكام المتعلقة بجريمة القذف.
المطلب الأول: شهادة العبد والذمي في القذف
أولًا: رأي المذهب الشافعي
أكد الإمام الرافعي أن شهادة العبد والذمي في القذف لا تقبل في الحدود، حيث إن العدالة شرط أساسي لقبول الشهادة. والعبد والذمي لا يستوفيان هذا الشرط في الحدود الشرعية التي تتطلب شهادة أحرار عدول. أشار الرافعي إلى أن العدالة تعني السلامة من الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وهذا لا يتحقق في العبد بسبب تبعيته لسيده وضعف موقفه الاجتماعي، ولا في الذمي بسبب اختلاف العقيدة وما قد يتصل بها من أحكام شرعية خاصة.
استدل الرافعي على موقفه بقول الإمام الشافعي: “الشهادة لا تقبل إلا من عدل، والعدل يشترط فيه الإسلام والحرية والعدالة الظاهرة”[8] وأكد أن إسقاط شهادة العبد والذمي في الحدود لا يُعد انتقاصًا من إنسانيتهم، وإنما يتعلق بمتطلبات العدالة الصارمة في إقامة الحدود، حيث تشترط الشريعة التثبت الكامل والتأكد من اكتمال الشروط لإقامة الحد.
وأضاف الرافعي أن اشتراط العدالة في الشهود يحفظ حقوق الأفراد ويمنع التعدي عليهم بشهادات قد تكون غير موثوقة. فالحدود تُدرأ بالشبهات، وبالتالي فإن أي خلل في عدالة الشاهد يُعتبر شبهة تمنع تطبيق الحد.
ثانيًا: اختلاف الآراء داخل المذهب
أشار الإمام الرافعي إلى وجود خلاف بين الشافعية في مسألة قبول شهادة العبد والذمي في حالات معينة خارج الحدود. فبعض فقهاء المذهب أقروا بشهادتهم في إثبات الحقوق المدنية، مثل الديون أو النفقات، وذلك بشرط أن تكون شهادتهم مصحوبة بقرائن قوية تدعمها، كالاعتراف من الطرف الآخر أو توفر أدلة إضافية[9]
أما في الحدود، فقد أجمع جمهور الشافعية على رفض شهادة العبد والذمي، معللين ذلك بأن الحدود لا تثبت إلا بشهادة أحرار عدول تتوافر فيهم الشروط كاملة. وأوضحوا أن نقصان أي شرط من شروط العدالة يُعد سببًا كافيًا لرفض الشهادة، لأن الحدود تستوجب أعلى درجات التثبت، عملًا بقاعدة “الحدود تُدرأ بالشبهات”.
استدرك الإمام الرافعي أيضًا على الإمام الغزالي في عدم ذكر مسألة اشتراط اكتمال العدد المطلوب من الشهود لإثبات القذف. وأكد أن القذف يحتاج إلى أربعة شهود عدول كما نص القرآن الكريم: (فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [10]
وأوضح الرافعي أن الشهادة على القذف إذا نقصت عن العدد المطلوب أو اختل فيها شرط العدالة فلا تقبل، ويتحول الأمر إلى موجب للتعزير لا الحد. فالعدد المطلوب من الشهود ليس مسألة فرعية، بل هو من الأسس التي تقوم عليها العدالة في إثبات هذه الجريمة، وهو ما ينسجم مع مقاصد الشريعة في درء الحدود بالشبهات[11]
كما أشار الرافعي إلى أن الإمام الغزالي في “الوجيز” لم يتعرض لمسألة العبرة بمجلس القضاء في القذف، وأوضح أن الشهادة على القذف يجب أن تُرفع إلى القاضي في مجلس القضاء حتى تكون معتبرة. فالقاضي هو الذي يتولى التحقق من اكتمال الشروط والنظر في الأدلة المقدمة. وأي شهادة على القذف تتم خارج مجلس القضاء لا يمكن أن تؤدي إلى إقامة الحد، إلا إذا أكدها القاضي لاحقًا بعد استيفاء الشروط.
المطلب الثاني: الشهادة في غير مجلس القضاء
تمهيد
تناول الإمام الرافعي مسألة الشهادة في غير مجلس القضاء، واستدرك على الإمام الغزالي الذي أغفل بيان هذه القضية بالتفصيل. أوضح الرافعي أن الشهادة في القذف يجب أن تتم في مجلس القضاء حتى تكون معتبرة لإقامة الحد. وأكد أن المذهب الشافعي يشترط أن تُسمع الشهادة بحضور القاضي المختص، لأن القاضي هو المسؤول عن التحقق من صحة الشهادة وتوفر الشروط اللازمة فيها، مثل العدالة والتعدد واكتمال العدد.
أولًا: حكم الشهادة في غير مجلس القضاء في المذهب الشافعي
أشار الرافعي إلى أن الشهادة خارج مجلس القضاء لا تُعتبر وسيلة لإثبات جريمة القذف، إذ إن رفع الأمر إلى القضاء يضمن سلامة الإجراء وحياديته، كما أنه يحمي الأطراف من أي استغلال أو تلاعب قد يحدث خارج الإطار القانوني. ودلل على ذلك بقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)[12]، حيث ربط بين إقامة الشهادة والعدل الذي يتحقق بحضور القاضي.
ثانيًا: تأثير الشهادة في غير مجلس القضاء
أوضح الإمام الرافعي أن الشهادة التي تقع خارج مجلس القضاء قد تؤدي إلى التعزير إذا لم تستوفِ الشروط المطلوبة لإقامة الحد. فإذا شهد أربعة شهود على القذف خارج مجلس القضاء، وكانوا عدولًا، لكن لم تُرفع شهادتهم إلى القاضي، فإن الشهادة تُعتبر غير كافية لإقامة الحد، وقد يُكتفى بتوقيع عقوبات تعزيرية على القاذف بدلًا من الحد[13]
وأشار الرافعي إلى أن الإمام الغزالي لم يوضح بشكل كافٍ تأثير الشهادة في غير مجلس القضاء على سير العدالة. وبين أن الشهادة لا تكون معتبرة إلا إذا تم التصديق عليها من القاضي، الذي يتولى مسؤولية فحص الشروط ومطابقة الأدلة المقدمة مع المعايير الشرعية.
ثالثًا: الشهادة الناقصة خارج مجلس القضاء
أضاف الإمام الرافعي استدراكًا مهمًا يتعلق بالشهادة الناقصة خارج مجلس القضاء، حيث أوضح أنه إذا شهد ثلاثة شهود عدول على القذف ولم يكتمل العدد المطلوب، فلا تقام العقوبة الحدية على القاذف. في هذه الحالة، يتحول الأمر إلى موجب للتعزير، إذ إن عدم اكتمال العدد يُعد شبهة تمنع إقامة الحد، استنادًا إلى القاعدة الفقهية: “الحدود تدرأ بالشبهات”[14]. كما أكد أن الشهادة الناقصة تُعتبر في الشريعة الإسلامية غير كافية لإثبات جريمة القذف مهما كانت درجة عدالة الشهود.
رابعًا: شروط القبول في مجلس القضاء
أوضح الرافعي أن قبول الشهادة في مجلس القضاء يعتمد على توفر عدة شروط رئيسية:
- اكتمال العدد: يجب أن يكون عدد الشهود أربعة عدول.
- العدالة: يجب أن يكون الشهود معروفين بالعدالة، خالين من الكبائر وغير مصرين على الصغائر.
- المجلس القضائي: يجب أن تُرفع الشهادة إلى القاضي المختص ليقوم بالنظر فيها.
- التطابق في الرواية: يجب أن تتفق رواية الشهود دون أي تناقض.
واستدرك الرافعي على الغزالي بعدم ذكر أثر التطابق في الرواية، حيث أكد أن أي تناقض في الشهادة يؤدي إلى بطلانها، لأن الشريعة الإسلامية تعتمد على الدقة في الإثبات، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالحدود[15].
خامسًا: الحكمة من الشهادة أمام القاضي
أوضح الإمام الرافعي الحكمة من اشتراط رفع الشهادة إلى القاضي، وهي ضمان التحقق من صحة الشهادة وعدالة الشهود، ومنع التلاعب أو استغلال الشهادة خارج الإطار القانوني. كما أن وجود القاضي يُعد ضمانة شرعية لإحقاق الحق، حيث يعمل القاضي كجهة محايدة توازن بين الأطراف وتضمن تطبيق العقوبة بشكل عادل.[16]
المبحث الثالث: شروط تحقق جريمة السرقة
تمهيد
تعد جريمة السرقة من الجرائم الحدودية في الإسلام التي شددت الشريعة على تحقيق شروطها بدقة قبل إقامة الحد على الجاني، وذلك لضمان العدالة ومنع أي ظلم. تناول الفقهاء شروط تحقق هذه الجريمة بالتفصيل، ومن أبرزهم الإمام الرافعي الذي استدرك على الإمام الغزالي في كتابه “الوجيز” لتوضيح بعض الجوانب التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ. أضاف الإمام الرافعي في كتابه “العزيز شرح الوجيز” تفصيلات دقيقة توضح شروط تحقق جريمة السرقة، معتمدًا على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ومراعيًا أصول المذهب الشافعي.
ركز الإمام الرافعي على أهمية النصاب كشرط أساسي لتحقق الجريمة، حيث إن النصاب يمثل الحد الأدنى لقيمة المال المسروق الذي يوجب إقامة الحد. كما بين شروط الملكية التي تجعل المال المسروق معتبرًا في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن المال يجب أن يكون مملوكًا ملكية تامة لشخص معين، وأن يكون مالًا محترمًا شرعًا.
شدد الإمام الرافعي على ضرورة ضبط هذه الشروط لضمان تحقيق العدالة في تطبيق الحدود، مشيرًا إلى أن القصد من هذه الشروط هو حماية حقوق الأفراد والمجتمع، ومنع أي تسرع في إقامة الحد دون تحقق الشروط اللازمة.
المطلب الأول: النصاب وشروط الملكية
تمهيد
تناول الإمام الرافعي في كتابه “العزيز شرح الوجيز” جريمة السرقة باعتبارها من الجرائم الحدودية التي تتطلب شروطًا دقيقة لتحققها. أضاف الإمام الرافعي توضيحات وشروحات تفصيلية لاستدراك القصور الموجود في كتاب “الوجيز” للإمام الغزالي، حيث لم يُفصّل الأخير في النصاب وشروط الملكية بالشكل الكافي. هدفت هذه الإضافات إلى ضبط النصوص الشرعية وتقديم رؤية شاملة تحقق العدالة وتضمن دقة تطبيق الأحكام الشرعية.
أولا: النصاب في جريمة السرقة
أكد الإمام الرافعي أن النصاب هو الحد الأدنى لقيمة المال المسروق الذي يوجب إقامة الحد على السارق. بيّن أن النصاب الشرعي لجريمة السرقة هو ربع دينار من الذهب أو ما يعادله من المال. استدل الإمام الرافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا”[17]يُعد هذا الحديث نصًا شرعيًا واضحًا في تحديد النصاب، ولا يحتمل التأويل. أوضح الإمام الرافعي أن النصاب هو شرط أساسي في تحقق جريمة السرقة، حيث يشير إلى القيمة الدنيا التي تجعل المال المسروق معتبرًا لإقامة الحد. تناول مسألة اختلاف التقدير في النصاب باختلاف الزمن والمكان، مشيرًا إلى أن الأصل في تقدير النصاب هو قيمته الشرعية في الذهب أو ما يُعادله من الأثمان، مع التأكيد على ضرورة مراعاة تغير قيمة العملات في العصر الحديث بما يضمن تحقيق المقصد الشرعي في إقامة الحد[18].
ثانيا: شروط الملكية في المال المسروق
تناول الإمام الرافعي شروط الملكية التي تجعل المال المسروق موجبًا لإقامة الحد. أشار إلى أن أول هذه الشروط هو أن يكون المال مملوكًا ملكية تامة لشخص معين. إذا كان المال مشاعًا بين الشركاء، أو كان للسارق فيه شبهة ملكية، فلا يقام الحد عليه. على سبيل المثال، إذا سرق شريك مال الشركة، فإن ذلك لا يُعد موجبًا للحد لأن الشريك يملك نصيبًا في المال[19].
أكد الإمام الرافعي أيضًا على ضرورة أن يكون المال المسروق محترمًا شرعًا، أي أن يكون ذا قيمة معتبرة في الشريعة. الأموال التي لا تُعد محترمة، مثل الأموال المحرمة كالنبيذ والخمور أو الأدوات المستخدمة في المحرمات، لا يُقيم الشرع حد السرقة عليها. أضاف الإمام أن المال المسروق يجب أن يكون مملوكًا لشخص معين وليس مالًا عامًا، مثل أموال الزكاة أو الوقف. في حالة سرقة المال العام، يُعاقب السارق بالتعزير وليس بالحد، لأن الأموال العامة تُدار من قبل ولي الأمر ولها نظام عقابي خاص[20]
ثالثا: استدراكات الإمام الرافعي على الغزالي
استدرك الإمام الرافعي على الإمام الغزالي في عدة نقاط تتعلق بجريمة السرقة. أوضح أن الغزالي لم يُفصل في النصاب وشروط الملكية بالشكل الكافي، مما قد يؤدي إلى غموض في تطبيق الأحكام الشرعية. أضاف الرافعي تفصيلات دقيقة تتعلق بأهمية النصاب وكيفية قياسه في ظل تغير الظروف الزمنية والمكانية. شدد على أهمية توضيح شروط الملكية، لا سيما ما يتعلق بالملكية التامة واحترام المال شرعًا، لتحديد ما إذا كان السارق يستحق إقامة الحد. كما بيّن الإمام الرافعي خلافات الفقهاء في هذه المسائل، وعرض الرأي الراجح معتمدًا على الأدلة الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة وأصول المذهب الشافعي. أكدت هذه الاستدراكات على أهمية الدقة في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها بما يضمن تحقيق العدالة ومنع الظلم[21]
المطلب الثاني: احترام المال
تمهيد
تناول الإمام الرافعي في كتابه “العزيز شرح الوجيز” شرط احترام المال كأحد الشروط الأساسية لتحقق جريمة السرقة التي تستوجب إقامة الحد. أشار إلى أن المال المسروق يجب أن يكون مالًا محترمًا شرعًا، أي له قيمة معتبرة ومشروعة في الشريعة الإسلامية. استدرك الإمام الرافعي على الإمام الغزالي الذي لم يفصّل في هذا الشرط، موضحًا الأبعاد الشرعية التي تجعل المال محترمًا أو غير محترم، وأثر ذلك في الحكم على السارق.
أولا: احترام المال شرعًا
أكد الإمام الرافعي أن المال المحترم شرعًا هو الذي يعتبره الشرع ذا قيمة ويمكن الانتفاع به بطريقة مشروعة. إذا كان المال المسروق لا يحظى باحترام الشريعة، فلا يُعد ذلك موجبًا لإقامة الحد[22]. أوضح الرافعي أن هذا الشرط يستند إلى مقصد الشريعة في حماية الأموال التي تعود بالنفع الحقيقي على الأفراد والمجتمع.
أشار الإمام إلى أن الأموال المحرمة، مثل الخمر أو الخنزير، لا يُقيم الشرع حد السرقة على سارقها لأنها لا تعتبر مالًا محترمًا. فمثل هذه الأموال لا قيمة لها شرعًا، ولا يجوز للمسلم تملكها أو الانتفاع بها. كما أشار إلى أن الأدوات التي تستخدم في المحرمات، مثل آلات اللهو أو القمار، لا تُعد أموالًا محترمة، وبالتالي فإن سرقتها لا تُوجب إقامة الحد[23]
ثانيا: تحديد المال المحترم والمال غير المحترم
فرق الإمام الرافعي بين المال المحترم والمال غير المحترم من خلال أمثلة شرعية واضحة. أشار إلى أن المال المحترم هو المال الذي:
- يُنتفع به شرعًا كالطعام، واللباس، والأموال النقدية.
- مشروع في تملكه، أي أن حيازة المال تتم بطريقة مشروعة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة
أما المال غير المحترم فهو المال الذي لا يُعترف به شرعًا لعدم جواز تملكه أو الانتفاع به، مثل:
- الأموال المحرمة كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلمين
- الأموال المكتسبة من المحرمات كالأموال الناتجة عن القمار أو الربا
ثالثا: استدراكات الإمام الرافعي على الغزالي
استدرك الإمام الرافعي على الغزالي الذي لم يُبرز شرط احترام المال بالشكل الكافي. أضاف الرافعي تفاصيل توضح أهمية هذا الشرط في تحديد ما إذا كان السارق يستحق إقامة الحد. شدد على أن هذا الشرط يُبرز مرونة الشريعة الإسلامية وعدالتها، حيث لا يُقيم الإسلام الحدود إلا على من يستحقها بناءً على قواعد شرعية واضحة.
أوضح الإمام الرافعي أن احترام المال شرط يهدف إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الأفراد وبين تطبيق العقوبات الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة. كما أشار إلى أهمية مراعاة هذا الشرط في القضاء الإسلامي لضمان عدم التسرع في تطبيق الحدود في الحالات التي لا يُعتبر فيها المال المسروق محترمًا شرعًا[24]
الخاتمة
تُبرز هذه الدراسة أهمية الاستدراك الفقهي في تطوير النصوص الشرعية وضبطها بما يتناسب مع الواقع والمقاصد الشرعية. تناول البحث استدراكات الإمام الرافعي على الإمام الغزالي في مسائل القذف والسرقة، حيث قدم إضافات وتصويبات تسهم في تعزيز دقة الفقه الإسلامي ومرونته. من خلال تحليل النصوص واستعراض الاستدراكات، يتضح دور الإمام الرافعي في تطوير المذهب الشافعي وإبراز مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
النتائج
- بلغ عدد الاستدراكات المدروسة تسعة وسبعين استدراكًا، شملت تصويبًا وإضافات توضيحية على نصوص الإمام الغزالي.
- أكدت استدراكات الإمام الرافعي أهمية النصاب واحترام المال كشرطين أساسيين لتحقق جريمة السرقة.
- تناول الرافعي شروط الشهادة وعدالة الشهود في إثبات القذف، مضيفًا توضيحات حول اكتمال العدد وضرورة إقامتها في مجلس القضاء.
- أظهرت الدراسة مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع المتغيرات وإبراز مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة ومنع الظلم.
- أثبت البحث أن استدراكات الإمام الرافعي كانت دقيقة ومنظمة، مما يعكس مكانته البارزة في تطوير الفقه الشافعي.
التوصيات
- التوسع في دراسة استدراكات العلماء الآخرين في المذاهب الفقهية المختلفة لتحليل أثرها على تطور الفقه الإسلامي.
- تحقيق ونشر كتب التراث الفقهي التي تحتوي على استدراكات هامة، مثل كتاب “العزيز شرح الوجيز”.
- توفير شروح حديثة تسلط الضوء على أهمية الاستدراكات في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة.
- تشجيع الباحثين على دراسة الاستدراكات الفقهية في ضوء القضايا الشرعية المستجدة، بما يعزز ربط النصوص الفقهية بالواقع.
- تقديم دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمفتين حول أهمية الاستدراكات في ضبط النصوص الشرعية وتحقيق العدالة.
المصادر والمراجع
- ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله. المغني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى.
- ابن منظور. لسان العرب، دار المعارف.
- الرافعي، عبد الكريم بن محمد. العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. طبقات الشافعية الكبرى، دار هجر، الطبعة الثانية، 1992م.
- الشافعي، محمد بن إدريس. الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، الطبعة الأولى، ج7،
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت.
- الغزالي، أبو حامد. الوجيز في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر، بيروت.
- القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الفروق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
- النووي، يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت.
[1] ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مادة “درك”، ج5، ص267.
[2] النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، ج9، ص5.
[3] الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت، ج2، ص190.
[4] الرافعي، عبد الكريم بن محمد. العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3، ص220.
[5]القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الفروق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ج2، ص77.
[6] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج6، ص85.
[7]الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م، ج13، ص215.
[8] الشافعي، محمد بن إدريس. الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، الطبعة الأولى، ج7، ص195.
[9] النووي، يحيى بن شرف. روضة الطالبين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ج10، ص63.
[10] السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. طبقات الشافعية الكبرى، دار هجر، الطبعة الثانية، 1992م، ج5، ص40.
[11] سورة النور: الآية 4.
[12] سورة الطلاق، الآية 2.
[13] النووي، يحيى بن شرف، مرجع سابق، ص65.
[14] السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، مرجع سابق ، ص42.
[15] الغزالي، أبو حامد. الوجيز في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر، بيروت، ج1، ص135.
[16] الرافعي، عبد الكريم. العزيز، مرجع سابق ، ص198.
[17] الحديث الشريف: صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا).
[18]النووي، يحيى بن شرف، مرجع سابق ، ص100.
[19] الرافعي، عبد الكريم، مرجع سابق، ص215.
[20]الغزالي، أبو حامد. الوجيز في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر، بيروت، ج1، ص140.
[21]ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج7، ص320.
[22] الغزالي، أبو حامد، مرجع سابق، ص145.
[23]ابن قدامة، موفق الدين عبد الله. المغني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ج9، ص290.
[24] الرافعي، عبد الكريم بن محمد، مرجع سابق، ص220.