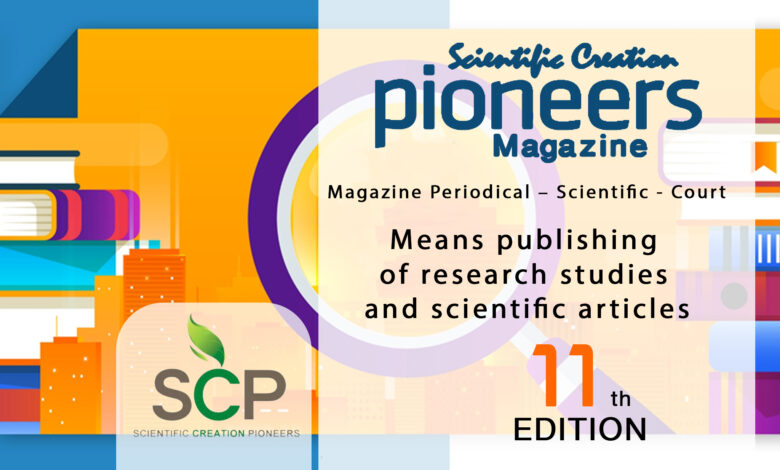
دور المؤسسات التربوية في الحد من تأثير العمالة المنزلية على تنشئة طفل ما قبل المدرسة
إعداد
فاطمة سليمان زنيد العلوني الجهني
كلية التربية _ جامعة القصيم
المملكة العربية السعودية
العام الجامعي 1433 هـ / 2012 م
معرف الوثيقة الرقمي : 20209118
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآلـه وصحبه والتابعين، وبعد: الأبناء فلذة كبد الآباء، بهم تحلو الحياة، وتعلق الآمال ؛ كيف لا وهم نتاج فكر الآباء، وامتداد ذكرهم، وطريق إلى الجنة ؛ بحسن تربيتهم وتنشئتهم النشأة الصالحة في ضوء الكتاب والسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:” إذَا مَاتَ ابْن ُآدَمَ انْقَطَعَ عَمًلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صَالحِ ٍيِدْعُو لَهُ ” (مختصر مسلم، 5 / 73).
وعلى الرغم من المكانة التي حباها الإسلام للطفل ؛ إلا أننا نجده في الآونة الأخيرة يسلّم إلى الخادمة أو المربية، حيث إن البعض منهن لا تراعي هذه الأمانة ؛ فمن المشاهد أن ظاهرة استقدام العمالة المنزلية الأجنبية (الخادمة والمربية) قد كثرت، منذ عام 1395ه وذلك مع بداية تشكيل لجنة منح تأشيرات الاستقدام وحتى الآن (العيدان، 1993م: 65). مما انعكس إيجاباً وسلباً على الأسرة بصفة عامة والطفل بصفة خاصة، وبالذات على نواحي التربية الدينية والجسمية والنفسية والاجتماعية مع خطورة استئثار هذه العمالة على عواطف ومشاعر الطفل في سن التكوين وعدم اكتسابه لعادات وأخلاق الوالدين.
إن تربية الطفل تحتاج إلى رعاية وحكمة وصبر، ذلك لأن طفولته طويلة جداً بالنسبة لغيره من المخلوقات وتمر بمراحل متعددة كلٍ منها تؤثر وتتأثر بسابقتها ولاحقتها، ويتميز الطفل بكل مرحلة من هذه المراحل بخصائص جسمية وعقلية واجتماعية وروحية معينة، وعلى ضوء تلك الخصائص يكون في حاجة ماسة لمطالب متعددة يتوجب على الأسرة والمحيطين به إشباعها بشكل متوازن ؛ وإلا تعرض الطفل لأضرار جسمية وعقلية ونفسية بالغة، تنعكس على شخصيته في مستقبل حياته وتجعل منه إنساناً ضعيفاً مهزوزاً لا يفيد مجتمعه وأمته بأي شيء أو تجعل منه شخصية ظالمة تكون مصدر فتنة للمجتمع الذي ينتمي إليه (الجلال، 1991م: 415).
لذا كان لزاماً على الأسرة الاهتمام بأبنائها وخصوصاً منذ الصغر ومتابعتهم في المنزل ورياض الأطفال، ومناقشتهم لمعرفة ما يدور في أذهانهم، وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة. ” فالطفولة هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها تشكيل كيان الفرد، وأي خطأ في هذا التشكيل يعتبر مؤثراً سلبياً يصعب التغلب عليه بعد هذه الفترة، ويكون له مردود سيء على جميع مراحل عمر الإنسان ” (الجلال، 1991م: 14).
يرى (كرانفورد) أنه كلما بكّر الأبوان تأديب أولادهما، استقرت في أذهانهم عادات سليمة، تتأصل في نفوسهم فتلازمهم طوال حياتهم (جمال، 1980م: 6,1 – 7,1).
ولا يأتي هذا الاهتمام والرعاية إلا بالتنسيق والتكامل بين الأسرة والمؤسسات التربوية الأخرى مثل رياض الأطفال، الجامعة، الإعلام حتى نضع للطفل صمام أمان للحد من الأضرار الناتجة عن استخدام العمالة المنزلية الأجنبية. فالأسرة تتولى تربية الطفل من المهد وحتى سن الرشد، ورياض الأطفال لها دور كبير في رعايته أثناء طفولته المبكرة وفي إعداده لمواجهة الحياة المدرسية فيما بعد، والمدرسة تتلقى الطفل منذ بداية طفولته المتأخرة وحتى نضوجه ؛ كما تعمل على إعداده للحياة المهنية مستقبلاً، وللحياة الجامعية دور كبير في تبصير الطلاب والطالبات بواجبات وحقوق الأطفال على والديهم حتى قبل أن يتم الزواج، والإعلام له دوره الفعّال في التأثير على تربية الطفل من خلال ما يقدم من برامج تفيد الأسرة وتوجهها لاتباع الأساليب التربوية في مواجهة مشاكل الطفل واحتوائها قبل أن تتفاقم (الجلال، 1991م: 416).
مشكلة الدراسة:
الطفل نواة الأسرة التي يأخذ منها حاجاته الأساسية من حب وأمان ورعاية يكتسبها نتيجة لتفاعله في أسرته، لذا فهي تترك بصماتها باقية مؤثرة على شخصيته من الناحية النفسية والأخلاقية والاجتماعية. ويجمع علماء النفس على أن أساليب التربية التي يتبعها الوالدان في تنشئة أطفالهما لها أكبر الأثر في تشكيل شخصياتهم في الكبر. فالكائن البشري الصغير ينتهي صوغه وتكوينه غالباً في السنة الرابعة أو الخامسة وهذا السن الصغير هو حجر الزاوية التي تعتمد عليها المراحل اللاحقة في حياة الإنسان (باشا، 2005م: 7).
وإن أبرز من يؤثر في الطفل في صغره هم من حوله، وقديما كان الأب والأم والإخوة والجد والجدة، أما الآن فقد وجد دخيل على هذه الأسرة فيما يسمي بالعمالة المنزلية سواء خادمة أو مربية.
أشارت إحصائيات وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، في عام 1425ه / 1426ه إلى أن ظاهرة العمالة المنزلية قد وصلت إلى 339985 خادمة، بينما في عام 1426ه / 1427ه بلغت 441248 خادمة، وفي عام 1427ه / 1428ه زاد العدد إلى 445106 خادمة، وفي العام الذي يليه أصبح عدد العمالة المنزلية 495885 خادمة، أما العام 1430ه / 1431ه فقد وصل العدد إلى 496092 خادمة، وفي العام 1431ه /1432ه زاد عدد العمالة المنزلية حيث أصبحت تقدر بــــ 565537 خادمة (الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل، 2009م: 57)، (الكتاب الإحصائي الثانوي لوزارة العمل، 2010م، 48).
ومن هذا يتضح أن العمالة المنزلية في تدفق مستمر إلى المملكة وقد أشارت كثير من الدراسات إلى ذلك مثل دراسة (عسيرى، 1983: 528) ودراسة (العتيبي، 2010م، 6) بسبب عوامل الجذب والأمن، والأجر المرتفع، والخدمات ذات المستوى العالي. وهناك دراسات توصلت لنتائج تفيد بأن الواقع الاقتصادي هو الأكثر تأثيراً في انتشار هذه الظاهرة، ومن هذه الدراسات دراسة قامت بها (عبدالعال، 1995م، 263) للكشف عن العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في المجتمع السعودي وبين أنماط الاستهلاك المختلفة التي انتشرت بين أفراد المجتمع، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الطفرة الاقتصادية ساهمت في زيادة الاستهلاك وخلق حاجات جديدة للأفراد كالاستعانة بالخدم بل وهناك أكثر من خادمة في بعض المنازل وخصوصاً في الأسر التي فيها زوجة عاملة، وترى الباحثة أن ذلك يشكل خطراً على النشء، كما أكدت دراسة (باحارث، 2005م: 555) على هذا العامل.
” والحقيقة أن هذا الانتشار للعمالة الوافدة يجعل الباحثين والمعنيين بالعمل الاجتماعي على المستوى الفردي والرسمي متخوفين من امتداد آثارها السلبية على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده ” (اليوسف، 2007م: 15).
وإن أحد عوامل انتشار ظاهرة الخدم في المجتمع السعودي هو خروج المرأة للعمل، بجانب تحملها مسؤولية إدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء وبما أن المرأة العاملة هي أم، والأم هي حاضنة الطفل الأولى لزم من يسد محلها في حال غيابها للعمل. وقد أكدت كثير من الدراسات على هذا العامل إذ أشارت إلى أن نسبة (52 %) من الزوجات السعوديات اللاتي يستعن بالخادمات هن من الموظفات (اليوسف، 2007م: 151)، كما أكدت ذلك دراسة (أحمد وآخرون، 1991م: 113) وحيث أن الخادمة الأجنبية من مجتمع غريب في العادات والتقاليد والأنماط السلوكية واللغة وربما الدىن عن المجتمع السعودي، مما أفرز العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية والأخلاقية واللغوية والسلوكية عند الأطفال وهذا ما كشفته دراسة (باحارث، 2005م: 556 – 561) لأنه مهما كانت براعة الخادمة في أداء وظيفتها فهي لن تحل محل الأم في عطفها وحبها وإخلاصها وتفانيها نحو صغارها، فالخادمة ماهي إلا عبد مأمور تؤدي مهمة رسمية بمجرد انتهاء العقد انتهت مهمتها هذا من ناحية (الأنصاري، 1988م: 2 – 3).
ومن ناحية أخرى قسوة المعاملة وعدم مراعاة إنسانية الخادم ساهم بدور بارز في ظهور ضحايا الخدم من الأطفال. وليست الأم فقط ملومة ومسؤولة عن هذا التقصير، بل إن كثيراً من الآباء انهمك في أعماله الخاصة دون أن يكون له دور في التصدي لهذه الظاهرة (بازامول، 2007م: 13).
ولا تقع المسؤولية على الأسرة فقط، فإننا إذا أعدنا النظر في القضية فإن قيام المؤسسات التربوية بدورها الإيجابي الصحيح يساهم في الحد من تلك الظاهرة. على أن تكون رياض الأطفال التي تربي الطفل حسب منهج تربوي إسلامي مدروس، يتفق مع خصائص ومتطلبات مرحلة الطفولة المبكرة، ويتولى الإشراف عليها والعمل بها إدارة واعية متخصصة، ومعلمات حصلن على التأهيل الكافي للتعامل مع الأطفال وتوجيههم الوجهة الصحيحة، وقادرات على حسن التواصل مع الأسرة (الجلال، 1991م: 254)، كما أنه لابد أن يكون هناك تعاون بين الأسرة ورياض الأطفال من جهة والجامعة من جهة أخرى فهي التي تثقف وتعدّ الفتاة والرجل وتزودهما بالمعلومات التربوية اللازمة للتربية الصحيحة والعناية بالطفل والتبصّر بالمشكلات المحيطة به، كذلك يجب الاهتمام بوسائل الإعلام في عصر الفضائيات. لا أن تلقي كل مؤسسة العبء على المؤسسة الأخرى، والطفل يبحث عن التحرر من الجميع إلى من يخدمه ولا يطلب منه أن يقدم له شيء وغالباً ما تكون هذه الصفة في الخدم.
ونظراً لهذه الآثار السلبية على تنشئة طفل ما قبل المدرسة الناتجة من العمالة المنزلية فقد قامت الباحثة بدراسة دور المؤسسات التربوية في الحد من تأثير العمالة المنزلية الأجنبية (الخادمة والمربية) على تنشئة طفل ما قبل المدرسة دراسة ميدانية في مدينة ينبع البحر، للعمل على تشخيصها واقتراح الحلول والبدائل لعلاجها والتخفيف من حدتها بما يتناسب مع أهداف ديننا الحنيف.
أسئلة الدراسة:
السؤال الرئيسي: ما دور المؤسسات التربوية في الحد من تأثير العمالة المنزلية (الخادمة والمربية) على تنشئة طفل ما قبل المدرسة؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي:
- التعرف على المتغيرات المجتمعية التي طرأت على الأسرة السعودية المعاصرة.
- التعرف على الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على استخدام الأسرة السعودية للعمالة المنزلية.
- التعرف على خصائص ومتطلبات الطفولة المبكرة (من الميلاد وحتى السنة السادسة).
- بيان أهمية ودور المؤسسات التربوية في الحد من تأثير العمالة المنزلية الأجنبية في تنشئة طفل ما قبل المدرسة.
أهمية الدراسة:
- تحاول هذه الدراسة التعرف على المتغيرات المجتمعية التي طرأت على الأسرة السعودية المعاصرة.
- تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على العمالة المنزلية الأجنبية والأطفال في المملكة العربية السعودية والمتعلقة بدراسة الجوانب السلبية والإيجابية المصاحبة للخادمة والمربية وعلاقتها بتربية الطفل ودور المؤسسات التربوية في التصدي لهذه الظاهرة، حيث إن بروزها بشكل كبير له جوانب سلبية على الطفل من الناحية الدينية والجسمية والنفسية والاجتماعية وغيرها.
- يمكن أن يسترشد بهذه الدراسة في دراسة جوانب أخرى مرتبطة بالأسرة والطفل والخدم غير ما تم تحديده في هذه الدراسة، وكذلك مناطق أخرى من المملكة العربية السعودية غير مدينة ينبع.
- تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على المؤسسات التربوية لتقوم بدورها الإيجابي في توعية المواطنين في الحد من تأثير العمالة المنزلية الأجنبية في تنشئة طفل ما قبل المدرسة.
حدود الدراسة:
لقد حددت الباحثة الدراسة بالحدود التالية:
الحد الزماني: تقتصر الدراسة على تنشئة الطفل السعودي دون سن المدرسة أي منذ الولادة إلى السن السادسة ؛ لأن هذه المرحلة من العمر هي الأساس الأول للمراحل الحياتية المقبلة (باشا، 2005م: 7)، الذي تقوم برعايته وتربيته في منزله خادمة أو مربية (أي من جنسية أخرى غير الجنسية العربية) مسلمة أو غير ذلك.
وطبقت الدراسة على الأمهات العاملات والخبيرات التربويات في الفصل الدراسي الأول من عام 1432ه / 1433ه.
الحد المكاني: تقتصر الدراسة على أطفال أفراد العينة من الأمهات العاملات والخبيرات التربويات بمدينة ينبع، لتواجد الباحثة بهذه المدينة؛ وستحاول الاستفادة من نتائج بعض الدراسات التي أجريت في بعض دول الخليج العربي عامة والمناطق الأخرى من المملكة العربية السعودية خاصة.
الحد الموضوعي: دور المؤسسات التربوية (الأسرة، رياض الأطفال، الجامعة، وسائل الإعلام) في الحد من تأثير العمالة المنزلية المسلمة الأجنبية (الخادمة والمربية) على تنشئة طفل ما قبل المدرسة من وجهة نظر الأمهات العاملات والخبيرات التربويات.
مصطلحات الدراسة:
العمالة المنزلية الأجنبية (الخدم):
لغةً:
” (العامل): من يعمل في مهنة أو صنعة والذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله. (ج) عمّال عملة. (العمل): المهنة والفعل (ج) أعمال. وأعمال المركز ونحوه { في التقسيم الإداري }: ما يكون تحت حكمه ويضاف إليه. و { في الاقتصاد }: مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة ” (مذكور، 1984م: 651).
” (خدمه): قام بحاجته فهو وهي خادم. (ج) خدم، وخدام، وهي خادمة، (تخدم) خادما: اتخذه. (اختدم): خدم نفسه، وفلاناً: سأله أن يخدمه ” (المرجع السابق: 229).
اصطلاحا:
ويعرف (محي الدىن، 1997م: 10) ” خدمة المنازل هو العمل الذي يقوم به نساء أو رجال في المنزل مقابل أجور متفق عليها”.
يشير (الشهراني، 1997م: 30) إلى أن الخدم ” يطلق على كل من يقومون بالأعمال المهنية أو الحرفية أو يقومون بخدمات النظافة وما شابه ذلك. وذلك عام على جميع فئات العمالة الأجنبية مثل العمالة العربية، والعمالة الإفريقية والعمالة الآسيوية، والعمالة الأوروبية وخلافه “.
وتقول (الأنصاري، 1988م: 67) ” إن الخادمة الأجنبية المرأة الغريبة عن المجتمع السعودي في العادات والتقاليد والأعراف وربما الدىن تعمل لدى الأسرة السعودية ولها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتربية الطفل ومن ثم ينصب أثرها على الأسرة والمجتمع ككل “.
التعريف الإجرائي للعمالة المنزلية الأجنبية:
هي العاملة أو الخادمة التي تقوم بأعمال المنزل من (تنظيف، طبخ، اعتناء بالأطفال) وتكون من جنسية أخرى غير الجنسية العربية، وتؤدي أعمال ذات طبيعة معاونة، تعتمد على التدريب والممارسة والخبرة العملية، ولا تحتاج إلى مؤهلات خاصة إلا في النادر، وتسكن في الغالب مع الأسرة وتعيش كأحد أفرادها فترة مؤقته أو مستمرة تنتقل هنا وهناك داخل المنزل مما يتيح لها الاطلاع على أسراره، وفي أثناء ذلك يتحمل رب الأسرة تكاليف الإقامة ويقدم لها أجراً تم الاتفاق عليه مسبقاً وفق عقود معينة نظير خدماتها.
المؤسسات التربوية:
يعرف (النحلاوي، 1999م: 119) ” المؤسسات التربوية بالوسائط التي يتم بداخلها تربية وتعليم النشء والإشراف على نموهم وإعدادهم للحياة، كالمنزل ورياض الأطفال والمدرسة والإعلام “.
الدور (لغة):
” (الدور): الطبقة من الشيء المدار بعضه فوق بعض. يقال: انفسخ دور عمالته. و (عند المناطقة): توقف كل من الشيئين على الآخر. (ج) أدوار ” (مدكور، 1984م: 313).
ويعرف (مدكور، 1975م: 471) ” دار الشيء إذا عاد إلى الموضوع الذي ابتدأ منه “.
اصطلاحا:
يعرف (الزبيدي، 1982م: 315) ” الدور بأنه وضع اجتماعي ترتبط به مجموعة من الخصائص الشخصية ومجموعة من ضروب النشاط التي يعزو إليها القائم بها في المجتمع معاً قيمة معينة، هذا من جانب البناء الاجتماعي، أما من جانب التفاعل الاجتماعي فهو صياغ مؤلف من مجموعة من الأفعال التي يؤديها الشخص في موضوع تفاعل اجتماعي “.
ويعرف (نشوان، 1985م: 109) الدور بــ ” ما يقوم به كل فرد من وظائف ومهام مناطه به باعتباره عضواً في تنظيم أو مؤسسة ما، إذ أن كل فرد في أي تنظيم لديه أدوار محددة يجب أن يقوم بها “.
التعريف الإجرائي للدور:
ما يمكن أن تقوم به المؤسسات التربوية في الحد من تأثير العمالة المنزلية الأجنبية في تنشئة طفل ما قبل المدرسة من أدوار وقائية أو علاجية.
التنشئة:
لغة: ” (نشأ) الشيء – نشئاً، ونشوءاً، ونشأة: حدث وتجدد. و – (ونشأ) الصبي: رباه، يقال: نشئ في النعيم. قال تعالى: (أوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (الزخرف: 18) (مدكور، 1984م: 957).
اصطلاحا:
يعرف (الشربيني وصادق، 2006م: 17) التنشئة الاجتماعية بــ ” العملية التي يتعلم من خلالها الفرد كيف يصبح فرداً في أسرته وعضواً في مجتمعه، وإنها عملية تعلم القصد منها أن ينمي لدى الطفل الذي يولد ولديه إمكانيات هائلة ومتنوعة وسلوك فعلي مقبول ومعتاد وفق معايير الجماعة التي ينتمي إليها “.
المربية:
لغة: ” مأخوذ من كلمة (ربّ) الولد – ربّا: وليّه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه. فالفاعل: راب، والمفعول: مربوب، وربيب ” (مدكور، 1984م: 333).
اصطلاحا:
يعرف (خليفة، 1984م: 35) ” المربية بأنها الخادمة التي تعمل لدى الأسرة وتقوم بأعمال الخدمة المنزلية، ولها علاقة مباشرة أو غير مباشرة برعاية أو تنشئة الأبناء مما يضطلع به الوالدان في الأغلب “.
يعرف (المطيرى، 2001م: 7) ” المربية بأنها من تقوم بتزويد الأبناء بعض المعلومات أثناء معايشتهم في ظل غياب الوالدين أو انشغالهما، وقد تتولى القيام ببعض المسؤوليات مثل إيقاظ الأطفال والإشراف على تغذيتهم أو ملابسهم أو تمريضهم وغير ذلك من واجبات الأم “.
التعريف الإجرائي للمربية:
هي العاملة التي وظيفتها الأساسية الاعتناء بالأطفال من (أكل – شرب – نوم – تمريض – لعب) وفي بعض الأحيان لها وظيفتان: القيام بشؤون المنزل، والاهتمام بالأطفال.
الإطار النظري للدراسة
التغير الاقتصادي والاجتماعي وظاهرة الخادمات الأجنبيات
التغير سنة من سنن الحياة فمنذ أوجد الله البشرية والمجتمعات تمر بمراحل عديدة من التغير حتى وصلت إلى ما هي عليه في الوقت الحاضر، والتغير يشمل جميع ميادين الحياة المادية والاجتماعية والثقافية والسلوكية مما يؤثر على أنماط حياتية كثيرة منها على سبيل المثال ظاهرة الخدم واستفحالها في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية وما ترتب على ذلك من آثار إيجابية وسلبية على الأسرة عموماً والطفل خصوصاً.
المتغيرات المجتمعية التي طرأت على الأسرة السعودية:
إن التغيرات السريعة التي مرت بالمجتمع السعودي في مسيرته التنموية، قد أحدثت تطور في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ؛ ويرجع أسباب هذا التطور إلى عاملين رئيسيين: أولهما داخلي / يتركز في توحيد المملكة العربية السعودية، واكتشاف البترول وما نتج عنه من تحسن مستويات المعيشة بارتفاع الدخل، وانتشار التعليم في المدن والقرى والهجر، وتغير حياة المواطنين من نمط حياة قائم على التنقل والترحال إلى نمط مستقر يعتمد على واردات النفط.
وثانيها خارجي / يتركز في انتشار وسائل التقنية الحديثة التي أدت لانفتاح المجتمع السعودي على الثقافات المختلفة ؛ محدثاً العديد من التغيرات البنائية في المجتمع السعودي (الخطيب، 2011م: 2). وجدير بالذكر أن التغير ظاهرة طبيعية تخضع لها كافة المجتمعات الإنسانية، فالتغير سنة من سنن الحياة. فالبشرية منذ وجدت، والمجتمعات تمر بمراحل متعددة من التغير حتى وصلت إلى ما هي عليه في الوقت الحاضر. “وليس من الضروري أن يكون ذلك التغير إلى الأفضل ” (الأنصاري، 1988م: 21).
فكلما استوعب المجتمع مستحدثات التغير ومتطلباته، وتكيف أفراده مع آثار هذا التغير وكانوا أكثر مرونة، كلما كان التغير متوازناً وسعى للأفضلية (الخشاب، 1967 م: 199). والمجتمع القويم هو الذي يبحث عن التفاعلات الاجتماعية ذات التأثيرات الإيجابية ليحقق هذه الأفضلية، ويتجنب أو على الأقل يقلل من حدة التفاعلات ذات الانعكاسات السلبية. (نجيب وآخرون، 1993م: 35).
ولعل للاحتكاك الحضاري والثقافي دور في إحداث التغيير، حيث أن التغير الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ساهم بدور بارز في الزيادة الهائلة في الطلب على الخدم بصفة عامة والخادمات بصفة خاصة، حتى أصبحت ظاهرة مألوفة لدى جميع طبقات المجتمع بل وحتى في القرى والهجر، ومحور الاهتمام السائد لدى هؤلاء العامة، الآثار المادية المترتبة على التوسع في استخدام هذه العمالة، مع إشارات جانبية للآثار الاجتماعية والتربوية الكامنة خلف التدفق البشري غير العربي الذي تتعرض له المملكة، بكل ما يحمله من تغيرات ثقافية بعيدة المدى، خاصة مع استمرارية هذا الحال مستقبلاً (خليفة، 1984م: 11).
ويعتبر العامل الاقتصادي من أهم العوامل المجتمعية التي طرأت على الأسرة السعودية والتي ساعدت على بروز وانتشار ظاهرة العمالة المنزلية الأجنبية، فمنذ أوائل الخمسينيات والاقتصاد السعودي ينمو بمعدل سريع، حتى وصل إلى مرحلة الطفرة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع في الآونة الأخيرة. هذه الطفرة الاقتصادية ساهمت ولا تزال في تغيير شكل الفرد والمجتمع، وأشكال التغيير كثيرة لعل من أبرزها ظاهرة استقدام الخدم والمربيات.
ولقد انتشر استخدام الخدم منذ بداية الثمانينات، وذلك مع بداية فتح مجال الاستقدام، والذي بدأ في عام 1389ه حيث شكلت لجنة لمنح تأشيرات الاستقدام، وأتاحت الدولة فرصة الاستقدام للجميع بشروط واضحة لدى مكاتب الاستقدام، ثم أصبحت عملية الاستقدام أكبر في عام 1395ه حيث صدر الأمر السامي بالسماح بمنح التأشيرات، وامتازت هذه الفترة بمرحلة جديدة ونقلة كبيرة للأسر السعودية (العيدان، 1993م: 13، 67 – 68)، متمثلة في ارتفاع معدلات دخل الفرد وبالتالي ارتفاع مستوى معيشته، وما تبعه من تغير في نمط الحياة ؛ الذي شمل كل مظاهرها من حيث: تطور المسكن، كبر حجمه، واتساع مرافقه، وتجهيزه بأفضل الأثاث، وتزويده بكل أنواع الأجهزة والأدوات المنزلية الحديثة. كذلك تنوع الملبس والمأكل والمشرب، واستخدام أحدث موديلات السيارات، وغير ذلك من وسائل الحياة العصرية (السرحان، 2009م، 31).
” فتغيرت النظرة التقييمية للأشياء فما كان كماليا أصبح ضرورياً ” (العيدان، 1993، 68). ولو نظرنا إلى وضع الأسرة السعودية قبل اكتشاف البترول، لوجدنا أن الأسر كانت كبيرة (ممتدة) تقوم فيها المرأة بتحمل مسؤولية المنزل وتربية الأطفال، على الرغم من عدم توفر الأجهزة الحديثة التي تساعدها على هذه الأعباء، كما يقع على عاتقها رعي الماشية وتعليفها وحلبها وجلب الماء للأسرة وطحن الدقيق وصنع الخبز، كل ذلك كان مرهقاً لها، ولكن الجميع يمد يد العون لها في إنجاز هذه الأعمال من أبناء وأقارب وجيران وجد وجدة. أما بعد اكتشاف البترول وتحسن الوضع الاقتصادي فقد انشغلت المرأة بطلب العلم، والعمل في المجال المناسب لها ؛ لتشارك الرجل في بناء البنية الأساسية للمجتمع، وتسهم بدورها في حركة التقدم والرقي الذي يشهده الواقع الآن.
وقد ترتب على انشغال المرأة، عدم تفرغها بالقدر الكافي للقيام بكافة شؤون المنزل، وتربية الأطفال، مما أدي إلى احتياجها لعنصر مساعد يعينها على الوفاء بتلك الأعباء المنزلية وإن كان من دخلها الخاص، فأقبلت الأسرة السعودية على عملية استقدام الخادمات الأجنبيات من البلاد الإفريقية، تلاها البلاد الآسيوية ؛ نظراً لانخفاض أجورهن وتدني مستوى المعيشة في بلادهن، ورغبة هذه العمالة في تحسين الوضع الاقتصادي لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفر مكاتب الاستقدام وسهولة التواصل مع هذه المكاتب، كذلك سهولة تنظيم هذه العملية عن طريق عقود مبرمة بين الطرفين لحفظ حقوق كلاً من الخادم والمخدوم.
الدراسات السابقة:
أجريت مجموعة من الدراسات التي تناولت ظاهرة العمالة الأجنبية بالوصف والتحليل والتفسير لمعرفة حجمها وأسبابها وآثارها. وركز بعض منها على الخادمات والمربيات وكشفت لنا عن خطورة هذه الظاهرة مما أفرزته من مشاكل اجتماعية ونفسية وأخلاقية ولغوية وأمنية على المجتمع الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً. واستكمالا لما بدأ به الآخرون سعت الباحثة لبلورة مشكلة الدراسة من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة الحديثة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الدراسة من خلال زيارة المكتبات المركزية مثل مكتبة: جامعة أم القرى، جامعة الملك عبد العزيز، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، جامعة الملك سعود، مكتب التربية العربي لدول الخليج، جامعة طيبة، جامعة الأمير نايف للعلوم العربية والتصفح عبر مواقع الإنترنت بهدف تناول أوجه الشبه والاختلاف وتحديد ما ستسهم به الدراسة الحالية في حقل الدراسات السابقة. ومن أبرز هذه الدراسات السابقة ما يلي:
الدراسة الأولى:
دراسة (عبدالعال 1995) بعنوان ” التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الأسرة السعودية وعلاقتها بأنماط الاستهلاك في مدينة جدة “.
من أهم الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة الكشف عن العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في المجتمع السعودي وبين أنماط الاستهلاك المختلفة التي انتشرت بين أفراد المجتمع، كذلك التعرف على الطرق المختلفة للحد من الاستهلاك والترشيد المنبثقة من التعاليم الدينية. ولتحقيق تلك الأهداف استعانت الباحثة بمنهج المسح الاجتماعي الوصفي للحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات خلال الاستبانة. وقد أجريت الدراسة على عينة من الأسر السعودية في مدينة جدة بلغ حجمها (252) أسرة.
وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
- اتضح من الدراسة أن هناك اتجاها ملحوظاً في المجتمع نحو الاستهلاك بجميع أنماطه، ولكن الفئة المتعلمة تحد جزئياً من ذلك الاستهلاك. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن هناك نسبة من أفراد المجتمع سريعي التأثر بالدعاية والإعلان ؛ بسبب الطرق الحديثة والمتطورة للإعلان، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك، كما ساهمت التسهيلات الائتمانية للاستيراد على زيادة الاستهلاك وخلق حاجات جديدة للأفراد.
- إن هناك نسبة كبيرة من الأسر السعودية تستعين بالخدم في المنازل وإن هناك أكثر من خادمة في بعض المنازل مما يشكل خطر واضح على الأسرة من تداخل القيم لدى أفرادها وخصوصاً الصغار للقدرة السريعة على الاستيعاب. وقد كشفت الدراسة عن وجود أعداد كبيرة من الخدم الذين يعملون في الأسرة التي بها زوجة عاملة، وترى الباحثة أن ذلك يشكل خطراً على النشء، وتقترح على السيدة العاملة أن تتوقف عن العمل في الأوقات التي تكون فيها لديها حضانة لأحد أطفالها على أن تعود لمزاولة عملها بعد أن يقوى طفلها ويلتحق برياض الأطفال.
الدراسة الثانية:
دراسة (الزوم 1995م) بعنوان “اتجاهات المرأة السعودية نحو العمل المنزلي والعوامل المؤثرة عليها”.
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المبحوثات نحو العمل المنزلي، والتعرف على مدى تأثير بعض العوامل على هذه الاتجاهات. ولقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي بطريقة المسح الاجتماعي، واستخدمت الاستبيان لاستقصاء آراء عينة من النساء السعوديات المتزوجات والمقيمات في مدينة الرياض.
أهم نتائج الدراسة:
- أن النساء السعوديات العاملات بمهنة التعليم يمثلن (6,71 %).
- أن العمل المنزلي يحتل المرتبة الأولى بين غيره من الأعمال.
- إن سبب إحجام بعض المبحوثات عن القيام بالأعمال المنزلية يعود إلى وجود الخادمات والعمل خارج المنزل.
- إن غالبية المبحوثات يعتمدن على الخادمات في ممارسة بعض الأعمال المنزلية.
الدراسة الثالثة:
دراسة (النبوي 1997م) بعنوان ” عمل المرأة وأثره على تنشئة أبنائها “. ولقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التحولات التي طرأت على سلوكيات المرأة وأدوارها تجاه أبنائها وكيفية تحديد مستقبلهم الدراسي ودرجة الحرية المعطاة لهم فيما يتعلق بشؤونهم الحياتية، وهل تختلف المرأة العاملة عن غير العاملة تجاه مسؤولياتها التربوية. ويتألف مجتمع الدراسة من كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية والبالغ عددها اثنتي عشرة محافظة، وقد تم استخدام المنهج التجريبي، واعتمد على الاستبيان كأداة لجمع البيانات.
وإن ما جاءت به هذه الدراسة من نتائج لم توضح أن هناك آثار سلبية لعمل المرأة، بل أظهرت البيانات أن دور عمل المرأة على موقفها وسلوكها التربوي تجاه أبنائها له من الإيجابيات التي ترقى بمستوى أبنائها على جميع المتغيرات التي تضمنتها الفرضيات، هذا بالإضافة إلى أن البيانات الإحصائية أثبتت فرضيات الدراسة من حيث تأثير عمل المرأة إيجابياً على طريقة تعاملها مع أبنائها فهي أكثر ميلاً لاستخدام الحوار والمناقشة مع الأبناء من المرأة غير العاملة وأقل منها ميلاً للاستسلام والخضوع لرغباتهم واستخدام أسلوب السيطرة والتسلط في علاقتها مع أبنائها، والمرأة العاملة أكثر نجاحاً في متابعتها لدراستهم ومساهمتها في القرارات المتعلقة بمستقبل الأبناء. وهذا ما يدفعنا للقول بأن هذه النتائج مبشرة على صعيد التوازن الاجتماعي والتطور الحضاري.
الدراسة الرابعة:
دراسة ( الشهراني 1997م) عن ” العمالة الآسيوية النسوية وأثرها على انحراف الأحداث في المجتمع السعودي “. وقد هدفت الدراسة إلى:
- تحليل ظاهرة انتشار العمالة الآسيوية النسوية في مجال الخدمات المنزلية داخل المجتمع السعودي ومحاولة تحديد أبعادها والتعرف على مدى تأثيرها على انحراف الأحداث.
- الوقوف على حجم تلك الظاهرة والعوامل الكامنة وراء انتشارها وعلاقتها بانحراف الأحداث.
- تحديد دور العمالة الآسيوية داخل الأسرة السعودية.
- رصد أهم المتغيرات المعاصرة التي طرأت على المجتمع العربي بوجه عام والأسرة بوجه خاص وعلاقة ذلك بالعمالة النسوية.
ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقة المسح الاجتماعي واستعان بنموذج الاستبيان كأداة رئيسية من أدوات الدراسة العلمية.
أهم النتائج:
- تنامي العمالة الآسيوية النسوية في مجال الخدمات المنزلية واستفحال تلك الظاهرة بغض النظر عن الفوارق الاقتصادية والتعليمية بين الأفراد.
- كشفت الدراسة عن محدودية علاقة خروج المرأة للعمل باستقدام الخادمات الأجنبيات وذلك لتدني مشاركة المرأة في مجالات العمل في المجتمع السعودي.
- وجود سلبيات لظاهرة الاستعانة بالخادمات سواء على التنشئة الاجتماعية للأبناء، والتأثير غير المباشر على الأحداث.
- تبين من خلال الدراسة أن العلاقة بين دخل الأسرة واستقدام الخادمات علاقة محدودة وضعيفة، نظراً لانتشار تلك الظاهرة بين كافة الأوساط والمستويات.
الدراسة الخامسة:
دراسة (المطيرى، 2001م) عن ” أثر استخدام المربيات الأجنبيات على التنشئة الاجتماعية للطفل الكويتي “.
هدفت الدراسة إلى:
- التعرف على أثر استخدام المربيات الأجنبيات على التنشئة الاجتماعية للطفل الكويتي.
- الكشف عن الاختلافات الجوهرية بين أساليب التنشئة الاجتماعية للمربية الأجنبية والأسرة الكويتية.
- التعرف على حجم الظاهرة ومدى انتشارها في المجتمع الكويتي.
- تحديد الأدوار التي تقوم بها المربية الأجنبية تجاه الأطفال.
- تحديد الفروق الجوهرية بين قيم وعادات المربية وقيم وعادات الأسرة الكويتية.
- الوصول إلى حلول مقترحة لمواجهة الآثار المترتبة على استخدام المربيات الأجنبيات.
وقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي باستخدام العينة (150) أسرة عشوائية من المجتمع الكويتي، (50) مفردة عشوائية من المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل. واستعان الباحث بالمقابلة شبه المقننة واستمارة الاستبيان. أهم النتائج:
- أن 70 % من الأسر الكويتية يستخدمون مربية أجنبية لأطفالهم.
- تشير الدراسة إلى أن كثرة الأعباء المنزلية وكثرة عدد أفراد الأسرة وخروج المرأة للعمل من الأسباب الرئيسية لاستخدام المربية الأجنبية.
- يوجد تأثير للمربية الأجنبية على التنشئة الاجتماعية للطفل الكويتي.
- تتعدد مظاهر التأثير للمربية الأجنبية على الطفل الكويتي من حيث اعتماد الطفل عليها واكتساب الطفل للغة المربية ومحاكاتها في عاداتها وتقاليدها.
- لا تقوم الأسر الكويتية بعمليات الاختيار الدقيق والمقنن للمربيات ويرجع ذلك إلى عدم توافر الوقت للاختيار وكثرة الأعباء الأسرية وارتفاع أجور المربيات.
الدراسة السادسة:
دراسة (الدعيج، 2002م) عن ” العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة وعلاقتها بالأمن “.
هدفت الدراسة إلى ما يلي:
- التعرف على المحاذير الاجتماعية من قبل العمالة الوافدة.
- التعرف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى مخالفة نظام الإقامة من قبل العمالة الوافدة.
- التعرف على الإجراءات والأنظمة التي تحد من مخالفة نظام الإقامة.
- التعرف على الخصائص البارزة للعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة.
- التعرف على الأسباب المهمة لقدوم العمالة الوافدة إلى المملكة.
اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي، بينما مجتمع الدراسة يتكون من المسؤولين بإدارات الجوازات وإدارات مراقبة ومتابعة الوافدين بالمنطقة الشرقية وعددهم (38) فرداً ومن العسكريين من منسوبي جوازات المنطقة الشرقية وعددهم (850) فرداً ومن مخالفي نظام الإقامة من الموقوفين بإدارات مراقبة ومتابعة الوافدين بالمنطقة الشرقية (7340) فرداً والموجودين عند تطبيق الدراسة. وعليه كانت عينة الدراسة العينة العمدية. وقد قام الباحث بعمل لقاءات عن طريق المقابلات الشخصية والاستعانة بالاستبانة لجمع المعلومات.
وتوصل إلى عدة نتائج منها:
- وجود محاذير اجتماعية من قبل العمالة الوافدة.
- هناك دور سلبي للمواطن السعودي في ازدياد مخالفة نظام الإقامة من قبل العمالة الوافدة.
- هناك خصائص بارزة للعمالة المخالفة لنظام الإقامة ومنها الجنسيات الأجنبية (غير العربية) من العمالة الوافدة وهي الأكثر مخالفة لنظام الإقامة.
- وجود أسباب هامة لقدوم العمالة الوافدة إلى المملكة.
العلاقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
ناقشت الدراسات السابقة ظاهرة العمالة المنزلية غير العربية وآثارها الاجتماعية والثقافية والأمنية واللغوية على الدولة والأسرة والأبناء، وما أحدث هذه الظاهرة من تسهيل عمل المرأة وتغيرات اجتماعية واقتصادية في الأسر الخليجية.
واتفقت أغلب هذه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في وحدة المنهج (المسح الاجتماعي)، ونوع الدراسة وصفية، والاعتماد على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، ودراسة آثار العمالة الأجنبية الإيجابية والسلبية.
إلا أن هناك نقاط اختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في أمور عدة منها:
- المنطقة التي طبقت فيها كل دراسة.
- عينة كل دراسة، فمثلاً في دراسة (عبد العال) استعان بعينة من أرباب الأسر التي تستخدم مربية. كما في دراسة (أحمد وآخرون) طبق على عينة من أرباب الأسر ذكوراً وإناث. وفي دراسة (الخضيرى) طبق على أولياء أمور طلبة جامعة الملك سعود. بينما في دراسة (المطيرى) اعتمد على عينة من الأسر وعينة أخرى المسئولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وفي دراسة (الدعيج) استعان بعينة من المسئولين بإدارات الجوازات وإدارات مراقبة ومتابعة الوافدين وعينة أخرى من مخالفي نظام الإقامة بتلك الإدارات. وفي دراسة (المرشدي) استعان بعينة من المسؤولين والمواطنين. كما في دراسة (العتيبي) استعان بعينة من دعاة مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة الرياض. بينما في دراسة (السبيعي) طبقت على عينة من النساء العاملات في قطاع التعليم. وفي دراسة (الزوم) استعانت بعينة من النساء السعوديات المتزوجات. في حين أن الدراسة الحالية استعانت بعينة من الأمهات العاملات اللاتي لديهن خادمة أو مربية وعينة أخرى من الخبراء التربويين.
- حدود الدراسة، فقد صاغ (باحارث) حدود دراسته بدور الأب المسلم في تربية الولد الذكر في مرحلة الطفولة التي تبدأ من الميلاد وحتى البلوغ. بينما البحث الحالي يبحث دور المؤسسات التربوية (الأسرة – رياض الأطفال – الإعلام – الجامعة) في الحد من تأثير العمالة المنزلية الأجنبية على تنشئة طفل ما قبل المدرسة والتي تبدأ من الميلاد حتى ست سنوات.
- في دراسة (أحمد وآخرون) بحث تأثير العمالة المنزلية على الأطفال والأسرة. وفي دراسة (الخضيرى) بحث المشكلات الاجتماعية التي يواجهها الزوجان والأطفال والمجتمع الناتجة عن العمالة المنزلية. وفي دراسة (باحارث) تناول مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في جميع مراحل حياته. بينما البحث الحالي يحاول أن يكون أكثر تخصيصاً وعمقاً فهو يتناول دراسة تأثير العمالة المنزلية الأجنبية على طفل ما قبل المدرسة فقط.
- أهداف الدراسة، فقد هدفت دراسة (الدعيج)، دراسة (الشهراني)، دراسة (السرحان)، إلى التعرف على أثر العمالة الأجنبية بصفة عامة على المجتمع السعودي من الناحية الأمنية. كذلك هدفت دراسة (العتيبي) إلى معرفة أثر العمالة الأجنبية على الأسرة من الناحية الدينية. بينما في دراسة (الزكري)، دراسة (المطيرى)، ودراسة (الخضيرى) فقد ركزت على أثر العمالة المنزلية الأجنبية على الأسرة السعودية من الناحية الاجتماعية. في حين دراسة (عبدالعال)، دراسة (البنوي) تناولت المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في الأسرة السعودية وأدت إلى ظهور الخدم. والبحث الحالي يهدف إلى بيان دور المؤسسات التربوية في الحد من تأثير العمالة المنزلية على تنشئة طفل ما قبل المدرسة.
- نتائج الدراسة، فقد توصلت دراسة (السبيعي) إلى ثمة مقترحات للتغلب على المشكلات المترتبة عن استخدام العمالة المنزلية منها دور الأم، الرقابة. بينما في البحث الحالي سوف يحاول الجمع بين دور الأسرة ودور المؤسسات التربوية للتغلب على المشكلات المترتبة عن استخدام العمالة المنزلية الأجنبية.
- كل نقاط الاختلاف السابقة الذكر تثبت وجود فائدة مرجوة من هذه الدراسات ؛ وإلا لما تم ذكرها. فعلى سبيل المثال عند مقارنة الإحصاءات الرسمية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة، ووزارة الداخلية المتعلقة بالعمالة غير السعودية داخل المملكة في الأعوام السابقة ومقارنته بعام 1433ه ؛ لوجدنا ارتفاع معدل نمو العمالة الأجنبية سنة بعد أخرى ؛ مما ينذر بخطر وشيك يستحق إعادة الدراسة حول هذا الموضوع.
(أ) إجراءات الدراسة:
يناقش هذا الفصل منهج الدراسة الذي استخدمته الباحثة في دراستها، ويحدد مجتمع الدراسة والعينة وخصائص أفراد العينة، ويستعرض الإجراءات التي استخدمت بناء أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها، وأخيراً يستعرض تطبيق الدراسة الميدانية والأساليب الإحصائية التي استخدمت في معالجة بياناتها من أجل تحقيق أهدافها والإجابة عن أسئلتها البحثية.
أ- منهج الدراسة:
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والهدف من استخدام هذا المنهج هو جمع الحقائق والمعلومات والملاحظات عن ظاهرة معينة ووصف الظروف المحيطة بها وتقرير حالتها كما توجد في الواقع وتحليلها تحليلاً دقيقاً وتحديد المشكلة وتبرير الظروف والممارسات والتعرف على ما يعمله الآخرون في التعامل مع الحالات المماثلة دون أن يتجاوز ذلك دراسة العلاقة أو استنتاج الأسباب، وإنما يسعى للوصول إلى تعميمات وتوصيات ووضع خطط مستقبلية عن موضوع الدراسة (القحطاني وآخرون، 2004م)، (العساف، 2003م)، (فان دالين، 1994م).
ب- مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من الأمهات العاملات، والخبيرات التربويات المختصات في مجال العمالة المنزلية، حيث قامت الباحثة بتوزيع (500) استبانة على الفئتين بالتساوي، (250) لكل فئة، وبعد جمع الاستبانات كان العدد الصالح منها للتحليل الإحصائي (261) منها (165) للأمهات العاملات و (96) للخبيرات التربويات وبنسبة فاقد بلغ إجمالي حوالي 48 %.
ب – 1 خصائص عينة الدراسة:
أولاً عينة الأمهات العاملات:
توضح الجداول والرسوم البيانية التالية الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة من الأمهات العاملات، باستخدام الباحثة للتكرارات والنسب المئوية والرسوم البيانية من خلال التوزيعات التكرارية لكل متغير من المتغيرات الديموغرافية.
بالنسبة لمتغير الوظيفة: أن (92 %) من عينة الدراسات يعملن معلمات، و (5 %) من عينة الدراسة يعملن في وظائف إدارية، و (2 %) من عينة الدراسة طالبات، و (1 %) من عينة الدراسة يعملن في وظائف فنية ( وقد تم دمج الفئتين: فنية وطالبة في فئة واحدة وذلك بهدف تحقق شرط استخدام تحليل التباين الأحادي عند الربط ما بين المتغير ومحاور الاستبانة في جزء التحليل الاستدلالي وذلك لأن النظرية الإحصائية تقول أنه لا يمكن إجراء التحليل الإحصائي من خلال الربط بين المتغيرات إذا كان عدد أفراد العينة في الفئة أقل من 5)، وبهذا يلاحظ أن النسبة الأكبر من العينة التي شملتها الدراسة من اللاتي يعملن أعضاء هيئة تدريس.
بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي: أن (97 %) من عينة الدراسة مؤهلهن العلمي بكالوريوس، و(2 %) من عينة الدراسة مؤهلهن العلمي دكتوراه، و (1 %) من عينة الدراسة مؤهلهن العلمي ماجستير ( وقد تم دمج الفئتين: ماجستير ودكتوراه في فئة واحدة، ورغم ذلك فإنه لن يتم الربط بين هذا المتغير ومحاور الدراسة لأنه رغم الدمج إلا أن عدد الأفراد في فئة الدمج تبقي 4 وهي أقل من 5، وبالتالي عدم تحقق شروط النظرية الإحصائية )، وبهذا يلاحظ أن النسبة الأكبر من العينة التي شملتها الدراسة مؤهلهن العملي بكالوريوس.
بالنسبة للمتغير العمر: أن (45 %) من عينة الدراسة عمرهن من 20 إلى أقل من 30 سنة، و (48 %) من عينة الدراسة عمرهن من 30 إلى أقل من 40 سنة و (7 %) من عينة الدراسة عمرهن 40 سنة فأكثر، وبهذا يلاحظ أن النسبة الأكبر من العينة التي شملتها الدراسة اللاتي عمرهن من 30 إلى أقل من 40 سنة.
بالنسبة لمتغير عدد الأبناء: أن (56 %) من عينة الدراسة لديهن عدد إثنين من الأولاد، و(30 %) من عينة الدراسة لديهن عدد واحد من الأولاد، و (12 %) من عينة الدراسة لديهن عدد ثلاث من الأولاد، و (1 %) من عينة الدراسة لديهن عدد أربع من الأولاد، و (1 %) من عينة الدراسة لديهن عدد خمس من الأولاد (وقد تم دمج الفئات الثلاث: ثلاث أولاد وأربعة وخمسة، في فئة واحدة وهي “ثلاثة فأكثر” وذلك بهدف تحقق شرط استخدام تحليل التباين الأحادي عند الربط ما بين المتغير ومحاور الاستبانة في جزء التحليل الاستدلالي وذلك لأن النظرية الإحصائية تقول أنه لا يمكن إجراء التحليل الإحصائي من خلال الربط بين المتغيرات إذا كان عدد أفراد العينة في الفئة أقل من 5)، وبهذا يلاحظ أن النسبة الأكبر من العينة التي شملتها الدراسة من اللاتي لديهن عدد إثنين من الأولاد.
بالنسبة لمتغير الحالة الاجتماعية: أن (79 %) من عينة الدراسة متزوجات، و (2 %) من عينة الدراسة مطلقات، و(1 %) من عينة الدراسة أرامل (وقد تم دمج الفئتين: مطلقة أو أرملة في فئة واحدة، ورغم ذلك فإنه لن يتم الربط بين هذا المتغير ومحاور الدراسة لأنه رغم الدمج إلا أن عدد الأفراد في فئة الدمج تبقي 4 وهي أقل من 5 بالتالي عدم تحقق شروط النظرية الإحصائية)، وبهذا يلاحظ أن النسبة العظمي من العينة التي شملتها الدراسة متزوجات.
بالنسبة لمتغير وجود خادمة: أن (84 %) من عينة الدراسة لديهن خادمات، و (16 %) من عينة الدراسة لا يوجد لديهن خادمات، وبهذا يلاحظ أن النسبة الأكبر من العينة التي شملتها الدراسة لديهن خادمات.
الخصائص السيكو مترية للأداة:
أولاً: الصدق:
قامت الباحثة بالتأكد من صدق الأداة من خلال استخدام نوعين من أنواع الصدق: الصدق التحكيمي (الظاهري) والصدق البنائي (صدق الاتساق الداخلي) للأداة.
الصدق الظاهري (صدق المحكمين): للتأكد من الصدق الظاهري للاستبانة وأن الفقرات في كل محور من المحاور كانت واضحة ومناسبة، فقد قامت الباحثة بتحكيمها لدى مجموعة من الأساتذة المختصين والخبراء.
وقد طلبت الباحثة من السادة المحكمين إبداء آرائهم حول الأداة المناسبة لعباراتها، ومدى انتمائها للمحاور التي أدرجت تحتها والتأكد من سلامتها اللغوية، ودرجة وضوح صياغتها، ومدى ملائمتها لقياس ما وضعت من أجله، وإمكان تعديل أو حذف أو إضافة بعض العبارات. وبناءاً على ذلك فقد حصلت الباحثة على مجموعة قيمة من الملاحظات، والتي على ضوئها قامت بتعديل بعض عبارات الاستبانة، واستبعاد العبارات غير المناسبة، وذلك من خلال قيام الباحثة بإجراء مقارنة بين آراء المحكمين حول الفقرات التي أثيرت حولها بعض الملاحظات، وتم الأخذ بالآراء الأكثر اتفاقا نحو المفردات، سواء من حيث الحذف، أو التعديل.
معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الأول ” دور الأسرة في الحد من تأثير الخدم على تنشئة طفل ما قبل المدرسة ” من وجهة نظر الأمهات العاملات، وبين العلامة الكلية للمحور.
| م | العبارة | معامل الارتباط |
| 1 | في حال إرضاع طفلي صناعياً تقوم الخادمة بذلك. | 1790 |
| 2 | أجلس مع طفلي في غرفة نومه وأتحدث معه باستمرار. | 1620 |
| 3 | يميل طفلي للانضمام للأصدقاء حتى في وجود الخادمة. | 1770 |
| 4 | طفلي يقضي معظم الوقت مع الخادمة. | 630 |
| 5 | تتم دراسة مدى الاحتياج للخادمة قبل استقدامها. | 2640 |
| 6 | أسرتي تهتم بأسس اختيار الخادمة. | 3680 |
| 7 | أسرتي تتعاون معي في أعباء المنزل حتى في وجود الخادمة. | 2680 |
| 8 | أقدم لأبنائي حوافز مادية وهدايا لمساعدتي في أعباء المنزل حتى في وجود الخادمة. | 3660 |
| 9 | أفهم طفلي باستمرار أن الخدم غرباء وليسوا من أفراد الأسرة. | 980 |
| 10 | أقوم بتسليم راتب خادمتي نهاية كل شهر بانتظام. | 2660 |
د- إجراءات الدراسة:
تم تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة من الأمهات العاملات والخبيرات التربويات وفقاً للخطوات التالية:
- حصلت الباحثة على موافقات الجهات المعنية لتطبيق الدراسة.
- أعددت الباحثة خطة زمنية تحدد التوقيت الذي يتم فيه كل إجراء من الإجراءات الميدانية للدراسة.
- حددت الباحثة عناصر وأفراد مجتمع الدراسة وقامت باختيار العينة بالطريقة المناسبة.
- قامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة (الاستبانة) على أفراد العينة -من الفئتين- مرفقة بالخطابات الرسمية التي تحثهم على تعبئة الاستبانة لغرض الدراسة العلمية.
- قامت الباحثة باستعادة الاستبانات التي وزعتها على أفراد العينة.
- استخدمت الباحثة حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لغرض التحليل الإحصائي وللإجابة على السؤال الأخير من أسئلة الدراسة وذلك بعد إدخال البيانات للبرنامج.
- تم التأكد من الخصائص السيكو مترية لأداة الدراسة من خلال معاملات الصدق والثبات، ثم تحليل استجابات أفراد العينة من الفئتين.
- كتابة النتائج وتحليلها وتفسيرها وربطها بنتائج الدراسات السابقة ومن ثم الخروج بعدة توصيات ومقترحات.
هـ – أساليب المعالجة الإحصائية:
لقد قامت الباحثة بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج SPSS الإحصائي وتم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:
- النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
- معامل الثبات ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة المستخدمة في جمع البيانات.
- معامل ارتباط بيرسون لقياس الصدق البنائي للاستبانة.
- حساب معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العلاقة بين المحاور المختلفة.
- اختبار ت للعينات المستقلة للفرق بين متوسطين.
- تحليل التباين الأحادي (One – Way – Anova) لدلالة الفروق بين المتوسطات.
- اختبار المقارنة البعدي (LSD) ” فرق المعنوية الأقل ” لبيان دلالة الفروق بين متوسطات المجموعات لاختبار تحليل التباين الأحادي.
نتائج الدراسة
هدفت الدراسة إلى الإجابة عن السؤال التالي:
“ما دور الجامعة في الحد من تأثير العمالة المنزلية على تنشئة طفل ما قبل المدرسة؟”
للإجابة على هذا السؤال استخدمت الباحثة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة من الأمهات العاملات حول فقرات هذا المحور، والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول (2) التكرارات، والمتوسطات، والنسب لاستجابات العيّنة لعبارات دور الجامعة في الحد من تأثير العمالة المنزلية على تنشئة الطفل من وجهة نظر الأمهات العاملات
| م | العبارات | أوافق | أوافق أحياناً | لا أوافق | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الإنحناء | ||||||||||||
| التكرار | % | التكرار | % | التكرار | % | ||||||||||||||
| 1 | يتوفر بالجامعة قادة على مستوى عال من الكفاءة العلمية والتربوية للتصدي لظاهرة خطر الخدم على الأطفال. | 44 | 26,7 | 72 | 43,6 | 49 | 29,7 | 1,9697 | 0,75243 | أوافق أحياناً | |||||||||
| 2 | مناهج الجامعة الحالية قادرة على التصدي لظاهرة خطر الخدم على الأطفال بكليات رياض الأطفال. | 32 | 19,4 | 77 | 46,7 | 56 | 23,9 | 1,8545 | 0,717840 | أوافق | |||||||||
| 3 | تعدّ الجامعة طلابها فكرياً وسلوكياً للزواج وطرق التربية الصحيحة للأطفال. | 58 | 35,2 | 66 | 40 | 41 | 24,8 | 2,1030 | 0,77005 | أوافق أحياناً | |||||||||
| 4 | تتعاون الجامعة مع المؤسسات التربوية الأخرى لمواجهة خطر الخدم على تنشئة طفل ما قبل المدرسة. | 49 | 29,7 | 68 | 41,2 | 48 | 29,1 | 2,0061 | 0,76904 | أوافق أحياناً | |||||||||
| 5 | تقدم الجامعات الندوات الثقافية وبرامج التوعية للطلاب والطالبات من خلال الدورات التدريبية على سبل مواجهة خطر الخدم على الأطفال. | 49 | 29,7 | 75 | 45,5 | 41 | 24,8 | 2,0485 | 0,73920 | أوافق أحياناً | |||||||||
| 6 | إتاحة الفرصة للحوار والمشاركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال ورش عمل لمناقشة خطر الخدم على الأطفال. | 55 | 33,3 | 72 | 43,6 | 38 | 23 | 2,1030 | 0,74592 | أوافق أحياناً | |||||||||
| 7 | تتعاون الجامعة مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بشكل جدي لمواجهة خطر الخدم على تنشئة طفل ما قبل المدرسة. | 50 | 30,3 | 68 | 41,2 | 74 | 28,5 | 2,0186 | 0,76885 | أوافق أحياناً | |||||||||
| 8 | تتعاون الجامعة مع وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت لإنشاء مواقع ثقافية توجه الشباب والفتيات لطرق تربية الطفل والحفاظ عليه. | 59 | 35,8 | 73 | 44,2 | 33 | 20 | 2,1576 | 0,73212 | أوافق | |||||||||
| 9 | تتعاون الجامعات السعودية مع الجامعات العربية المجاورة في التصدي لظاهرة الخدم وخطورتها على تنشئة الطفل. | 47 | 28,5 | 71 | 43 | 47 | 28,5 | 2,0000 | 0,75708 | أوافق | |||||||||
| إجمال المحور الرابع | 2,028956 | 0,750281 | أوافق | ||||||||||||||||
يتضح من الجدول السابق: أن المتوسط الحسابي الكلي لاستجابات أفراد العينة تجاه العبارات الخاصة بــ ” دور الجامعة في الحد من تأثير العمالة المنزلية على تنشئة طفل ما قبل المدرسة من وجهة نظر الأمهات العاملات ” يبلغ 2,03 بانحراف معياري 0,75، وهذا يعني أن أفراد العينة موافقون أحيانا على توفر مفردات هذا المحور، بمعني أنها متحققة بدرجة متوسطة.
أما بالنسبة لاستجابات أفراد العينة على الفقرات، فيمكن تصنيفها تنازلياً على النحو التالي:
جاءت العبارة رقم (37) تتعاون الجامعة مع وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت لإنشاء مواقع ثقافية توجه الشباب والفتاة لطرق تربية الطفل والحفاظ عليه، في المرتبة (الأولى) بمتوسط حسابي بلغ (2,15)، وبانحراف معياري بلغ (0,73)، وبنسبة (35,8 %) أوافق، مقابل (44,2 %) أوافق أحياناً، ورفض ذلك (20 %). نلاحظ أن استجابة بعض أفراد العينة بأنهم غير متأكدين بنسبة (44,2 %) من أن هناك تعاون بين الجامعة والإنترنت في طرح قضية تربية الطفل والحفاظ عليه، وتعزو الباحثة هذه النتيجة لافتقاد التواصل بين الجامعة وبين بعض المؤسسات التربوية كالإعلام وهذا ما يدعو إليه الإطار النظري للدراسة الحالية بأهمية التواصل بين الجامعة وبين الأسرة وبين رياض الأطفال والإعلام وكافة المؤسسات التربوية الأخرى.
جاءت العبارة رقم (32) تعدّ الجامعة طلابها فكرياً وسلوكياً للزواج وطرق التربية الصحيحة للأطفال، في المرتبة (الثانية) بمتوسط حسابي بلغ (2,1)، وبانحراف معياري بلغ (0,77)، وبنسبة (35,2 %) أوافق، مقابل (40 %) أوافق أحياناً، ورفض ذلك (24,8 %). نلاحظ أن استجابة بعض أفراد العينة غير متأكدين وبنسبة (40 %) من أن الجامعة تعدّ طلابها فكرياً وسلوكياً للزواج وطرق التربية الصحيحة للأطفال وتعزو الباحثة هذه النتيجة لقصر مناهج الجامعة على تشكيل ثقافة الشباب وتوجيه أفكارهم وقيمهم وسلوكهم واتجاهاتهم حول الزواج وما ينتج عنه من أطفال وما يحيط بالطفل من مشكلات حتى قبل أن تحدث وكيفية مواجهتها، حتى إذا تزوج الفتي أو الفتاة يكون على علم بمسئوليته تجاه أبنائه في المستقبل. ولقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العويضي، 2009م) والتي بينت ضرورة الاهتمام بالإعداد الثقافي والاجتماعي والنفسي للمقبلين على الزواج من خلال دورات تدريبية معتمدة، وأهمية قيام الجهات الرسمية المتخصصة بفرض حصول الزوجين على رخصة زواج بعد حضور برامج إعدادية وتأهيلية للزواج. وكذلك ضرورة الاهتمام بالثقافة الأسرية وتقديمها في المرحلة الجامعية كمنهج يقدم للشباب من الجنسين لمساعدتهم مستقبلاً على تكوين أسرة وإنجاب أطفال والقدرة على تحمل المسئولية.
وجاءت العبارة رقم (35) إتاحة الفرصة للحوار والمشاركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال ورش عمل لمناقشة خطر الخدم على الأطفال، وفي المرتبة (الثانية) بمتوسط حسابي بلغ (2,1)، وبانحراف معياري بلغ (0. 74 %)، وبنسبة (33,3 %) أوافق، مقابل (43,6 %) اوافق أحياناً، ورفض ذلك (23 %). وتعزو الباحثة كون أعلى نسبة من أفراد العينة غير متأكدين وبنسبة (43. 6 %) من أن الجامعة تتيح حوار مشترك بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيها من خلال ورش عمل تناقش فيه قضايا ومشكلات المجتمع، بل ويرفضون أن الجامعة تقوم بذلك الدور بنسبة (23 %) ما يدل على أن الجامعة لا تؤدي دورها على الوجه المطلوب ؛ لأن الجامعة يقع على عاتقها واجبات يجب أن تؤديها للمجتمع، وتبصير الطالب بقضايا المجتمع ومشكلاته هو جزء من واجباتها.
جاءت العبارة رقم (34) تقدم الجامعات الندوات الثقافية وبرامج التوعية للطلاب والطالبات من خلال الدورات التدريبية على سبل مواجهة خطر الخدم على الأطفال، في المرتبة (الثالثة) بمتوسط حسابي بلغ (2,04)، وبانحراف معياري بلغ (0,73)، وبنسبة (29,7 %) أوافق، مقابل (45,5 %) أوافق أحياناً، ورفض ذلك (24,8 %). نلاحظ أن أغلب أفراد العينة غير متأكدين وبنسبة (45,5 %) من أن الجامعة تعقد دورات تدريبية عن خطر الخدم على الأطفال، وبعض أفراد العينة يرفض وبنسبة (24,8 %) أن الجامعة تقوم بذلك الدور، ما يؤكد أن الجامعة تنفصل عن المجتمع، لذلك يجب تكثيف الجهود في مجال البحث العلمي لكيفية قيام الجامعة بالدور التربوي المناط بها دون الاكتفاء بالمناهج القديمة والاهتمام بتخريج أكبر عدد من الطلاب والطالبات والباحثين والباحثات، والعمل على كيفية توظيف هذه الأبحاث التي على أرفف المكتبات لخدمة كافة فئات المجتمع وتبصير طلاب الجامعة بقضايا ومشكلات المجتمع وكيفية مواجهتها.
جاءت العبارة رقم (36) تتعاون الجامعة مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بشكل جدي لمواجهة خطر الخدم على تنشئة طفل ما قبل المدرسة، في المرتبة (الرابعة) بمتوسط حسابي بلغ (2,01)، وبانحراف معياري بلغ (0,76)، وبنسبة (30,3 %) أوافق، مقابل (41,2 %) أوافق أحياناً، ورفض ذلك (28,5 %). نلاحظ أن بعض أفراد العينة يرفض وبنسبة (28,5 %) أن الجامعة تتعاون مع وسائل الإعلام بالقدر الكافي الذي يصل لمختلف فئات المجتمع في عرض قضايا ومشاكل المجتمع، ما يدعو القائمين على الجامعة للاجتهاد في طرح مشاكل المجتمع واستضافة المختصين والخبراء التربويين فيها لإيجاد الحلول والبدائل للتصدي لهذه المشاكل والقضايا ومن هذه القضايا قضية العمالة المنزلية وازدياد تدفقها في المجتمع السعودي وتأثر الأطفال من وجودها.
جاءت العبارة رقم (33) تتعاون الجامعة مع المؤسسات التربوية الأخرى لمواجهة خطر الخدم على تنشئة طفل ما قبل المدرسة، في المرتبة (الخامسة) بمتوسط حسابي بلغ (2,006)، وبانحراف معياري بلغ (0,76)، وبنسبة (29، 7 %) أوافق، مقابل (41,2 %) أوافق أحياناً، ورفض ذلك (29,1 %). نلاحظ أن بعض أفراد العينة يرفض وبنسبة (29,1 %) أن الجامعة تتعاون مع المؤسسات التربوية الأخرى في حل قضايا المجتمع مثل قضية خطر الخدم على الأطفال، فالجامعة مثلاً لا تتواصل مع الأسرة سوى في مشاكل الطالب دون تناول مشاكل المجتمع مع الأسرة، كما أن الجامعة لا تتعاون مع الإعلام في طرح قضايا المجتمع وقد رفض بعض أفراد العينة ذلك مسبقاً بنسبة (28,5 %) أن يكون للجامعة دور في التعاون مع الإعلام في طرح قضاياها، كما أن الجامعة قد امتلأت مكتباتها بالأبحاث المتعلقة برياض الأطفال ومشاكل الطفولة ولكن لم يخصص أعضاء هيئة تدريس متخصصين لإيصال صوت الباحثين وأقلامهم لهذه الرياض والقائمين عليها وإنما أكتفى بأي بحث علمي أن ينال مُقدمه الدرجة العلمية دون حدوث ذلك التبادل، وحتى إن الدول يتم فيها التبادل التجاري والسياسي والثقافي والاجتماعي والديني، في حين أن الجامعة تنحصر خيراتها وفوائدها لمرتاديها من المثقفين طالبي المصلحة العلمية أو الوظيفية أو المادية، مانعين وإن كان بدون قصد وبسوء تخطيط بقية فئات المجتمع من مختلف فوائدها.
جاءت العبارة رقم (38) تتعاون الجامعات السعودية مع الجامعات العربية المجاورة في التصدي لظاهرة الخدم وخطورتها على تنشئة الطفل، في المرتبة (السادسة) بمتوسط حسابي بلغ (2)، وبانحراف معياري بلغ (0,75)، وبنسبة (28,5 %) أوافق، مقابل (43 %) أوافق أحياناً، ورفض ذلك (28,5 %). يوافق بعض أفراد العينة وبنسبة (28,5 %) من أن الجامعات السعودية تتعاون مع الجامعات العربية في التصدي لخطر الخدم على الأطفال وتعزو الباحثة هذه النتيجة لتوفر بعض الأبحاث حول هذا الموضوع على أرفف مكتبات الجامعات السعودية من مختلف الدول العربية، ولكن أغلب أفراد العينة يرون أن الجامعة تقوم بهذا الهدف أحياناً وبنسبة (43 %) ما يعني أن الأبحاث التي توضع على الأرفف لا تكفي، بل لا بد من اتحاد القائمين على هذه الجامعات في الدول العربية لطرح القضايا والمشكلات العربية على طاولة واحدة في مكان واحد، وعمل تبادل لأعضاء هيئة التدريس الأكفاء بين جامعات الدول العربية، ولا يكتفي بهذا التواصل بهذه اللقاءات والندوات والمحاضرات التي يشترك فيها الطلاب عبر ورش عمل مهيئة لذلك، بل يتم التواصل أيضاً عن طريق وسائل الإعلام المختلفة التي تقرب كل بعيد محققين بذلك ربط قضايا الأسرة بالجامعة السعودية والجامعات من الدول العربية المختلفة والإعلام.
جاءت العبارة رقم (30) يتوفر بالجامعة قادة على مستوى عال من الكفاءة العلمية والتربوية للتصدي لظاهرة خطر الخدم على الأطفال، في المرتبة (السابعة) بمتوسط حسابي بلغ (1,96)، وبانحراف معياري بلغ (0,75)، وبنسبة (26,7 %) أوافق، مقابل (43,6 %) أوافق احياناً، ورفض ذلك (29,7 %). نلاحظ أن استجابة أغلب أفراد العينة تتجه نحو أنهم غير متأكدين وبنسبة (43,6 %) من أن القائمين على الجامعة وخبراء التربية قادرين على التصدي لظاهرة الخدم على الأطفال، وتعزو الباحثة هذه النتيجة لعدم الطرح الكافي لهذه القضية من قبل القائمين على الجامعة والأخصائيين في هذا المجال، لذلك يجب على المعنيين أن يمنحوا هذه القضية جل اهتمامهم ؛ لارتباطها الوثيق بمستقبل الأمة من خلال الطفل.
جاءت العبارة رقم (31) مناهج الجامعة الحالية قادرة على التصدي لظاهرة خطر الخدم على الأطفال بكليات رياض الأطفال، في المرتبة (الثامنة) بمتوسط حسابي بلغ (1,85)، وبانحراف معياري بلغ (0,717)، وبنسبة (19,4 %) أوافق، مقابل (46,7 %) أوافق أحياناً، ورفض ذلك (33,9 %). نلاحظ أن أكبر استجابة رفض من قبل أفراد العينة في هذا المحور تمثلت في هذا العنصر حيث بلغت (33,9 %) يرون أن مناهج الجامعة الحالية غير قادرة على التصدي لظاهرة خطر الخدم على الأطفال، وتعزو الباحثة هذه النتيجة لفصل الجامعة عن قضايا ومشكلات المجتمع في بعض جوانبها، لذلك لابد من تحسين أداء نظام التعليم الجامعي من خلال تطوير مناهج التعليم فيها ؛ حيث إن موقع الجامعة من المجتمع يظل مرهوناً بقدرتها على تطوير نفسها وتطوير أعضاء هيئة التدريس فيها وبالتالي تطوير لطبيعة الأدوار المتوقع منهم ممارستها، فالتطوير ضمان للاستمرارية والبقاء ويتضمن هذا التطوير المراجعة الدائمة لأصول سياستها وخططها وبرامجها. كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (عبد القادر، 1995م) والتي بينت أن مناهج التربية والتعليم تنقصها موضوعات حول أساليب التنشئة الأسرية السوية لدى الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية والثانوية في إطار إعدادهم للحياة الأسرية.
توصيات الدراسة:
- توصي الدراسة بأن تتعاون المؤسسات التربوية في توعية الوالدين بأهمية وخطورة مرحلة ما قبل المدرسة؛ لأنها مرحلة تكوينية للفرد يتم فيها نموه الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي، وتؤثر هذه المرحلة في حياة الشخص المستقبلية، وأن الاهتمام بتربية الطفل ورعايته في مرحلة الحضانة هي من مسئوليات الأم، فيجب أن تعي هذه المسئولية وتعطيها حقها من الحضانة والرعاية.
- كما توصي الدراسة بأن تتعاون المؤسسات التربوية وعلى رأسها وسائل الإعلام في توعية الأم أن تترك لطفلها الفرصة للاقتراب من شخص تثق به ؛ حتى يحدثه عن مشاعره ومشاكله إن كان لا يبوح لأمه عما بداخله، وبذلك نضمن أن الطفل لو تعرض لأذى أو اعتداء من قبل العمالة المنزلية أن يخبر بذلك من يثق به.
- وكذلك توصي الدراسة بأن تتعاون المؤسسات التربوية في تنبيه الأم للخلوة باستمرار مع طفلها ومناقشته بما يفكر به من خلال سؤاله عن وجهة نظره في موضوعات عامة أو خاصة ؛ حتى نعزز الثقة بنفسه فينطلق لسانه بالحديث، على أن يكون ذلك بعيداً عن أعين الخادمات أو المربيات، وإن كان خارج المنزل كان أفضل.
- أن تتعاون المؤسسات التربوية في توعية المرأة على التوفيق بين مطالب أسرتها وعملها وهو ما يساعدها على عدم ترك كل أدوارها للخادمة أو المربية والقيام بدورها كأم بصورة أفضل.
- أن تتعاون المؤسسات التربوية في إعداد برامج إرشادية للأمهات العاملات وغير العاملات ممن لديهن عمالة منزلية على كيفية معاملة الخادمة أو المربية بالإحسان والتسامح والصبر وتقديم الهدايا والمكافئات لضمان رضاهن عن العمل وكسب قلوبهن.
- أن تتعاون المؤسسات التربوية والجهات الحكومية في توحيد البيانات الإحصائية حول العمالة المنزلية بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر، باعتبارها أطر مرجعية للباحثين والباحثات في هذه الظاهرة ولكونها مشكلة اجتماعية تتطلب دراسات متعددة للإحاطة بها من جميع جوانبها وإيجاد الحلول والبدائل للحد والتقليل منها.
المراجع: –
- القرآن الكريم.
- أحمد، حاتم وآخرون، آثار العمالة المنزلية على النشء والأسرة، الرياض، دراسة منشورة مقدمة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 2008م.
- الأنصاري، عنبرة حسين، أثر الخادمات الأجنبيات في تربية الطفل بمدينتي مكة المكرمة وجدة من وجهة نظر الأمهات. مكة الكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة أم القري، 1988م.
- باحاراث، عدنان حسن. مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة. جدة، دار المجتمع، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لجامعة أم القري، 2005م.
- بازامول، محمد عمر سالم. أحكام الخدم في الشريعة الإسلامية. ط1، بيروت، شركة دار البشائر الإسلامية، 2007م.
- باشا، حسان شمسي. كيف تربي أبنائك في هذا الزمان. ط4، دمشق، دار القلم، 2005م.
- البنوي، نايف عودة. ” عمل المرأة وأثره على تنشئة أبنائها “. مجلة التربية، قطر، 123، 1997م.
- الجلال، عائشة عبد الرحمن سعيد. المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق علاجها. جده، دار المجتمع، 1991م.
- الدعيج، نايف مطلف. العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة وعلاقتها بالأمن. الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2001م.
- الزبيدي، محمد مرتضي. تاج العروس من جوهر القاموس. م 3، بيروت، مكتبة الحياة، 1983م.
- خليفة، إبراهيم. المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي. الرياض، صادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج، 1985م.
- الزوم، ابتسام. اتجاهات المرأة السعودية نحو العمل المنزلي والعوامل المؤثرة عليها. الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة للرئاسة العامة لتعليم البنات، 1995م.
- الشهراني، سعد محمد. العمالة الآسيوية وأثرها على انحراف الأحداث في المجتمع السعودي. الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لأكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 1997م.
- عبدالعال، وصال نجيب. التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الأسرة السعودية وعلاقتها بأنماط الاستهلاك في مدينة جدة. جدة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة الملك عبد العزيز، 1995م.
- العتيبي، نادر نهار متعب. “المخالفات العقدية لدى العمالة المنزلية وآثارها هلي الأسرة السعودية “. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة الملك سعود في عام 2010م. استرجع في 15/12/1431ه على الرابط: htpp: //www. facaltg. ksa. edu. sa/30026/pageg/aspx
- العساف، صالح محمد. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض، مكتبة العبيكان، 2003م.
- عسيرى، عبد الرحمن محمد. العمالة غير السعودية وآثارها الاجتماعية قي المملكة العربية السعودية. الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1983م.
- العيدان، نوره إبراهيم. ظاهرة الخدم في الأسرة السعودية. الرياض، دار الشواف، 1993م.
- فان دالين، ترجمه محمد نبيل الفوفل وآخرون. مناهج البحث في التربية وعلم النفس. ط 5، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1994م.
- 20. اليوسف، عبد الله عبد العزيز. المشكلات الأسرية في المجتمع السعودي وأساليب مواجهتها. الرياض، دار عالم الكتب، 2007م.
قيم البحث الأن
راجع البحث قبل التقييم
راجع البحث قبل التقييم




