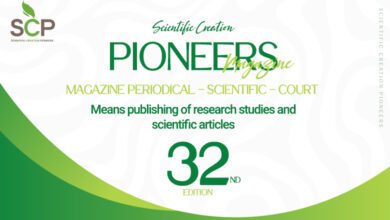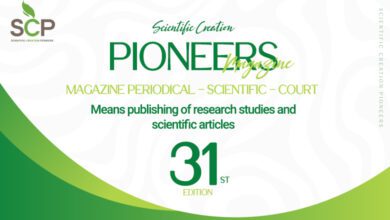تمكين المرأة وأثره على التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
Women's empowerment and its impact on sustainable development from the perspective of working women (managers and administrators) in public and private sector institutions in the Kingdom of Saudi Arabia.
المستخلص:
يهدف البحث إلى تعرف أثر تمكين المرأة على التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
واعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لموضوع الدراسة، حيث يهدف إلى وصف واقع الظاهرة المراد دراستها باستجواب مجتمع الدراسة أو شريحة منه تمثل عينة للدراسة عن طريق أداة الدراسة وهي الاستبانة والتحليل الكمي للمقابلة المفتوحة. واشتمل مجتمع الدراسة من جميع النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية، وتكوَّنت عينة الدراسة (56) من النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتمثلت أداة الدراسة في الاستبانة ومقابلة مفتوحة من تصميم (الباحثة).
وكانت من أبرز النتائج التي توصل اليها البحث الحالي هي: تواجد علاقة بين تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية، ومستوى تمكين المرأة في السعودية مرتفع بشكل عام، وفقًا لآراء النساء العاملات في القطاعين الحكومي والخاص، يُعتبر التمكين مرتفعًا بشكل عام، كما أن الوصول إلى المناصب القيادية لا يزال يمثل تحديًا، على الرغم من أن التأييد لوجود المرأة في هذه المناصب مرتفع، كما أن النساء العاملات يعتقدن أن لتمكين المرأة دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة. وتوصي الباحثة من خلال النتائج التي توصل إليها البحث بما يلي:
على مستوى المؤسسات: وضع أهداف واضحة لزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية، أما على مستوى المجتمع: أوصت الباحثة بضرورة إطلاق حملات توعية لتغيير الصورة النمطية عن المرأة، وتشجيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات (الرياضة، الفن، الثقافة)، وتسليط الضوء على قصص نجاح المرأة السعودية في مختلف المجالات.
الكلمات المفتاحية: تمكين المرأة، التنمية المستدامة.
Abstract:
The research aimed to identify the impact of women’s empowerment on sustainable development from the perspective of working women (managers and administrators) in public and private sector institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. The research relied on the use of the descriptive analytical approach for its suitability to the subject of the study, as it aims to describe the reality of the phenomenon to be studied by questioning the study community or a segment of it that represents a sample for the study through the study tool, which is the questionnaire and Quantitative analysis of open interview. The study community included all working women (managers and administrators) in public and private sector institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. The study sample consisted of (56) working women (managers and administrators) in public and private sector institutions in Riyadh, Saudi Arabia. The study tool was a questionnaire and Open interview designed by (the researcher). The most prominent results reached by the current research were: There is a relationship between women’s empowerment and achieving sustainable development in the Kingdom of Saudi Arabia from the point of view of working women (managers and administrators) in public and private sector institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. The level of women’s empowerment in Saudi Arabia is generally high. According to the opinions of women working in the public and private sectors, empowerment is generally considered high. The table indicates that reaching leadership positions remains a challenge, although support for women’s presence in these positions is high. Working women also believe that women’s empowerment plays an important role in achieving sustainable development. The researcher recommends, through the results of the research, the following: At the institutional level: setting clear goals to increase the percentage of women in leadership positions. At the community level: the researcher recommended the need to launch awareness campaigns to change the stereotype about women, encourage women’s participation in various fields (sports, art, culture), and highlight the success stories of Saudi women in various fields.
Key words: Women’s empowerment, sustainable development.
مقدمة:
تعد التنمية هي عملية مستمرة تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية. إنها رحلة نحو مستقبل أفضل، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق أقصى قدر من الرفاهية والعدالة والمساواة، حيث تعيش مجتمعاتنا اليوم في عالم متغير ومتسارع، تواجه تحديات كبيرة مثل التغير المناخي، والفقر، والهجرة، والتفاوتات الاجتماعية.
إن بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود وتعاون جميع أفراد المجتمع، حيث كل فرد في المجتمع يلعب دوراً هاماً في عملية التنمية، فالأفراد هم المحرك الرئيسي للتغيير، وهم القادرون على إحداث فرق إيجابي في حياتهم وحياة مجتمعاتهم، إن الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته هو الاستثمار الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
تؤدي المرأة دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية، فالمرأة هي صانعة القرار في الأسرة، وهي المسؤولة عن تربية الأجيال القادمة، وبالتالي فإن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع بأكمله، فالمرأة المتعلمة والصحية والقادرة على المشاركة في الحياة العامة تساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهاراً (بن النوى، 2019).
ويشكل الحديث عن تمكين المرأة نقطة تقاطع ما بين ثقافة العزل والتهميش والتمييز وبين ثقافة النوع والمشاركة، فالثقافة السائدة تحول المرأة إلى كائن محبط مهمش فاقد لأبسط حقوق الانسانية باسم الشرف تارة وباسم الحفاظ على قيم الاسرة تارة أخرى غير أن عملية تمكين المرأة تفتح لها نوافذ وعي جديد بذاتها، وتهيئ المجتمع لخلق تصورات جديدة عن أدوارها (السرور، 2022).
وقد تزايد الاهتمام العالمي بشكل ملحوظ بقضية المرأة وضرورة مشاركتها وإدماجها في عمليات المساواة، والتنمية، والسلام، منذ المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975 والثاني في كوبنهاجن 1980، والمؤتمر الثالث في نيروبي 1985، كما بدأ ذلك واضحاً في نتائج المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بكين 1995 حيث أكدت نتائج وتوصيات هذه اللقاءات على بعض المصطلحات أو المناهج التي تحمل مفاهيم تنموية هامة مثل منهج التمكين للمرأة والذي يهدف إلى تعزيز صورة المرأة عن نفسها، وثقتها بقدراتها الذاتية، وقيمتها في المنزل والمجتمع (علي، 2024).
وبالرغم من تلك المؤتمرات الدولية التي نادت بحقوق المرأة نجد حضوراً غير ملموس للمرأة في مجالات الحياة المختلفة وعلى رأسها المجال السياسي، وذلك بسبب العادات والتقاليد والميراث الفكري والثقافي السائد، أضف على ذلك أسباب وعوامل أخرى منها ارتفاع نسبة الأمية، وانخفاض وعي المرأة بدورها وحقوقها، فضلا عن الأعباء الثقيلة التي تقع على المرأة داخل المنزل وخارجه (العنزي، 2023).
وأكدت النتائج على حق المرأة في المشاركة الفعالة في الحوار والمناقشة، والتحليل للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المؤثرة في قدراتها ومكانتها إضافة إلى حقها في المشاركة في صنع القرارات الخاصة بها وبأسرتها، وحقها في التوعية والتدريب، لتصبح عاملاً فاعلاً في المجتمع بهدف تحقيق العدل والمساواة بمفهومها الشامل وعلى المستويات كافة (بن النوى، 2019).
ويعد اندماج المرأة في النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل يؤدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية ومنها الحصول على فرص التوظيف التي تؤمن لها مصدراً دائما للدخل، كذلك تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة على المستوى القومي مما يؤدي للوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، ورفع القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل في ظل اقتصاديات السوق والخصخصة والعولمة وتخفيض معدلات البطالة. كما تعتبر المشاركة الاقتصادية للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. إن مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي تدفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي، وذلك ان المرأة ليست كائناً يسعى لمجرد البقاء، وإن المشاريع التي تقوم بها المرأة سواء صغيرة أم متوسطة الحجم تساهم وبشكل إيجابي وفعال في تعزيز الاقتصاديات الوطنية (زيدان، 2020).
ومن هنا سعى البحث الحالي إلى تعرف أثر تمكين المرأة على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
مشكلة البحث:
على الرغم من تحقيق العديد من الدول لنمو اقتصادي ملحوظ، إلا أن هذا النمو لم يصاحبه دائماً تحسن في مستوى المعيشة لكافة أفراد المجتمع وحماية البيئة. فالتنمية الاقتصادية التقليدية غالباً ما ترتبط باستنزاف الموارد الطبيعية وتدهور البيئة، مما يهدد قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. لذا، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة التحول نحو نموذج تنمية مستدامة يضمن التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (النوى،2019).
وقد عقدت العديد من المؤتمرات مثل، قمة الأرض التي عقدت في ريو جانيرو سنه1992 التي تم بموجبها تحديد المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى قمة الأرض الثانية التي تم عقدها في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا تحت شعار القمة العالمية للتنمية المستدامة، وقبل تلك القمتين فقد وجدت جذور فكرية مهمة تتعلق بالتنمية المستدامة مثل تقرير نادي روما، المعنون ( حدود النمر) عام 1970 وجاء فيه أن الحدود البيئية للنمو الاقتصادي عامل هام في التنمية الاقتصادية، ثم أصدر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تقريرًا بعنوان الاستراتيجية العالمية للمحافظة على الطبيعة عام 1980، يُعتبر هذا التقرير رائدًا في مجال المقاربات الراهنة المتعلقة بترابط الاقتصاد مع البيئة، وقد ظهر توافق بين مفهوم المحافظة على الطبيعة وبين التنمية الاقتصادية ومنه انبثق مفهوم التنمية المستدامة(علي، 2024).
أما مؤتمر ستوكهولم المنعقد عام 1972 وهو مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية، فقد ظهر من خلاله مفهوم التنمية الملائمة للبيئة حيث يتم تصميم نموذج للتنمية يحترم البيئة ويولي عناية خاصة بالإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، ويجعل التنمية الاقتصادية مرافقة للعدالة الاجتماعية. وكان هذا المؤتمر أول انجاز في مجال وضع أسس النظام البيئي للعالم، والذي تلاه العديد من المؤتمرات التي تهدف إلى إحداث تغير جوهري في طبيعة ومسيرة التنمية في العالم لتصبح أكثر استدامة وعدالة، ويتسنى من خلالها لكل دولة التأثر والتأثير، عن طريق وضع صورة عن نظمها المؤسساتية في تحقيق استدامة التنمية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذلك الشأن إلى إقرار سياسات عامة تكاملية تشاركية تقوم على مقاربة عصرية في صنع القرار والتدبير الجيد للشأن العام عن طريق منهجية للعمل المتعدد الأطراف باعتماد مجموعة معايير لتحقيق التنمية المستدامة من قِبَل المشروعية والشفافية والاستدامة.(دسوقي، 2021)
وإضافة لما سبق، وجدت الباحثة ندرة في الدراسات التي تبحث في موضوع تمكين المرأة السعودية على وجه الخصوص، وربطها بالتنمية المستدامة في المجتمع السعودي، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تبني العديد من برامج التنمية المستدامة بالمجتمع السعودي وعلى كافة الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، مما يعد مبررا إضافيا لإجراء هذا البحث.
ويمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في التساؤلات التالية:
ما أثر تمكين المرأة على التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية؟
وتتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية:
- ما واقع تمكين المرأة، وفقا لمتغيري (المؤهل، الوظيفة) من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية؟
- ما دور تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية؟
- ما علاقة تمكين المرأة بتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية؟
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تعرف ما يلي:
- تعرف واقع تمكين المرأة، وفقا لمتغيري (المؤهل، الوظيفة) من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
- تحديد دور تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
- الكشف عن علاقة تمكين المرأة بتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
أهمية البحث:
الأهمية النظرية:
- يبرز أهمية البحث الحالي من تناوله موضوعاً ذا اهتمام محلي وعالمي، تعكسه الأدبيات الاجتماعية ذات العلاقة بمعوقات تمكين المرأة في المجتمع، فتمكين المرأة السعودية من الموضوعات التي ما زالت تخضع للبحث والمناقشة، من أجل أن تأخذ المرأة فرصتها وحقها في مجتمعها، لاسيما في ظل المتغيرات الحديثة التي تطرأ على البناء الاجتماعي للمجتمع السعودي وحرص المملكة على التنمية المستدامة.
- يسلط البحث الضوء على الدور المجتمعي الواسع الذي يلعب دوراً كبيرا إيجابا أو سلبا في تمكين المرأة في المجتمع السعودي.
- أيضاً أهمية البحث تنبع من تعديل النظرة التقليدية للمرأة، وأنها قادرة على تولى أدوار اجتماعية مهمة في المجتمع ومشاركتها في خطط التنمية المستدامة.
الأهمية التطبيقية:
- من المتوقع أن تفيد نتائج هذا البحث في التعرف على المعوقات الفعلية لتمكين المرأة السعودية وتقديمها إلى الجهات المعنية لتقديم الحلول المناسبة لها، ما قد يسهم في تغيير وضع المرأة السعودية نحو الأفضل داخل مجتمعها ومشاركتها في التنمية المستدامة.
- من الممكن تلفت نتائج هذ البحث الانتباه إلى ان التفضيل الذكوري في المجتمع السعودي مازال قائماً خاصة في التنمية المستدامة.
حدود البحث:
الحدود الموضوعية: يقتصر البحث الحالي على تناول موضوع تمكين المرأة، وأثره على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
الحدود البشرية: تتضمن الحدود البشرية على مجموعة من النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
الحدود المكانية: مؤسسات القطاع العام والخاص في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية: سيتم اجراء البحث الحالي خلال عام 1446ه/ 2025م.
مصطلحات البحث:
- تمكين المرأة:
أن تمكين المرأة يعني مساعدتها على التطور، وزرع الثقة بالنفس، والتخلص من معوقات الإنجاز، ومشاركتها الفعالة في المسئوليات، ويمكن النظر إلى مفهوم التمكين من زوايا عديدة منها ذو بعد مجتمعي يدعو إلى إفساح المجال للمرأة لكي تشارك في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم إعطائها القدرة على التحكم في كافة خياراتها وتشجيع التنمية وتحفظ النمو السكاني (العنزي، 2023).
كما يعرف تمكين المرأة بأنّه العملية التي تُشير إلى امتلاك المرأة للموارد وقدرتها على الاستفادة منها وإدارتها بهدف تحقيق مجموعة من الإنجازات (علي، 2024).
تعرف الباحثة تمكين المرأة اجرائيًا: بأنها المشاركة الفعالة للمرأة في كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل المجتمع السعودي.
- التنمية المستدامة:
هي التنمية التي تركز على الروابط المتداخلة للنمو الاقتصادي وتجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاندماج والاستدامة البيئية، وهي نهج معياري لوضع الأهداف المشتركة لتحقيق رقي المجتمع والتطلع لحياة كريمة إنها نظرية تحليلية وإطار معياري. (عبد الغني،2020).
ويقصد بالتنمية المستدامة تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، ولذلك تؤدي إلى تغيير حياة الإنسان وتحسين حقيقي فيها (عمار، 2020).
وتعرف الباحثة للتنمية المستدامة اجرائيا: هو مصطلح اقتصادي اجتماعي بيئييهتم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتطوير وسائل الإنتاج وإدارتها دون تبديد الموارد لنمو اقتصادي وتنمية اجتماعية مستدامة، وحماية مستدامة للبيئة ومصادر ثرواتها الطبيعية على المدى الطويل، اعتمادا على المرأة كونها أحد عناصر المجتمع السعودي، لاستغلال أمثل للموارد الطبيعية المتجددة لضمان عدم فنائها أو نقصها للأجيال القادمة مع تلبية احتياجات الأجيال الحالية.
الإطار النظري والدراسات السابقة
المحور الأول: تمكين المرأة:
مفهوم تمكين المرأة:
يُعرّف مفهوم تمكين المرأة بأنّه العملية التي تُتيح للمرأة القدرة على اتخاذ العديد من القرارات الاستراتيجية التي تُكسبها قوةً يمكن من خلالها السيطرة على حياتها. (الكعبي، 2020).
كما يُمكن تعريف تمكين المرأة بأنّه عبارة عن العملية التي تُشير إلى امتلاك المرأة للموارد وقدرتها على الاستفادة منها وإدارتها بهدف تحقيق مجموعة من الإنجازات (السرور، 2021).
وتعد عملية تمكين المرأة عملية مركبة، تعني بإيجاد الخبرات والإمكانات المادية والفنية التي لا توفرها التنشئة الاجتماعية للمرأة، إلى جانب خلق تصورات ذاتية للمرأة عن نفسها تنطوي على الثقة وشجاعة اتخاذ القرار والرأي الصائب، فضلاً عن تغيير النظرة التمييزية للمجتمع ضدها. والتمكين بهذا المعنى ليس تدريباً بل هو عملية اجتماعية، نفسية توفر للمرأة فرصة الإسهام في حياة المجتمع وتعزز أدوارها الايجابية سواء في البيت أو في العمل، أو في علاقتها مع الآخرين (يحيى، 2024).
وبناءً على هذا التعريف يتبيّن أهمية توافر ثلاثة عناصر مترابطة لتستطيع المرأة ممارسة اختياراتها الفردية؛ وهي تتمثل فيما يلي: الموارد، والإدارة، والإنجازات، ويُشير كلّ من تلك العناصر إلى معنى مختلف؛ فالموارد تُشير إلى التوقعات والمخصصات المادية، والاجتماعية، والبشرية، أمّا الإدارة فتُشير إلى قدرة المرأة أو على الأقل إحساسها بالقدرة على تحديد أهدافها الاستراتيجية التي تريد الوصول إليها في حياتها والتصرّف بناءً على تلك الأهداف واتخاذ القرارات بناءً على نتائج تلك الأهداف، أمّا الإنجازات فهي تُشير إلى مجموعة متنوعة من النتائج التي تبدأ من تحقيق مستوى عيش كريم وتحسينه إلى تحقيق مبدأ تمثيل المرأة سياسيّاً(قدري، 2022).
كما يتضح أن تمكين المرأة يعني مساعدتها على التطور وزرع الثقة بالنفس والتخلص من معوقات الانجاز ومشاركتها الفعالة في المسئوليات، ويمكن النظر إلى مفهوم التمكين من زوايا عديدة منها ذو بعد مجتمعي يدعو إلى إفساح المجال للمرأة لكي تشارك في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم إعطائها القدرة على التحكم في كافة خياراتها وتشجيع التنمية وتحفظ النمو السكاني (العنزي، 2023)
أبعاد تمكين المرأة:
قد يشكل تمكين المرأة مجموعة من الأبعاد ذات أبعاد نفسية ومجتمعية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومن أبرزها (علي، 2024):
- الأبعاد النفسية: حيث يعزز التمكين النفسي وعي الفرد، والإيمان بالكفاءة الذاتية، والوعي والمعرفة بالمشكلات والحلول وكيف يمكن للأفراد معالجة المشكلات التي تضر بنوعية حياتهم، يهدف هذا البعد إلى خلق الثقة بالنفس وإكساب النساء المهارات اللازمة لاكتساب المعرفة.
- الأبعاد المجتمعية: ويركز تمكين المجتمع على تعزيز المجتمع من خلال تطوير القيادة، وتحسين التواصل، وإنشاء شبكة دعم لتعبئة المجتمع لمعالجة المخاوف.
- الأبعاد التنظيمية: حيث يهدف التمكين التنظيمي إلى إنشاء قاعدة من الموارد للمجتمع، بما في ذلك المنظمات التطوعية والنقابات والجمعيات التي تهدف إلى حماية وتعزيز ومناصرة الضعفاء.
- الأبعاد الاقتصادية: يُعلِّم التمكين الاقتصادي للمرأة مهارات تنظيم المشاريع، وكيفية الحصول على ملكية أصولهن وكيفية تأمين الدخل لهن.
- الأبعاد الاجتماعية: يُعلّم التمكين الاجتماعي النساء مفاهيم الإدماج الاجتماعي ومحو الأمية وكذلك مساعدة النساء في العثور على الموارد ليكونوا مُستبِقات في مجتمعاتهم.
- الأبعاد الثقافية: ويهدف التمكين الثقافي إلى إعادة خلق الممارسات الثقافية وإعادة تعريف القواعد والمعايير الثقافية للمرأة.
العوامل التي تعوق تمكين المرأة (الكعبي، 2020):
1- العوامل الاجتماعية: حصر المجتمع بنظرته الضيقة، وبخلفياته الثقافية والاجتماعية التقليدية والعرفية دور المرأة العربية في البيت وفي بعض الأعمال الفنية، كما أنه لم يضمن لها الحرية الكافية للتخطيط لمستقبلها بشكل حيادي، أو المساحات الكافية للاختيار، ووفق ثقافة المجتمع العربي القائمة على “ثقافة العيب والحرام من جهة” وعلى اعتبار المرأة أماً وزوجة في المقام الأول، فقد تم تحديد دورها الأهم في أسرتها فقط، وتقليص دورها في التنمية سواء كانت الاجتماعية أو الإدارية أو الثقافية أو السياسية، كما توجد العديد من المعوقات والصعوبات ذات المضمون الاجتماعي، التي تعرقل انطلاق دور المرأة المساند والمكمل لدور الرجل في مجالات الحياة كافة.
وتشير العديد البيانات المستخلصة من الدراسات والإحصاءات التي قامت بها جامعة الدول العربية (إدارات الإحصاء وإدارة المرأة والأسرة) حول واقع المرأة العربية أن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية تؤثر في مشاركتها في النشاط الاقتصادي لمجتمعها وموضوعها على السلم الإداري والوظيفي، لذا فالفقر والأمية، والرغبة في تكوين أسرة في عمر مبكر، وتكوين أسرة كبيرة، وما يتبعها من ضرورة الاعتناء بها، والتفرغ التام لها، يجعلها بعيدا عن تمكينها إدارياً واجتماعياً، فالدور الأسري للمرأة قد يجبرها على اختيار الأعمال التي تتطلب وقتاً وجهداً أقل. ونتيجة للظروف التي تمر بها من حمل وولادة وتربية الأطفال، يجعلها غير قادرة على تحمل متطلبات الأعمال الإدارية وما تتطلبه من متابعة، وتنفيذ، وجهد وسفر، ومن اختلاط دائم وحيوي مع الموظفين، وما تفرضه طبيعة العمل من تداخلات وظيفية يومية اضافة الى ان الموروث الاجتماعي السلبي تنعكس أثاره على المرأة مما يمنعها من ممارسة دورها في بناء المجتمع والمشاركة في عملية التنمية التي لا تتم إلا بتكامل الأدوار بين كل من المرأة والرجل، وما زال هذا الموروث يترك أثراً يحتاج إلى عمل جاد لتصحيح المفاهيم المغلوطة لهذه المعتقدات والمورثات ومن ثم الحفاظ على ما هو أصلي منها وتنقيتها مما هو نتيجة تراكمات لا أساس لها من الصحة. (يحيى، 2024).
- العوامل الاقتصادية والسياسية: يكتسب دور الحكومات أهمية خاصة في إقرار السياسات المتعلقة بخصوص المرأة، والمشاركة بين الرجال والنساء، وإزالة العقبات القانونية التي تميَّز ضد المرأة، والحكومات إذا أرادت فهي التي تدفع بالمرأة إلى مراكز القيادات، إلا إن الحكومات ما زال دورها ضعيفا في إيصال المرأة إلى السلطة التشريعية، وللأحزاب السياسية أيضا دورًا هامًا، حيث تعتبر نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية متدنية جدًا، فالنساء عازفات عن الانتساب إلى الأحزاب السياسية، كما إن الأحزاب لا تتوجه للنساء، وتعد هيمنة الثقافة البطريركية (الأبوية) المتداخلة مع قيم الهيمنة والتفوق والإخضاع والتي حصرت دور المرأة في الوظيفة الاجتماعية والأسرية أدت وتؤدي دورًا بالغ السوء في قضية تمكين المرأة (أبو القاسم، داود، 2024).
فضلاً عما سبق يمكن الإشارة إلى ضعف فاعلية المنظمات النسائية، ويمكن إرجاع ذلك إلى ما يأتي (عبد اللطيف، 2022):
– قلة الموارد المالية، فالدعم الذي تلقاه هذه المنظمات قليل جداً، وهذا يستلزم بناء استراتيجية مستمرة لتوفير الدعم والتمويل الذاتي والوطني لهذه المنظمات.
– غياب استراتيجية تمكين شاملة، وضعف الوعي بأهمية التمكين ومفهومه الحقيقي لدى هذه المنظمات وأجهزتها التنفيذية والقدرة على التوجه إلى جميع الشرائح النسائية والقواعد الشعبية خصوصاً المرأة الريفية.
– ضعف عملية بناء قدرات المنظمات النسائية وتحويلها إلى مؤسسات فاعلة ذات قيادات مؤهلة ومدربة.
– الافتقار إلى التفاعل والتواصل وتبادل الخبرات مع الأطراف المختلفة ذات الخبرات والإمكانيات.
– وجود القوانين المقيدة لنشاط الجمعيات، فالتشريعات العربية تقيد بدرجات متفاوتة حرية تكوين الجمعيات وتخضعها عندما تنشأ لأشكال مختلفة من الإشراف والرقابة.
3- العوامل الشخصية: على الرغم من اتفاق الباحثين على أن هناك معوقات للمشاركة الفعالة للمرأة في أنشطة المجتمع المختلفة، وأن تلك المعوقات دائما ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ،إلا أن هناك معوقات شخصية لدى المرأة وتصوراتها حول قدراتها وأدوارها، وهو ما يحول دون أن تستفيد من الفرص المتاحة أمامها للمشاركة الرسمية واكتساب الأدوار والمكانات القيادية ليست فقط التطوعية ،وإنما الرسمية لأنه على الرغم من ما إتاحته القوانين والتشريعات من فرص المشاركة إلا أن المرأة لم تستفد منها على قدر توفرها، وهو يؤكد على فكرة التمكين والمساعدة الذاتية للحصول على تلك الفرص والمعوقات الشخصية هي تلك المرتبطة بالمرأة نفسها وتتضمن ضعف قدرة المرأة على تنظيم الوقت، والخوف من الفشل، وكذلك خوف النساء من تحمل المسئوليات الاجتماعية وعزوفهن عن القيام بمهام تتطلب الخروج من البيت والبقاء خارجه مدة طويلة وعدم الرغبة في الانضمام إلى المؤسسات الاجتماعية(السعدون، عطشان، 2022).
من الطرح السابق يتضح تنوع العوامل المؤثرة على عملية تمكين المرأة، فقد شملت هذه العوامل المتعلقة بالعادات والتقاليد والمورثات الاجتماعية، وعوامل اقتصادية وأخرى ذاتية تتعلق بالمرأة نفسها، كما أن أي قضية خاصة بالمرأة يجب النظر اليها بوصفها مشكلة اجتماعية، ناتجة عن خصائص اجتماعية خاصة بكل مجتمع (زيدان، 2020).
الدراسات السابقة المتعلقة بتمكين المرأة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تمكين المرأة على التوافق الزواجي، وقد تبنت الدراسة المنهج الوصفي الكمي باستخدام الاستبانة الإلكترونية على عينة عشوائية مؤلفة من 242 فردًا من النساء والرجال في المجتمع السعودي، شملت الدراسة أربعة أبعاد رئيسية تؤثر في التوافق الزواجي، وهي: قوانين الأحوال الشخصية، ونظام الولاية، وقانون حق المرأة، وقيادة المرأة للسيارة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إيمان المرأة بأهمية تمكينها في مختلف المجالات، ونسبة 24٪ من المشاركات في الدراسة وصفن أنفسهن بأنهن ربات منازل ولسن بحاجة للبحث عن عمل.
دراسة خالد (2023)
هدف هذا البحث إلى الوقوف على واقع تمكين المرأة ذات الإعاقة للوصول للمناصب القيادية، وأهم التحديات التي تحول دون ذلك، والعوامل المؤثرة عليها وكيفية مواجهتها، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي؛ كما اعتمد البحث على دليل المقابلة؛ كأداة أساسية لجمع البيانات، وطبق البحث على عينة عمدية؛ قوامها 20 مفردة من النساء العاملات ذوات الإعاقة. وقد كشفت نتائج البحث أن نسبة وظائف المرأة في القطاع العام (الحكومي) أعلى من القطاع الخاص؛ كما توصل البحث إلى أن غالبية العاملات؛ مجالهن محدد؛ وهو القطاع الإداري، وبينت النتائج أيضا وجود عرقلة في الإجراءات، وعدم إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات ذاتها، وإدراجها ضمن الخطط والاستراتيجيات على المستوى الحكومي، وعلى مستوى المجتمع المدني، وأخيرا كشفت النتائج عن عدم إدراك المسئولين للاحتياجات التدريبية والتطورية الملائمة للعاملات ذوات الإعاقة، وكذلك قلة الوعي بتهيئة بيئة ملائمة لتدريب الموظفات من ذوات الإعاقة.
دراسة الدبيخي (2023)
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر المرجعية الثقافية على مجالات تمكين المرأة في المجتمع السعودي. ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، واستخدمت بطاقة تحليل المحتوى أداة لجمع البيانات، وطبقت الدراسة على كتب وإعلاميات النخب الثقافية في المرحلة الثقافية السابقة والمرحلة المتغيرة الحالية اللتين مر بهما المجتمع السعودي وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: أن تحليل المحتوى لكتب النخب الثقافية ومقالاتهم الإعلامية أثبتت أن الثقافة وبما تحوي من عادات وتقاليد متعلقة في المفاهيم المرتبطة بعلاقة المرأة بالرجل، وطبيعة المرأة الأنثوية، وموقعها بالنسبة للرجل، كانت مؤثرة على: مجالات تمكينها في المجتمع، وقد اتضح أن أهم الموضوعات التي ناقشتها المرحلة الثقافية السابقة والتي أدت إلى ارتفاع مكانة المرأة السعودية بشكل كبير هي: (حق المرأة في تمكينها في مجال التعليم، وأيضا تمكينها في مجال العمل والتوظيف، إضافة إلى تمكينها في المجال القيادي)، في حين أن المرحلة المتغيرة التي عاصرها المجتمع السعودي كانت أقل تأثيرا في طرح هذه الموضوعات.
دراسة ياسين وغريب (2023)
هدف البحث إلى الكشف عن واقع تمكين المرأة في جامعة تشرين من وجهة نظر العاملات فيها، الكشف عن الفروق في آراء العاملات في جامعة تشرين حول واقع تمكين المرأة فيها تبعا لمتغيري (الكلية، والمؤهل العلمي)، اشتملت عينة البحث على (156) عاملة في جامعة تشرين للعام الدراسي 2022/2023 واستخدم المنهج الوصفي، ولتحقيق الغرض من البحث تم بناء استبانة مؤلفة من (44) عبارة تقيس واقع تمكين المرأة في الجامعة موزعة إلى خمسة مجالات هي (التمكين الاجتماعي، التمكين الإداري، التمكين الصحي والبيئي، التمكين التكنولوجي، التمكين النفسي). بينت نتائج البحث أن واقع تمكين المرأة في جامعة تشرين من وجهة العاملات جاء بدرجة متوسطة، وكذلك عدم وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث من العاملات في جامعة تشرين حول واقع تمكين المرأة فيها تبعا لمتغير الكلية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الإجازة الجامعية.
دراسة العنزي (2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على آثار تمكين المرأة على دورها في الأسرة السعودية، من خلال التعرف على مستوى التمكين (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الإداري) للمرأة، والتعرف على الأدوار الأسرية الحالية للمرأة المتزوجة بكلية الآداب بجامعة حائل في ظل التمكين، والآثار المترتبة على تمكين المرأة على أدوارها الأسرية، متبعة منهج المسح الاجتماعي، واستخدمت الدراسة أداة الاستبيان وتم تطبيقها على عينة بأسلوب الحصر الشامل تمثلت في عضوات هيئة التدريس والإداريات المتزوجات بجامعة حائل بلغ عدد أفرادها (102) مفردة، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تمكين المرأة المتزوجة مرتفع، وجاء التمكين الاجتماعي في الترتيب الأول، يليه التمكين الإداري، ثم التمكين الاقتصادي، وأخيرًا التمكين السياسي.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عملياً على واقع تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي، وكشف التحديات التي تحول دون تمكينها، واقتراح بعض الوسائل للتغلب على هذه التحديات، ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي القائم على الاستبانة كأداة للتحليل، واستخدم الباحث عينة عشوائية مصنفة من 376 عضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية السعودية التالية: الملك سعود بالرياض، والملك عبد العزيز بجدة، والإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، يشير التحليل إلى وجود تمكين للمرأة السعودية في المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي، وأن هناك اتفاقاً بين أفراد عينة الدراسة على التحديات التي تحول دون تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي، حيث تأتي التحديات الثقافية في المرتبة الأولى، تليها التحديات الشخصية، وأخيراً التحديات التنظيمية، وهناك اتفاق قوي على سبل التغلب على التحديات التي تحول دون تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي.
دراسة السرور (2021)
هدفت الدراسة إلى بيان مؤشرات التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة السعودية ضمن رؤية (2030)، وتم الاستعانة بمنهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي ويستفاد من المنهجين في هذه الدراسة في بيان مؤشرات التمكين الفعلي للمرأة السعودية سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي، وتضمن عينة البحث النساء فب المناصب الإدارية والقيادية بالمملكة العربية السعودية وقد بينت نتائج الدراسة زيادة نسبة المقاعد التي شغلتها المرأة السعودية في مجلس الشورى السعودي إلى نسبة (20%)، وفيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي فقد ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للإناث في المملكة من نسبة (69،2%) عام (2000) إلى نسبة (76،4%) عام (2004)، قد وصلت النسبة إلى (93،6%) عام 2013، ثم وصلت النسبة إلى (93،3%) عام (2019).
دراسة المليحان (2019)
هدف البحث إلى تعرف مدى تمكين المرأة في العمل الإداري في المجتمع السعودي. واعتمد البحث على منهج المسح الاجتماعي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في استبانة لجمع البيانات والمعلومات، وطبقت على عينة قوامها (131) مفردة من النساء العاملات في القطاعين الحكومي والخاص والمستشفيات والمؤسسات الخاصة في المجتمع السعودي. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في المحور الأول الخاص بواقع تمكين المرأة في العمل الإداري في المجتمع السعودي تبعًا لمتغير مستوى الدخل الشهري. وعدم وجود فروق دالة احصائيًا في المحور الثاني الخاص بالمعوقات التي تحول دون تمكين المرأة في العمل الإداري في المجتمع السعودي تبعًا لمتغير مستوى الدخل الشهري. وبهذا فإن أفراد عينة البحث بمختلف مستويات دخولهن الشهرية متفقات في استجاباتهن نحو محوري البحث الأمر الذي لم يستوجب وجود فروق إحصائية دالة بينهم.
دراسة (Shamlawi, H., & Saqfalhait,. (2019
هدفت هذه الدراسة إلى تقدير محددات التمكين التراكمي للمرأة في الدول العربية، ومدى اختلافها وفق مستويات الدخل، وذلك بالاستناد إلى تقارير الفجوة بين الجنسين العالمية خلال السنوات (2006-2015). واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، واستعانت الدراسة بأداة الاستبيان، وتوصلت الدراسة على عدة نتائج منها: عدم وجود فروقات تذكر يمكن أن تعزى للفروقات في الدخل في أثر معلمة التمكين الاقتصادي على التمكين الكلي للمرأة، أمّا بالنسبة إلى معلمة التمكين السياسي للمرأة، فقد كانت معنوية وإيجابية، وكان الأثر الأكبر للتمكين السياسي في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، في حين يقل أثر هذه المعلمة مع ارتفاع الدخل، أمّا معلمة التمكين الصحي للمرأة، فقد تبين عدم وجود دلالة إحصائية للتمكين الصحي للمرأة على التمكين التراكمي لها في جميع مجموعات الدول، في حين كان لهذه المعلمة أثر في مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض فقط بمستوى معنوية (10%).
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد الاطلاع على الدراسات السابقة المتعلقة بتمكين المرأة، يمكن تقديم التعقيب التالي من حيث أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين دراسة “أثر تمكين المرأة على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
أوجه الاتفاق
تتفق جميع الدراسات على أهمية تمكين المرأة ودوره في مختلف جوانب الحياة، سواء كانت أسرية، اجتماعية، اقتصادية، أو سياسية كدراسة المالكي (2024) و دراسة، Shamlawi, H., & Saqfalhait, (2019) .و
تركز معظم الدراسات على المرأة السعودية وتسعى إلى فهم واقع تمكينها والتحديات التي تواجهها، كدراسة الخل (2022)، ودراسة السرور (2021).
تستخدم العديد من الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، وهو منهج مناسب لتحليل البيانات واستخلاص النتائج حول الظواهر الاجتماعية والاقتصادية. وتشترك الدراسات في هدف عام هو فهم أبعاد تمكين المرأة وتسليط الضوء على أهميته في تحقيق التنمية المستدامة.
أوجه الاختلاف
تختلف الدراسات في تركيزها على جوانب معينة من تمكين المرأة، بعضها يركز على التمكين الاقتصادي، بينما يركز البعض الآخر على التمكين الاجتماعي أو السياسي أو الأسري كدراسة الخل (2022) ودراسة العنزي (2023).
تختلف الدراسات في استخدام الأدوات والأساليب المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها، بعضها يستخدم الاستبيانات، بينما يستخدم البعض الآخر المقابلات أو تحليل المحتوى.
تختلف الدراسات في حجم وطبيعة العينة التي تمثل المجتمع السعودي. بعضها يستهدف النساء العاملات في القطاعين الحكومي والخاص، بينما يستهدف البعض الآخر عينات أوسع من المجتمع.
تختلف الدراسات في النتائج التي توصلت إليها. بعضها يركز على الآثار الإيجابية لتمكين المرأة، بينما يركز البعض الآخر على التحديات والمعوقات التي تواجهها، كدراسة الخل (2022) ودراسة المالكي (2024)، ودراسة ( Shamlawi, H., & Saqfalhait, (2019.
تتميز الدراسة الحالية باستخدامها المنهج الكمي من خلال استخدام أداة الإستبانة والكيفي من خلال استخدام أداة المقابلة في تحليل البيانات وتفسيرها، كما تميزت الدراسة الحالية بتركيزها على النساء العاملات بالقطاع الخاص والحكومي بمؤسسات المملكة العربية السعودية وهذا ما لم تتناوله أي دراسة أخرى على حد علم الباحثة كما تميزت الدراسة باستهدافها لتمكين المرأة السعودية وبيان علاقة هذا التمكين بتحقيق التنمية المستدامة في المملكة مما يضفي أهمية كبيرة لهذا البحث وذلك لأنه قد يساهم في إضافة أراء النساء العاملات في موضوع تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل هذا التمكين.
المحور الثاني: التنمية المستدامة
١-١ الإطار المفاهيمي للتنمية المستدامة
التنمية المستدامة تحظى بأهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية منذ بداية مسيرتها التنموية، واتضحت معالمها في توجهاتها الاستراتيجية بعيدة المدى، وبدأ التطبيق العملي لهذا البعد في خطط التنمية الخمسية المتتالية التي انطلقت عام ١٩٧٠، حيث سعت تلك الخطط لتنمية قدرات المواطن وتحقيق طموحاته وتلبية احتياجاته، وتحسين مستوى معيشته كونه أسمى هدف للتنمية المستدامة بالمملكة، فضلاً عن الحرص على توسع نطاق التنمية المستدامة لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كافة المناطق، واستندت المملكة في تنفيذ استراتيجياتها التنموية الى المبادئ والقيم الإسلامية والحرية الاقتصادية، وبما يحقق شمول أبعاد التنمية الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية(عمار، 2020).
وقد أسهمت خطط التنمية المتعاقبة في تحقيق المملكة منجزات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واتسمت بالاستدامة والتوازن وينعكس ذلك على النمو المستمر لاقتصادها وبمعدلات مرتفعة، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية المتطورة والتحسن المتواصل في مستوى الخدمات العدلية والصحية والتعليمية والبيئية العامة للمواطنين (نصر الدين، 2023).
كما لوحظ في العقود الأخيرة بروز التنمية المستدامة كأحد أهم المفاهيم التي تسعى الدول إلي لتحقيقها لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بحيث لا يقتصر فقط على النمو الاقتصادي، بل يشمل أيضًا الأبعاد الاجتماعية والبيئية مما يحقق توازنّا مستدامًا وشاملًا، وذلك نظرًا للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، حيث تقوم التنمية المستدامة على التوازن المحكم، وللقطاع العام دور في دفع عجلة التنمية المستدامة؛ حيث يمتلك القدرة على تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المتوازن، من خلال تبني مبادئ الحوكمة الرشيدة، يمكن للقطاع العام تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوجيه التنمية نحو مسار أكثر استدامة(قادري، 2018).
١-٢ نشأة التنمية المستدامة
بدأ مفهوم التنمية في الظهور بصورة واضحة في الستينيات من القرن ال ٢٠ م، وقد مر بعدة عوامل كما يلي: بداية برز مفهوم التنمية في علم الاقتصاد بهدف استثمار الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائدها وهو يمثل التنمية الاقتصادية، ثم تطور واتسع المفهوم ليشمل الجانب البشري الذي يركز على قدرات الفرد ومستوى معيشته مما يمثل تنمية بشرية إلى جانب التنمية الاقتصادية، ومع تزايد الوعي لدى الدول والهيئات والمؤسسات والأفراد بقضايا البيئة والمجتمع ظهر مفهوم جديد وهو التنمية المستدامة. (فتحي، متولي، 2021).
وفي ظل التنافس العالمي بين الدول عن النهوض بكافة قطاعات الدولة تم اكتساب الميزة التنافسية للأسواق الدولية، والتمكّن للوقوف بقوة في ساحة الأعمال الدولية بشتى المجالات.
أضحى مفهوم التنمية المستدامة أساس التمكين الدولة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا، حيث تساعد الدول لتحقيق التنمية المستدامة الداخلية لنفسها بهدف الحفاظ على سيطرتها على مواردها. (رزوق، 2023)
١-٣ أهداف التنمية المستدامة
إن التنمية المستدامة عملية واعية معقدة طويلة الأمد شاملة ومتكاملة في أبعادها، لذلك فإن التنمية المستدامة وإن كانت غايتها الإنسان، إلا إنه يجب أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها، لهذا فإن هدفها يجب أن يكون إجراء تغييرات جوهرية في البنى التحتية والفوقية للمجتمع دون الإضرار بعناصر البيئة المحيطة.
هذا النموذج للتنمية يمكّن دور الأفراد من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن، وتوظيف تلك القدرات أفضل توظيف لها في جميع الميادين، من هنا نستنبط أن التنمية المستدامة ترتكز على جملة أهداف هي (بكيري، 2021):
– المحافظة على المصادر واستمرار تزويدها للأجيال القادمة عن طريق الاستخدام الفعّال للطاقة غير المتجددة والمصادر المعدنية من خلال الإنتاجية العالية وإعادة تشغيل وتطوير تقنيات بديلة غير مؤذية للبيئة مع المحافظة على التنوع البيولوجي.
– تحسين تطوير البيئة المبنية، فالمحافظة على المصادر الطبيعية والمصنّعة تحتاج لتقليل استهلاك الطاقة والمحافظة على إنتاجية الأرض وتشجيع إعادة استخدام المباني.
– تحسين نوعية البيئة؛ فالتنمية يجب أن تحترم البيئة بحيث تقلل من التلوث وتحمي النظام البيئي وصحة الإنسان.
– تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من سياسات التنمية التي تزيد حجم الفجوة بين الغني والفقير.
– تفعيل مبدأ المشاركة السياسية كلما زاد حجم المساواة زاد حجم التغييرات الأساسية في الاستهلاك ومواقع المصادر وأنواع الحياة كم أن الاستدامة البيئية لا يمكن تحقيقها دون التزام سياسي لإحداث التغيير من الأعلى والمشاركة من الأسفل.
ومن خلال الأهداف المقدمة، نستنتج أن التنمية المستدامة هي في الحقيقة تنطلق من ثلاث مبادئ رئيسة وهي (غضبان، 2021):
١- الفعالية الاقتصادية.
٢ – العدالة والإنصاف الاجتماعي.
٣- المحافظة على البيئة وحمايتها.
وتعد التنمية المستدامة هي تنمية موالية للناس وفرص العمل، فهدف نموذج التنمية المستدامة يقدّر الحياة البشرية في حد ذاتها، وهو يقدر الحياة لمجرد أن الناس يمكنهم إنتاج سلعة مادية ولا يقدّر حياة شخص ما أكثر من تقديره لحياة شخص آخر، إذًا لا ينبغي أن يكون مصير طفل حديث الولادة هو حياة قصيرة أو بائسة لمجرد أن هذا الطفل قدّر له أن يولد مثلا في المكان الخطأ، فالتنمية المستدامة هي تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس، وهي تحتاج إلى مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها.
وهي تعالج الإنصاف فيما بين الأجيال، أما فيما يخص المبدأ الثالث والذي ينطوي على علاقة الإنسان بالبيئة ،فلقد بدأت هذه العلاقة تسوء نظرًا لسوء استغلال الإنسان لعناصرها وتهديده المستمر لنظم البيئة ،وقد كان للتطور الصناعي دور كبير في ذلك منذ بداية الثورة الصناعية كما كان للزيادة السكانية الهائلة تأثير واضح على البيئة ساعد على تدهور العلاقة بين الإنسان وبيئته(عمار، 2020).
ولتحقيق هذه الأهداف لا بد أن توفر مجموعة من العناصر والتي تتمثل أساسًا في (علي 2024):
– ثبات أعداد السكان.
– أشكال جديدة من التكنولوجيا / نقل التكنولوجيا.
– الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية.
– الإدارة متكاملة النظم البيئية.
– تحسين اقتصاد السوق وتشجيعه.
– التعليم.
– الوعي وتغيير الاتجاهات (تغيير النموذج).
– التغيرات الاجتماعية والثقافية.
وإضافة إلى اهتمام التنمية المستدامة بالعلاقة المتبادلة ما بين الإنسان ومحيطه، وبين المجتمع وتنميته، فهي تهدف أيضًا إلى الاهتمام بشكل رئيس لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمشاريع التنموية. وأكثر من ذلك، أهمية التنمية المستدامة تعدّت إلى داخل المؤسسات، وخلق الميزة التنافسية؛ وذلك من خلال تخفيض التكاليف، وزيادة العوائد عن طريق إنتاج نفس المستوى من الإنتاج في ظل مدخلات أقل ومع بقاء العوامل الأخرى على حالها، سيكون لها أثر بيئي واقتصادي إيجابي، بعيد عن ذلك، للتنمية المستدامة أهمية قصوى تبدأ من تركيزها على الإنسان وحقوقه، إلى العناية بالبيئة، ومنع تدهورها كما تكتسب أهميتها وضرورتها من أنها تربط البيئة والاقتصاد والمجتمع في شكل حلقة متصلة تشكل أبعاد التنمية المستدامة (العنزي، 2023).
١-٤ أبعاد التنمية المستدامة
للتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد لا تنفك عن بعضها وهي (عمار، 2020):
اولاً – البعد الاقتصادي: ويقصد به استدامة الاقتصاد وترشيده، وتوسعة الأسواق لتوفير الأرباح وإفادة المجتمعات باستخدام رأس المال والممتلكات العينية لتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة، والهدف من مفهوم التنمية الاقتصادية، هو تطوير البنى الاقتصادية فضلا عن الإدارة الكفء للموارد الطبيعية والاجتماعية وبناء علاقات اقتصادية متينة وينطوي البعد الاقتصادي إجمالاً على العناصر التالية:
– خفض معدل استهلاك الفرد في الدول المتقدمة من الموارد الطبيعية، فسكان الدول الصناعية يستهلكون من الموارد الطبيعية في العالم أضعاف ما يستهلكه سكان الدول النامية.
– إيقاف تبديد الموارد الطبيعية، فالتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تعني ضرورة إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين الكفاءة وإحداث تغيير جذري في أسلوب الحياة وتغيير أنماط الاستهلاك.
– تحمل البلدان المتقدمة مسؤوليتها عن التلوث وعن معالجته، حيث تتحمل الدول الصناعية مسؤولية زيادة مشكلة تلوث العالم.
– المساواة في التوزيع والحد من التفاوت في الدخول، حيث إن المساواة في توزيع الموارد والحد من التفاوت في الدخول هو الوسيلة الناجحة للتخفيف من عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة في كل البلدان الغنية والفقيرة كما أنها تساهم في تنشيط عمليات التنمية والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وكذلك خفض الإنفاق العسكري.
ثانيًا: البعد الاجتماعي:
تتميز التنمية المستدامة بهذا البعد بشكل خاص، وهو يمثل الإنسان بالمعنى الضيق إذا يجعل النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي، وضرورة اختيار الإنصاف بين الأجيال، إذ يتوجب على الأجيال النظر إلى ضرورة عملية الإنصاف والعدل والقيام باختيارات النمو وفقًا لرغبتنا ورغبة الأجيال القادمة ،وفيما يلي أهم عناصر البعد الاجتماعي (حجازي، 2022):
– المساواة في التوزيع.
– التنوع الثقافي.
– استدامة المؤسسات.
ويمكن أن يحقق هذا البعد الوصول لأرقى مستوياته وذلك من خلال (محمد، 2023):
– الاستخدام الكامل للموارد البشرية والاهتمام بكل من الصحة والتعليم، حيث تنطوي التنمية المستدامة على استخدام الموارد البشرية استخدامًا كاملاً؛ وذلك بتحسين التعليم، والخدمات الصحية، ومحاربة الفقر، والجوع.
– تفعيل دور المرأة في المجتمع؛ أي العمل على إدماج المرأة في عملية التنمية المستدامة وخاصة في التخطيط للمشاريع وتنفيذها، وزيادة الوعي لدى المرأة في مجال المحافظة على الموارد وفي استغلالها.
– اتباع الأسلوب الاشتراكي؛ بمعنى ضرورة مشاركة أفراد المجتمع مشاركة تامة في صنع القرارات السياسية المتعلقة بحياتهم وتنفيذها.
– إعادة توجيه السكان والحد من معدلات الهجرة الداخلية، حيث تؤدي زيادة المناطق الحضارية إلى عواقب بيئية ضخمة في المدن تقوم بتركيز النفايات والموارد الملوثة؛ فتسبب في كثير من الأحيان مشاكل صحية لأفرادها، وتدمّر النظم الطبيعية المحيطة بها، ومن هنا تُعنى التنمية المستدامة بالتنمية الريفية للحد من كل هذا.
ثالثًا: البعد البيئي:
إن الترابط بين التنمية والبيئة هو ترابط عضوي وثيق الصلة على جميع المستويات، ومن المعروف أن التنمية والبيئة كانتا منذ القدم في حالة بدائية، والاقتصاد كان بسيطًا بدائيًا، ومع تقدم الإنسان، ومرور الزمن أصبح أكثر تعقيدًا؛ حيث زادت الموارد التي يستخدمها، وتنوعت أنشطته، وبشكل عام اتجه الاقتصاد من النمط البسيط إلى المركب وفقًا لتطور التنظيمات الاجتماعية التي تمثل النظم البشرية للتنمية والبيئة، والتفاعل فيما بينهما.
وهنا تحاول فلسفة التنمية المستدامة أن تحل هذه المعضلة، بالإصرار على أنه يتعين أن تأخذ القرارات التي تتخذها في جميع المستويات، وتأخذ في اعتبارها الآثار البيئية التي يمكن أن تنجم عن تلك القرارات، ومن شأن ذلك أن يقودنا إلى ممارسة النوع الصحيح من النمو الاقتصادي القائم على التنوع الحيوي وعلى التحكم في الأنشطة الضارة بالبيئة، وتجديد أو تعويض الموارد القابلة للتجديد، ونظرًا لأن البعد البيئي هو من الأبعاد الرئيسة للتنمية المستدامة، لأن النظم البيئية والمشاكل البيئية العالمية هي سبب ظهورها بل كانت سببًا رئيسيًا لذلك، ويمكن أن نعالج هذا البعد من خلال عدة نقاط. (فتحي، ومتولي، 2021):
– منع تجريف التربة وخفض استعمال المبيدات.
– حماية الموارد الطبيعية.
– ترشيد استهلاك المياه.
– حماية المناخ من ظاهرة الاحتباس الحراري.
استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها
أولاً – مفهوم استراتيجية التنمية المستدامة
يقصد باستراتيجية التنمية المستدامة أنها عملية منسقة وتشاركية متواصلة من الأفكار والأنشطة التي تُعتمد لتحقيق أهداف اقتصادية، وبيئية واجتماعية بطريقة متوازنة ومتكاملة على المستوى المحلي، وتتضمن هذه العملية تحليل الوضع الحالي وصوغ السياسات وخطط العمل وتنفيذها ورصدها واستعراضها بصورة منتظمة، كما تعد عملية دورية وتفاعلية من التخطيط والمشاركة يتم من خلال التركيز على إدارة التقدم تجاه تحقيق أهداف الإدارة المستدامة بدلا عن إعداد خطة كمنتج نهائي (عمار، 2020).
وتعرّف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة بأنها ” مجموعة منشقة من عمليات التحليل والنقاش وتعزيز القدرات والتخطيط والاستثمار، تقوم على المشاركة ولا تنفك تتحسن وتدمج بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع، من التماس مواضع للتنازلات المتبادلة حيثما يتعذر ذلك، ولا ينبغي في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة أن يؤخذ بنوع بذاته من النهج أو بصيغة واحدة، إذ لكل بلد أن يحدد لنفسه أفضل الطرق التي تناسبه لإعداد استراتيجية للتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للظروف السياسية والثقافية والأيكولوجية السائدة فيه، وعليه فإن اتباع نهج موحد للاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة غير ممكن، من المهم توخي الاتساق في تطبيق المبادئ التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجيات، والعمل على أن تكون الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متكاملة ومتوازنة، وتعد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أداة تستخدم لصنع القرارات على أساس مستنير، وهي توفر إطار للتفكير المنهجي في كل المجالات، كما تساعد على ترسيخ عمليات التشاور والتفاوض، والتوصل لتوافق في الآراء بخصوص القضايا الاجتماعية ذات الأولوية التي تتفاوت فيها المصالح، وتواجه استراتيجيات التنمية المستدامة مجموعة من التحديات أهمها: (بكيري، 2021).
– تقوية المؤسسات البيئية والمشاركة الشعبية: بحسب أن العمل البيئي هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فإن التقوية المؤسساتية على صعيد الأطراف الثلاثة من شأنها أن تحسن:
١- القدرات المالية والفنية المخصصة للعمل البيئي.
٢- زيادة الوعي بالأخطار والتهديدات البيئية، من أجل استنهاض العمل الشعبي، وزيادة استعداد المواطنين لدفع تكلفة الحفاظ على البيئة ومنع التلوث.
٣- تعزيز دور الأجهزة المسؤولة عن التحقق البيئي ومراقبة معايير الجودة البيئية ومتابعتها.
٤- الإدارة البيئية، أي تزايد الحديث في السنوات الأخيرة عن الأخطار والتهديدات البيئية التي تواجه مستقبل الجنس البشري واستمراره مثل قضايا ازدحام كوكب الأرض بالسكان وتلوث المياه العذبة، ومصايد الأسماك والأضرار بالأراضي، هذا ما أدى بالتنمية إلى الارتكاز على ضمان التناسق الاقتصادي والاجتماعي مع المنظومة البيئية وتحقيق الاستدامة، على ذلك يمكن تقسيم أشكال استراتيجيات الإدارة البيئية من أجل التنمية المستدامة إلى:(قادري، 2018):
١- المستوى الوطني، من منظور سكاني، إدارة الخطر، إدارة المناطق الريفية والزراعية، إدارة المناطق الصحراوية.
٢- من منظور زماني، مدى قصير، متوسط، طويل في إدارة الأخطار والكوارث.
٣- منظور مكاني ومنظور العناصر البيئية، عرضية ومائية وجوية، تنظيم الاحياء.
أما عن أسس الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فتتمثل في: (غضبان، 2021)
– خلق ثقافة للتنمية المستدامة، ينبغي أن تشكل الاستراتيجية للتنمية المستدامة نمطًا حياتيًا، والعمل على تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
– إضفاء الطابع المؤسسي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تتطلب عملية وضع هذه الاستراتيجية أن تكتسي تمامًا بالسمة المؤسسية، وينبغي ألا ينظر إليها بوصفها عملية مخصصة لهدف معين، أو أنها مهمة تنفّذ لمرة واحدة فقط، وينبغي أن تدمج الأنشطة اليومية للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.
– وضع آليات قانونية مناسبة وآلية للتنفيذ، تحكم القوانين واللوائح التنظيمية العلاقة بين المؤسسات، وكذلك العلاقة بين الناس وبيئاتهم، وبينهم وبين بعض، وإن تطبيق تشريعات وآليات مناسبة لإنفاذها يعد أمرًا ضروريًا بمواصلة عملية وضع الاستراتيجية.
– التنسيق الفعّال، لا بد من تنسيق الأفعال الاستراتيجية لكفالة نجاحها، وينبغي أن يشمل التنسيق ضمان إدماج عملية إعداد الاستراتيجية في العملية الحكومية لصنع القرار وإعادة الموازنة السنوية.
– الاتصال بالجمهور والمشاركة الفعّالة، يجب إقامة منتديات للمشاورة الدورية على المستوى الوطني والصعيد المحلي، ويجب أن تستخدم هذه المنتديات علاوة عن وسائط الإعلام للتوصل لتوافق في الآراء بخصوص الرؤية الشاملة للأهداف الإنمائية للبلد.
– تعبئة القدرة الوطنية على مواصلة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من المهم أن يجري بانتظام تحديد المهارات والقدرات الموجودة، والأمور التي تستلزم لمختلف الآليات والإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلال استخدام تلك الآليات، وينبغي بذل الجهد لتحقيق الأفضل من بين المهارات والقدرات الموجودة حاليًا، ويلزم بناء قدرات إضافية من خلال خيارات التدريب، كما يلزم تحديد الاحتياجات بالنحو المناسب.
ثانيًا: مؤشرات قياس التنمية المستدامة
تنقسم التنمية المستدامة عادة إلى ثلاث فئات رئيسة بناء على تعريف التنمية المستدامة (اقتصادية، اجتماعية، بيئية) ويتم استنباط هذه المؤشرات لتدل على وضع معظم القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تعالجها التنمية المستدامة، والتي تضمنتها الفصول الأربعون من وثيقة الأجندة ٢١ التي أُقرت في عام ١٩٩٢، وتمثل خطة عمل الحكومات والمنظمات الأهلية تجاه التنمية المستدامة في كل العالم. وهي تشمل الأسس التالية: (رزوق، 2023).
١- المؤشرات الاجتماعية، وهي تشمل ما يلي:
أ- المساواة الاجتماعية، وهي تمثل نوعية الحياة المشتركة العامة وهي انعكاس لمستويات تطبيق العدالة وشموليتها عند توزيع الموارد، وفي الحصول على فرص لكل فرد من الصحة والتعليم والعمل، وفي تحقيق العدالة الفرضية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتعتبر المساواة أحد أهم القضايا الاجتماعية في التنمية المستدامة، إذا تنعكس وترتبط المساواة مع درجة العدالة والشمولية في توزيع الموارد، وإتاحة الفرص واتخاذ القرارات وتتضمن فرص الحصول على العمل والخدمات العامة ومنها الصحة والتعليم والعدالة والمساواة يمكن أن تكون مجالات للمقارنة والتقييم داخل الدولة نفسها وكذلك بين الدول المختلفة، وقد تم اختيار مؤشرين رئيسين لقياس المساواة الاجتماعية وهما: الفقر ويقاس عن طريق نسبة السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر ونسبة السكان العاطلين عن العمل من السكان في سن العمل، ثاني مؤشر وهو المساواة في النوع الاجتماعي ويمكن قياسه من خلال حساب مقارنة معدلات أجر المرأة بمعدل أجر الرجل(الشيباني، 2022).
ب- الفقر البشري، وهو مؤشر مركب بثلاث أبعاد وهي حياة طويلة وصحية، توافر الوسائل الاقتصادية.
ت- نوعية الحياة، يستخدم هذا المؤشر لقياس عدد الأشخاص الذين لا يتوقع لهم أن يبلغوا سن ال 40 كنسبة مئوية من مجموع السكان والذين لا يتيسر لهم الانتفاع بالمياه المأمونة والخدمات الصحية ومرافق التنظيف الصحي.
ث- التعليم، ويقاس بنسبة الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم الابتدائي ومحو الأمية ويقاس بنسبة الكبار للمتعلمين في المجتمع.
ج- السكن، وتقاس حالة السكن في مؤشرات التنمية المستدامة عادة بمؤشر واحد نسبة مساحات السقوف في الأبنية لكل شخص.
ح- الصحة العامة، وتقاس من خلال أربعة مؤشرات رئيسة وهي:
– حالة التغذية وتقاس بالحالات الصحية للأطفال.
– الوفاة وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول للمرافق الصحية ونسبة التطعيم ضد الأمراض المعدية لدى الأطفال، ونسبة استخدام موانع الحمل.
خ- الأمن، ويقاس الأمن الاجتماعي عادة من خلال عدة جرائم مرتكبة لكل١٠٠ ألف شخص من سكان الدولة.
٢- المؤشرات البيئية:
وتضم المؤشرات المختلفة الخاصة بالنظام البيئي ونذكر منها (كيشار، 2021):
أ- الغلاف الجوي، ويضم انبعاثات الكربون وارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم وكذلك نسبة إنتاج غازات الكلور والفلور والكربون.
ب- الطاقة، وتخص إنتاج البترول، طاقة الرياح، الطاقة النووية وإنتاج الطاقة بالخلايا الشمسية والغاز الطبيعي، وكذلك كفاءة الطاقة والطاقة المولدة من حرارة الأرض.
ت- الغذاء، ويشمل إنتاج الحبوب ومخزوناتها، وصيد الأسماك واستعمال الأسمدة.
ث- الأراضي، وهنا يجب تحديد بشكل رئيس مدى التزام الدول بالتنمية المستدامة وتطبيقها لمبادئها، عن طريق معرفة طرق ووسائل استخدام الأراضي، ويضم هذا المؤشر قياس مساحة الأراضي المزروعة وكذلك الغابات في النظر للمساحات الغابات ومعدلات قطعها وأيضًا قياس نسبة الأراضي المتأثرة من التصحر.
ج- البحار والمحيطات، بما أن البحار تشغل ما نسبته ٧٠٪ من مساحة الكرة الأرضية فإن إدارة هذه المناطق الشاسعة بطريقة مستدامة بيئيا هو أكبر التحديات التي تواجه البشرية.
٣- المؤشرات الاقتصادية:
ويشمل هذا المؤشر عدة نقاط نذكر منها (الشيباني، 2022):
– نصيب الفرد من الناتج المحلي، وهذا يعبر عن الأداء الاقتصادي.
– حصة الاستثمار في الناتج القومي الإجمالي.
– ميزان، التجارة للسلع والخدمات والدين الناتج القومي الإجمالي.
– نصيب الفرد من استهلاك الطاقة سنويا.
– المسافة التي يقطعها الفرد حسب واسطة النقل يوميا.
– نسبة استهلاك موارد الطاقة المتجددة ومدى كثافة استخدام الطاقة.
– توليد النفايات الخطرة وإعادة تدوير استخدام النفايات.
وهناك يضيف المؤشرات المؤسسية والتي تضم استراتيجيات التنمية المستدامة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة وعدد أجهزة الراديو وكذا اشتراكات الإنترنت لكل ١٠٠٠ نسمة، وخطوط الهاتف الرئيسة، وعدد الهواتف النقالة لكل ١٠٠٠ نسمة. (نصر الدين، 2023).
الدراسات السابقة المتعلقة بالتنمية المستدامة:
دراسة العبد الكريم (2023)
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كفاءة الوسائط الرقمية في تحقيق التنمية البيئية المستدامة وفق مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط. وباستخدام أسلوب المسح التحليلي، وتم اجراء تحليل محتوى لعينة من تغريدات المؤسسات الحكومية، لوزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في الفترة من أوائل نوفمبر إلى أواخر ديسمبر 2022، وكشفت الدراسة أن الإبلاغ عن النتائج المقلدة جاء في مقدمة القضايا الرئيسية بشكل رئيسي فيما يتعلق بالتنمية البيئية والحفاظ عليها بنسبة 18.3٪، تليها اجتماعات المسؤولين بنسبة 16.7٪، ومن بين القضايا التي تناولتها تغريدات الوزارات السعودية، تصدرت زراعة الأشجار داخل وخارج المملكة العربية السعودية القائمة بنسبة 19.1٪، يليها تأهيل الأراضي المتدهورة، والحفاظ على البيئة بنسبة 12.4٪، أما بالنسبة لأهم أهداف المؤسسات العامة، فقد احتل إطلاع المواطنين على المشاريع التنموية المنفذة المرتبة الأولى بنسبة 60.8%، يليه إطلاع المواطنين على أنشطة الهيئات الحكومية بنسبة 57%.
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد اتجاهات المجتمع السعودي نحو تمكين المرأة السعودية في المجالات التنموية المختلفة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجهها المرأة السعودية وتمثل عوائق لها تجاه التمكين بمجالاته الذاتية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت أداة الاستبيان لجمع البيانات على عينة مكونة من ١٨٥ تم اختيارهم بطريقة صدفية. وقد أسفرت نتائج الدراسة على أن اتجاهات عينة البحث نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي جاء مرتفعة وكانت الاتجاهات الأقل في متوسطها بينهم تعزى للتمكين السياسي وبالنسبة لمحور التحديات التي تواجهها عينة البحث فقد احتلت التحديات الاجتماعية الترتيب الأول بمتوسط (2,81).
هدفت الدراسة إلى تعرف اثر تمكين المرأة السعودية في تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية و السياسية و القانونية واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم استخدام الاستبانة كأداةً لجمع البيانات وطبقت على عينة عشوائية من افراد المجتمع ذكور واناث فوق سن 25 سنة، والبالغ عددهم 107 مفردة، وكانت اهم النتائج أن جميع افراد عينة الدراسة ايدت أثر تمكين المرأة السعودية على دورها في المجتمع بصورة إيجابية في جميع المجالات، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وبنسبة 90%.
دراسة صقر وآخرون (2021)
تهدف الدراسة الحالية إلى الکشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى وعي المرأة السعودية عينة الدراسة بالأمن المجتمعي وبين واقع التمکين الاجتماعي والاقتصادي لها في ضوء التنمية المستدامة، تکونت عينة الدراسة من (200) سيدة سعودية من ريف وحضر محافظة الطائف تم اختيارهم بطريقة عشوائية، تکونت أدوات الدراسة من استمارة البيانات العامة واستبيان ومستوى وعي المرأة السعودية بالأمن المجتمعي، واستبيان واقع التمکين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة السعودية في ضوء التنمية المستدامة، واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،توصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط طردي دال إحصائياً بين مستوى وعي المرأة السعودية عينة الدراسة بالأمن المجتمعي وواقع التمکين الاجتماعي والتمکين الاقتصادي لها في ضوء التنمية المستدامة، وجود فروق دالة إحصائياً بين مستوى وعي المرأة السعودية عينة الدراسة بالأمن المجتمعي تبعاً لاختلاف متغيرات المستوى الاجتماعي الاقتصادي (عمل المرأة) و(نوع قطاع العمل)، وجود تباين دال إحصائياً بين مستوى وعي المرأة السعودية عينة الدراسة بالأمن المجتمعي تبعاً لاختلاف متغيرات المستوي الاجتماعي الاقتصادي (السن, عدد أفراد الأسرة, تعليم المرأة, الدخل الشهري).
دراسة الزامل (2020)
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى التخطيط للتنمية المستدامة في المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال المؤشرات الفرعية التالية: (تحديد أهداف- إعداد ووضع- تنفيذ- متابعة- تقويم) خطط للتنمية المستدامة في المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030، وقد استخدمت منهج المسح الاجتماعي الشامل وطبقت على أعضاء هيئة التدريس (الخبراء الأكاديميين في مجال التخطيط للتنمية المستدامة) بعينة من الجامعات السعودية (الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض- الأمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض- الملك سعود بالرياض- أم القرى بمكة المكرمة- الملك عبدالعزيز بجدة) وعددهم (57) عضو هيئة تدريس تخصص التخطيط الاجتماعي واعتمدت على استبيان لجمع البيانات وقد أكدت نتائج الدراسة تنمية وعي المخططين بأهداف رؤية المملكة 2030، دراسة المشكلات المستقبلية للتنمية المستدامة، والعمل على صياغة أهداف وخطط التنمية المستدامة وفق إستراتيجية واضحة ورؤى مستقبلية في إطار فلسفة التنمية المستدامة وبأسلوب علمي مخطط.
تعقيب على الدراسات السابقة
أوجه الاتفاق بين الدراسات
- تتفق جميع الدراسات على أن تمكين المرأة يلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية كدراسة اللعبون وآخرون (2023)، ودراسة صقر وآخرون (2021)، ودراسة أفغاني ومحمد (2023).
- تركز الدراسات على مفهوم التنمية المستدامة وأهميته في تحقيق التقدم والازدهار للمملكة.
- تستخدم معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، وهو منهج مناسب لتحليل البيانات واستخلاص النتائج حول الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، كدراسة اللعبون وآخرون (2023)، ودراسة أفغاني ومحمد (2023).
- تركز الدراسات على المرأة السعودية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى إلى فهم التحديات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة.
أوجه الاختلاف بين الدراسات
- تختلف الدراسات في تركيزها على جوانب معينة من تمكين المرأة والتنمية المستدامة، بعضها يركز على الجوانب الاقتصادية، بينما يركز البعض الآخر على الجوانب الاجتماعية أو السياسية أو البيئية.
- تختلف الدراسات في استخدام الأدوات والأساليب المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها. بعضها يستخدم الاستبيانات، بينما يستخدم البعض الآخر تحليل المحتوى أو المقابلات. كدراسة دراسة الزامل (2020)
- تختلف الدراسات في النتائج التي توصلت إليها. بعضها يركز على الآثار الإيجابية لتمكين المرأة على التنمية المستدامة، بينما يركز البعض الآخر على التحديات والمعوقات التي تواجهها المرأة كدراسة دراسة اللعبون وآخرون (2023) ودراسة صقر وآخرون (2021)، ودراسة أفغاني ومحمد (2023)
وتميزت الدراسة الحالية بتركيزها على تحقيق التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة وخاصة (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
مقدمة:
يتناول هذا الجزء إجراءات البحث الميداني التي قامت بها الباحثة والتي تعتبر المدخل لساحة البحث حيث يتم عن طريقها توفير البيانات والمعلومات التي يركز عليها الدارس في التناول الرئيس للدراسة هو تمكين المرأة وأثره على التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية، كما يتناول هذا الجزء من الدراسة وصفا لمنهج الدراسة، وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وأداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها، والأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة بيانات الدراسة.
أولاً: منهج الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لموضوع الدراسة، حيث يهدف إلى وصف واقع الظاهرة المراد دراستها باستجواب مجتمع الدراسة أو شريحة منه تمثل عينة للدراسة عن طريق أداة الدراسة وهي الاستبانة.
- مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
- عيِّنة الدراسة:
تتكوَّن عينة الدراسة (56) من النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ثانياً: أداة الدراسة:
تتمثل أداة الدراسة في الاستبانة من تصميم (الباحثة)، كما شملت مقابلة مفتوحة مع خمس موظفات من عينة البحث.
تصميم الاستبانة:
قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة (الاستبانة) مستعينة بالدراسات السابقة حول تمكين المرأة وأثرها على التنمية المستدامة، وقد اشتملت الاستبانة على (35) عبارة، وتكونت من قسمين كالتالي:
القسم الأول: واختص بالبيانات الأساسية الديموغرافية لأفراد الدراسة واقتصرت على العمر، المؤهل العلمي والوظيفة
القسم الثاني: ويشتمل على محورين رئيسيين وهما:
المحور الأول: واقع تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية.
المحور الثاني: دور تمكين المرأة في التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
قامت الباحثة من التحقق من صدق الاستبانة من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة تنتمي لكل محور من محاور الاستبانة والدرجة الكلية لهذا المحور الذي تنتمي إليه، وأيضا معامل الارتباط بين كل محور من محاور الاستبانة وإجمالي الاستبانة، وتم استخدام برنامج (SPSS). والجداول التالية:
جدول (1): يوضح معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الأول: واقع تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية.
| رقم العبارة | معامل الارتباط | مستوى الدلالة |
| 1 | 0.438 | دالة |
| 2 | 0.748 | دالة |
| 3 | 0.519 | دالة |
| 4 | 0.703 | دالة |
| 5 | 0.719 | دالة |
| 6 | 0.624 | دالة |
| 7 | 0.641 | دالة |
| 8 | 0.823 | دالة |
| 9 | 0.704 | دالة |
| 10 | 0.743 | دالة |
| 11 | 0.843 | دالة |
| 12 | 0.692 | دالة |
| 13 | 0.724 | دالة |
| 14 | 0.789 | دالة |
| 15 | 0.78 | دالة |
يتضح من الجدول السابق ارتباط بعض عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور ارتباطا دالاً عند مستوى (0.01)، مما يدل على الصدق الداخلي للمحور.
جدول (2): معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني: دور تمكين المرأة في التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
| رقم العبارة | معامل الارتباط | مستوى الدلالة |
| 1 | .914 | دالة |
| 2 | .869 | دالة |
| 3 | .642 | دالة |
| 4 | .689 | دالة |
| 5 | .849 | دالة |
| 6 | .838 | دالة |
| 7 | .847 | دالة |
| 8 | .844 | دالة |
| 9 | .801 | دالة |
| 10 | .697 | دالة |
| 11 | .853 | دالة |
| 12 | .664 | دالة |
| 13 | .810 | دالة |
| 14 | .780 | دالة |
| 15 | .751 | دالة |
يتضح من الجدول السابق ارتباط بعض عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور ارتباطا دالاً عند مستوى (0.01)، مما يدل على الصدق الداخلي للمحور.
ثبات أداة الدراسة
المقصود بـ ثبات الاستبانة أن تعطي النتائج نفسها تقريبا لو تكرر تطبيقها أكثر من مرة على نفس الأشخاص في ظروف مماثلة، وتم التحقق من ثبات المقياس في هذا الدراسة الحالية من خلال استخدام معادلة ألفا – كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية واستخدام معادلة جتمان، وكانت النتائج كالتالي.
1) حساب الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ للثبات:
وبتطبيق معادلة ألفا كرونباخ للثبات بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس (0.830)، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,01).
– التجزئة النصفية:
تم حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية، وذلك بتقسيم عبارات الاستبانة إلى جزئين (فردي وزوجي) ثم استخدمت معادلة سبيرمان – براون وقد بلغت قيمة معامل الثبات (0.780)، وهو دال إحصائيًا عن مستوى دلالة (0,01).
– معادلة جتمان:
تم حساب الثبات أيضًا باستخدام معادلة جتمان وبلغ معامل الثبات (0.720)، وهو دال إحصائيًا عن مستوى دلالة (0,01).
إجراءات تطبيق الدراسة:
قامت الباحثة بتطبيق أداة البحث على النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
المعالجة الإحصائية:
للإجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((spss حيث تم استخدام الأساليب الإحصائية الآتية: للإجابة عن السؤال الأول تم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والرتب وللإجابة عن السؤال الثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين الرباعي، واختبار شيفيه.
وقد اعتمدت الباحثة على معيار لتحديد درجة تقدير تمكين المرأة وفق المعادلة الآتية: طول الفئة – الحد الأعلى للبدائل – الحد الأدنى للبدائل /3= 5- 3/1 =1.33. وبذلك تصبح الفئات على النحو الآتي: درجة مرتفعة إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي (3.68-5)، ودرجة متوسطة إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي (2.34 -3.67)، ودرجة منخفضة إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي (1-2.33)
تصميم المقابلة
اتبعت الباحثة إجراءات منهجية لتصميم المقابلات وضمان صدقها وثباتها، بدأ البحث بتحديد أهداف المقابلة، والتي تمحورت حول استكشاف واقع تمكين المرأة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها والمقترحات لتعزيز التمكين، تم اختيار مقابلات شبه منظمة لضمان المرونة في الحوار مع الحفاظ على التركيز حول الموضوعات الرئيسية.
بعد ذلك، تم إعداد دليل مقابلة يتضمن أسئلة رئيسية وفرعية، مثل: “ما رأيك في واقع تمكين المرأة؟” و”كيف يمكن للمرأة أن تساهم في التنمية المستدامة؟”، مع اختبارها مسبقًا لضمان وضوحها وفعاليتها، لضمان صدق المقابلة، تم التأكد من أن الأسئلة تغطي جميع جوانب الموضوع من خلال مراجعة الخبراء، كما تم اختبار صدق الظاهري للتأكد من وضوح الأسئلة للمشاركات، لضمان الثبات، تم تدريب الباحثين على إجراء المقابلات بشكل موحد، واستخدام التحليل الموضوعي لاستخراج الموضوعات الرئيسية من البيانات، تم تسجيل المقابلات وتحويلها إلى نصوص مكتوبة لتحليلها بدقة، مع مراجعة النتائج مع خبراء لزيادة مصداقيتها.
تم توثيق جميع الإجراءات بدقة، بما في ذلك طريقة اختيار العينة والتحديات التي واجهت الباحث، هذه الإجراءات ساعدت في جمع بيانات دقيقة وموثوقة لتحقيق أهداف الدراسة.
إجابة السؤال الأول: ما واقع تمكين المرأة، وفقا لمتغيري (المؤهل، الوظيفة) من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية؟
جدول رقم (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لواقع تمكين المرأة، وفقا لمتغيري (المؤهل، الوظيفة) من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية
| الرتبة | رقم العبارة | العبارة | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | الدرجة |
| 1 | 1 | أعتقد أن المرأة السعودية تتمتع بفرص متساوية مع الرجل في الحصول على التعليم. | .49379 | 4.6038 | مرتفعة |
| 2 | 3 | أعتقد أن القوانين السعودية تحمي حقوق المرأة بشكل كاف. | .57588 | 4.5094 | مرتفعة |
| 3 | 11 | أرى أن المرأة السعودية تلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. | .72234 | 4.4528 | مرتفعة |
| 4 | 8 | أرى أن المرأة السعودية تلعب دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية. | .74265 | 4.3962 | مرتفعة |
| 5 | 7 | أعتقد أن المجتمع السعودي يتقبل فكرة قيادة المرأة للسيارة. | .52236 | 4.3585 | مرتفعة |
| 6 | 2 | أرى أن المجتمع السعودي يدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة. | .79867 | 4.3019 | مرتفعة |
| 7 | 14 | أعتقد أن المرأة السعودية قادرة على المساهمة في تطوير المجتمع بشكل إيجابي. | .84073 | 4.2830 | مرتفعة |
| 8 | 13 | أؤيد أن يكون هناك دعم أكبر للمرأة العاملة. | .73774 | 4.2642 | مرتفعة |
| 9 | 15 | أرى أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل. | .75716 | 4.2453 | مرتفعة |
| 10 | 4 | أؤيد مشاركة المرأة في صنع القرار على المستويات المختلفة. | .84116 | 4.1509 | مرتفعة |
| 11 | 9 | أعتقد أن المرأة السعودية تتمتع بحرية الاختيار في الزواج والطلاق. | .78539 | 4.1321 | مرتفعة |
| 12 | 6 | أرى أن التحديات التي تواجه المرأة السعودية في العمل أقل من ذي قبل. | .81842 | 4.0566 | مرتفعة |
| 13 | 12 | أعتقد أن تمكين المرأة يساهم في تقليل البطالة. | .79640 | 4.0189 | مرتفعة |
| 14 | 5 | أعتقد أن المرأة السعودية قادرة على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية وحياتها الأسرية. | .74655 | 3.9811 | مرتفعة |
| 15 | 10 | أؤيد وجود المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص والعام. | .75572 | 3.9245 | مرتفعة |
| المجموع | 0.72900 | 4.2453 | مرتفعة | ||
يبين الجدول (4) أن الدرجة الكلية لمحور واقع تمكين المرأة، وفقا لمتغيري (المؤهل، الوظيفة) من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية. جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي (4.2453)، وبانحراف معياري (0.72900)، وجاءت الفقرة (1) والتي تنص على ” أعتقد أن المرأة السعودية تتمتع بفرص متساوية مع الرجل في الحصول على التعليم.” بالرتبة الأولى وبمتوسط حسابي (4.6038) وانحراف معياري ( .49379) وبدرجة مرتفعة، وفي حين جاءت الفقرة (10) التي نصها ” أؤيد وجود المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص والعام.” بالرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.9245) وانحراف معياري (.84116) وبدرجة مرتفعة، وذلك يرجع إلى أن النساء العاملات في القطاعين الحكومي والخاص يعتقدن أن هناك تمكينًا للمرأة في مختلف الجوانب، يعكس التقدم الكبير الذي حققته المرأة السعودية في مجال التعليم، حيث أصبحت تشكل نسبة كبيرة من الخريجات في مختلف المراحل التعليمية، مما يشير إلى وجود بعض التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى المناصب القيادية، مثل التمييز والتحيز، والحاجة إلى مزيد من الدعم والتأهيل.
إجابة السؤال الثاني: ما دور تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية؟
جدول رقم (5) يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لدور تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
| الرتبة | رقم الفقرة | الفقرات | الانحراف المعياري | المتوسط الحسابي | الدرجة |
| 1 | 3 | أعتقد أن الاستثمار في تعليم المرأة يعود بالنفع على المجتمع ككل. | .57735 | 4.5000 | مرتفعة |
| 2 | 10 | أرى أن الاستثمار في صحة المرأة يساهم في تحسين صحة المجتمع بشكل عام. | .53919 | 4.4423 | مرتفعة |
| 3 | 7 | أعتقد أن مشاركة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في تنمية الاقتصاد. | .67267 | 4.3077 | مرتفعة |
| 4 | 14 | أؤيد أن تكون هناك برامج تدريبية خاصة بالمرأة لتمكينها من المشاركة في سوق العمل. | .72319 | 4.2885 | مرتفعة |
| 5 | 12 | أرى أن تمكين المرأة يساهم في تحسين صورة المملكة العربية السعودية عالمياً. | .73071 | 4.2308 | مرتفعة |
| 6 | 2 | أرى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة تساهم في تنويع مصادر الدخل. | .67272 | 4.2157 | مرتفعة |
| 7 | 5 | أعتقد أن تمكين المرأة يساهم في تقليل الفقر. | .77510 | 4.1961 | مرتفعة |
| 8 | 8 | أؤيد أن يكون هناك دعم أكبر للمرأة الريادية. | .68709 | 4.1923 | مرتفعة |
| 9 | 1 | أعتقد أن تمكين المرأة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. | .64841 | 4.1731 | مرتفعة |
| 10 | 6 | أرى أن المرأة السعودية تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على البيئة. | .71480 | 4.1346 | مرتفعة |
| 11 | 11 | أعتقد أن زيادة فرص عمل المرأة يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. | .74780 | 4.0962 | مرتفعة |
| 12 | 9 | أعتقد أن تمكين المرأة يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة. | .73688 | 4.0769 | مرتفعة |
| 13 | 13 | أعتقد أن مشاركة المرأة في صنع القرار تساهم في وضع سياسات تنموية أكثر شمولية. | .71295 | 4.0385 | مرتفعة |
| 14 | 4 | أؤيد أن يكون هناك تمثيل نسائي أكبر في مجلس الشورى. | .90478 | 3.7500 | مرتفعة |
| 15 | 15 | أعتقد أن تمكين المرأة يساهم في تقليل الهدر الاقتصادي. | .89134 | 3.9038 | مرتفعة |
| المجموع الكلي | 0.71567 | 4.1698 | مرتفعة | ||
يبين الجدول (5) أن الدرجة الكلية لمحور دور تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي (4.1698)، وبانحراف معياري (0.71567)، وجاءت جميع فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (4.5000 – 3.9038)، وجاءت الفقرة (3) والتي تنص على ” أعتقد أن الاستثمار في تعليم المرأة يعود بالنفع على المجتمع ككل.” بالرتبة الأولى وبمتوسط حسابي (4.5000)، وانحراف معياري (.57735)، وبدرجة مرتفعة، وفي حين جاءت الفقرة (15)، التي نصها ” أعتقد أن تمكين المرأة يساهم في تقليل الهدر الاقتصادي ” بالرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.9038)، وانحراف معياري (0.71567)، وبدرجة مرتفعة، وذلك يرجع إلى أن النساء العاملات يعتقدن أن هناك حاجة إلى مزيد من تسليط الضوء على هذه النقطة وأهمية دور المرأة في تقليل الهدر الاقتصادي، مما يعكس الارتباط الوثيق بين تعليم المرأة والتنمية المستدامة، حيث أن تعليم المرأة يساهم في زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتحسين صحة الأسرة، وتقليل الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما يشير إلى أهمية دور المرأة في الاقتصاد، حيث أن تمكينها يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الهدر الاقتصادي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
إجابة السؤال الثالث والذي ينص على: ما علاقة تمكين المرأة بتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية؟
والجدول التالي يوضح معامل ارتباط تمكين المرأة مع تحقيق التنمية المستدامة.
جدول (12) معامل ارتباط محاور الدراسة.
| البيان | معامل ارتباط معامل ارتباط تمكين المرأة مع تحقيق التنمية المستدامة | الدلالة |
| معامل الارتباط | 0.859 | دالة |
في ضوء الجدول (12) يوضح أن معامل الارتباط بين متغيري البحث معامل ارتباط تمكين المرأة مع تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية بلغ (0.859)، وهي تعد درجة دالة من الناحية الإحصائية.
النتائج:
لقد توصلت نتائج البحث الحالي إلى أنه توجد علاقة بين تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر النساء العاملات (المديرات، والإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية. وقد اتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كل من دراسة صقر وآخرون (2021) ودراسة الزامل (2022)، ودراسة أفغاني ومحمد (2023)، ودراسة اللعبون وآخرون (2023).
نتائج التحليل الكمي للمقابلات
في هذا الفصل، يتم عرض نتائج المقابلات المفتوحة التي أُجريت مع خمس نساء عاملات (مديرات وإداريات) في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية تم اختيارهم من عينة الدراسة.
وقد هدفت هذه المقابلات إلى استكشاف آراء المشاركات حول تمكين المرأة وأثره على التنمية المستدامة، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة البحثية الرئيسية والفرعية، وتم تحليل البيانات النوعية باستخدام التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) لتحديد الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتمكين المرأة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد جاءت نتائج المقابلات على النحو التالي:
1. واقع تمكين المرأة وفقًا لمتغيري (المؤهل، الوظيفة (
أ. المؤهل العلمي:
المشاركة الأولى (مديرة في القطاع الحكومي): أكدت أن المؤهل العلمي يلعب دورًا كبيرًا في تمكين المرأة، حيث أن الحصول على درجة علمية متقدمة (ماجستير أو دكتوراة) ساعدها في الوصول إلى مناصب قيادية، وذكرت أن المؤهل العلمي يعزز ثقة المرأة بنفسها وقدرتها على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
المشاركة الثانية (إدارية في القطاع الخاص): أشارت إلى أن المؤهل العلمي ليس العامل الوحيد في التمكين، بل يجب أن يكون مصحوبًا بمهارات عملية وخبرة ميدانية، ولاحظت أن بعض النساء الحاصلات على مؤهلات علمية عالية يواجهن صعوبات في الترقية بسبب التحيز الجنسي.
ب. الوظيفة:
المشاركة الثالثة (مديرة في القطاع الخاص): ذكرت أن المناصب القيادية توفر فرصًا أكبر للمرأة للمساهمة في صنع القرار، ولكنها أشارت إلى أن الوصول إلى هذه المناصب لا يزال يمثل تحديًا، وأكدت أن النساء في المناصب الإدارية الوسطى يشعرن بتمكين أكبر مقارنة بالوظائف الدنيا.
المشاركة الرابعة (إدارية في القطاع الحكومي): أشارت إلى أن الوظائف في القطاع الحكومي توفر بيئة أكثر دعمًا للمرأة مقارنة بالقطاع الخاص، حيث توجد سياسات واضحة لدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
2. دور تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة:
أ. المساهمة الاقتصادية:
المشاركة الخامسة (مديرة في القطاع الخاص): أكدت أن تمكين المرأة يساهم في زيادة مشاركتها في سوق العمل، مما يعزز النمو الاقتصاد، وذكرت أن النساء العاملات يساهمن في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية.
المشاركة الأولى (مديرة في القطاع الحكومي): أشارت إلى أن تمكين المرأة يؤدي إلى استغلال أفضل للموارد البشرية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ب. المساهمة الاجتماعية:
المشاركة الثانية (إدارية في القطاع الخاص): أكدت أن تمكين المرأة يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في تقليل الفجوة بين الجنسين، وذكرت أن النساء العاملات يلعبن دورًا مهمًا في تربية الأجيال القادمة وتعزيز قيم المساواة.
المشاركة الثالثة (مديرة في القطاع الخاص): أشارت إلى أن تمكين المرأة يساهم في تحسين صورة المجتمع السعودي عالميًا، حيث يعكس التقدم الذي تشهده المملكة في مجال حقوق المرأة.
3. علاقة تمكين المرأة بتحقيق التنمية المستدامة:
أ. العلاقة بين التمكين والتنمية الاقتصادية:
المشاركة الرابعة (إدارية في القطاع الحكومي): أكدت أن تمكين المرأة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية، حيث أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وذكرت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
ب. العلاقة بين التمكين والتنمية الاجتماعية:
المشاركة الخامسة (مديرة في القطاع الخاص): أشارت إلى أن تمكين المرأة يعزز التنمية الاجتماعية من خلال تحسين مستوى التعليم والصحة في المجتمع، وأكدت أن النساء العاملات يلعبن دورًا مهمًا في تعزيز الثقافة والوعي المجتمعي.
ج. العلاقة بين التمكين والتنمية البيئية:
المشاركة الأولى (مديرة في القطاع الحكومي): ذكرت أن النساء العاملات في المناصب القيادية يلعبن دورًا مهمًا في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني سياسات صديقة للبيئة، وأكدت أن تمكين المرأة يساهم في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
4. التحديات التي تواجه تمكين المرأة:
أ. التحديات الثقافية:
المشاركة الثانية (إدارية في القطاع الخاص): أشارت إلى أن الثقافة المجتمعية لا تزال تمثل تحديًا أمام تمكين المرأة، حيث أن بعض التقاليد تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل، وذكرت أن الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع تحتاج إلى تغيير.
ب. التحديات التنظيمية:
المشاركة الثالثة (مديرة في القطاع الخاص): أكدت أن عدم وجود سياسات واضحة لدعم المرأة في بعض المؤسسات يمثل تحديًا كبيرًا، وذكرت أن النساء يواجهن صعوبات في التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
5. توصيات المشاركات لتعزيز تمكين المرأة:
أ. على مستوى المؤسسات:
المشاركة الرابعة (إدارية في القطاع الحكومي): أوصت بضرورة وضع سياسات واضحة لدعم المرأة في المناصب القيادية، وذكرت أهمية توفير برامج تدريبية لتطوير مهارات المرأة القيادية.
ب. على مستوى المجتمع:
المشاركة الخامسة (مديرة في القطاع الخاص): أكدت على أهمية تغيير الصورة النمطية عن المرأة من خلال حملات التوعية، وأوصت بتسليط الضوء على قصص نجاح المرأة السعودية في مختلف المجالات.
تفسير نتائج المقابلات
تظهر نتائج المقابلات أن تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنويع مصادر الدخل.
كما أن تمكين المرأة يعزز العدالة الاجتماعية من خلال تقليل الفجوة بين الجنسين ودعم قيم المساواة، مما ينعكس إيجابًا على تربية الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ذلك، تلعب النساء العاملات دورًا مهمًا في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني سياسات صديقة للبيئة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. ومع ذلك، تواجه المرأة تحديات ثقافية وتنظيمية، مثل الصورة النمطية السائدة وعدم وجود سياسات داعمة كافية في بعض المؤسسات.
لتجاوز هذه التحديات، تحتاج المرأة إلى مزيد من الدعم من خلال سياسات مؤسسية واضحة، وبرامج تدريبية لتطوير مهاراتها القيادية، بالإضافة إلى حملات توعية لتغيير الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع. باختصار، تمكين المرأة ليس فقط حقًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للمملكة العربية السعودية.
ملخص النتائج:
- مستوى تمكين المرأة في السعودية مرتفع بشكل عام، وفقًا لآراء النساء العاملات في القطاعين الحكومي والخاص.
- بينما يُعتبر التمكين مرتفعًا بشكل عام، يُشير الجدول إلى أن الوصول إلى المناصب القيادية لا يزال يمثل تحديًا، على الرغم من أن التأييد لوجود المرأة في هذه المناصب مرتفع.
- النساء العاملات يعتقدن أن لتمكين المرأة دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة.
- يُعتبر دور المرأة في تقليل الهدر الاقتصادي مهمًا، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من تسليط الضوء عليه.
- وجود ارتباط قوي وإيجابي بين تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في السعودية، حيث بلغ معامل الارتباط (0.936)، وهي درجة دالة إحصائيًا.
- وتشير النتائج إلى أن المرأة السعودية تتمتع بتمكين ملحوظ، خاصة في مجال التعليم، وأن هذا التمكين يلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وتسليط الضوء على أهمية دورها الاقتصادي.
التوصيات:
توصي الباحثة من خلال النتائج التي توصل إليها البحث بما يلي:
على مستوى المؤسسات:
- وضع أهداف واضحة لزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية.
- تطوير برامج تدريب وتأهيل خاصة بالمرأة للوصول إلى هذه المناصب.
- مراجعة سياسات التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص.
- تغيير الصورة النمطية السائدة عن المرأة في القيادة.
- توفير خيارات عمل مرنة (دوام جزئي، عمل عن بعد).
- توفير خدمات رعاية الأطفال في مقرات العمل.
- تشجيع ثقافة داعمة للأم العاملة.
- توفير فرص متساوية للتدريب والتطوير المهني.
- خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة.
- توفير برامج تدريب وإرشاد للمرأة الراغبة في تأسيس مشاريعها الخاصة.
- تسهيل الحصول على التمويل والدعم المالي للمشاريع النسائية.
- إنشاء شبكات لدعم رائدات الأعمال وتبادل الخبرات.
على مستوى المجتمع:
- إطلاق حملات توعية لتغيير الصورة النمطية عن المرأة.
- تشجيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات (الرياضة، الفن، الثقافة).
- تسليط الضوء على قصص نجاح المرأة السعودية في مختلف المجالات.
- توفير منح دراسية وبرامج دعم مالي للفتيات لمواصلة تعليمهن.
- توعية المجتمع بأهمية تمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة.
- تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف تمكين المرأة والتنمية المستدامة.
- وضع مؤشرات لقياس التقدم في تمكين المرأة والتنمية المستدامة.
المراجع:
- أبو القاسم، هناء عبد المعتمد عبد الله, & داود، هيام عبد المجيد السيد. (2024). معوقات تمكين المرأة من المشاركة في تحقيق برامج التنمية المستدامة: جامعة سبها أنموذجًا-دراسة ميدانية لآراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب. مجلة الاصالة, 3(9).
- أفغاني، أماني, محمد, سمحاء. (2023). تمكين المرأة السعودية والتنمية المستدامة: دراسة للاتجاهات والتحديات. المجلة العربية لعلم الاجتماع, 16(32) , 183-246.
- بكيري، موسى 2021))، دور الحوكمة البيئية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة على ضوء تجارب بعض الشركات والبلدان العربية، مجلة الحوكمة المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، (3) ,2، 179-163
- بن النوى، عائشة. (2019). تمكين المرأة الجزائرية. دراسات في علوم الانسان والمجتمع, 2(4) , 56-74.
- حجازي، السيد عبد المنعم على متولى. (2020). دور التعليم البيئى فى تحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة لمعهد الدراسات البيئية بجامعة العريش. مستقبل التربية العربية, 27(125 ج 2), 161-260.
- الخل، لينا سليمان. (2022). تستخدم النساء في الخلفيات الجامعية: السياق السعودي. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، العلوم الإنسانية والإدارية، 23(2).
- خالد، ريمان عيد محمود. (2023). تمكين المرأة ذات الإعاقة بالمراكز القيادية: دراسة حالة لبعض النساء العاملات من ذوات الإعاقة. مجلة كلية التربية في العلوم الإنسانية والأدبية، مج29, ع3 ، 307 – 384.
- دسوقى, رانيـا عبد الحميـد مبروك. (2021). مفهوم التنمية المستدامة. المجلة العربية للقياس والتقويم, 2(4) , 195-215.
- الدبيخي، بشرى محمد. (2023). دور المرجعية الثقافية في تمكين المرأة بالمجتمع السعودي: تحليل محتوى. دراسات في التعليم الجامعي، ع59 ، 197 – 237.
- رزوق، وسهام ميمونة، (2023)، العلاقة بين الحوكمة الإلكترونية والتنمية المستدامة – مدخل نظري، مجلة الاقتصاد الحديث والتنمية المستدامة, 6(1) , 100-116.
- الزامل، الجوهرة بنت عبد العزيز. (2020). تصور مقترح للتخطيط للتنمية المستدامة في المجتمع السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية, 4(9) , 201-237.
- زيدان، عذراء اسماعيل. (2020). دور التراث العربي والاسلامي في تمكين المرأة. مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، (56) , 405-416.
- زيدان، عذراء اسماعيل. (2020). دور التراث العربي والاسلامي في تمكين المرأة. مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، (56) , 405-416.
- السرور، عبير عقيل محمد. (2021). تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية 2030. مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، (73) , 252-268.
- السعدون، احمد ثامر خيون صبير , & عطشان، غزوان عدي. (2022). معوقات تمكين المرأة العراقية لممارسة الدور القيادي بالمؤسسات المجتمعية. lark, 14(5), 428-415.
- الشيباني، عدناظم كاظم جبار. (2022). وتشهد التنمية المسيحية في العراق تحديات وحلول. أوروك للعلوم الإنسانية، ١٥(٢).
- صقر، نورهان محمد، محمد حسنين، الهام عبد العزيز، شوقي شيحه، هناء احمد، … & منار مرسي. (2021). الأمن المجتمعي وعلاقته بواقع التمکين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة السعودية في ضوء التنمية المستدامة: دراسة وصفية جامعة الطائف نموذجاً. مجلة الفنون والعلوم التطبيقية, 8(1) , 183-204.
- العاجيب، أمنة طشحيل، و جواد، شوقي ناجي. (2017). أثر تمكين المرأة علي نمو الأعمال الريادية في الأردن (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة عمان العربية، عمان.
- عبد الغني، محمد فتحي. (2020). تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجه في مصر. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة, 50(2) , 401-468.
- العبد الكريم، صفية بنت إبراهيم. (2023). تأثير الإعلام الرقمي في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. مجلة الآداب, ١١(٢)، ٦٧٦-٧١٨.
- عبد اللطيف، إرواء فخري . (2022). معوقات تمكين المرأة ذات الإعاقة في الدول العربية (مصر، والأردن، والعراق أنموذجاً). قضايا سياسية, (70).
- علي، هنا. (2024). تمكين المرأة ورهانات التنمية المستدامة. المجلة العلمية البحثية, 1(1).
- علي، هنا. (2024). تمكين المرأة ورهانات التنمية المستدامة. المجلة العلمية البحثية, 1(1).
- عمار، حمدي (2020)، رؤية تربوية مقترحة لتفعيل حوكمة الجامعات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة- مصر2030، مستقبل التربية العربية، 27(125 ج 2) , 13-88.
- العنزي، مطلة خالد. (2023). آثار تمكين المرأة على دورها في الأسرة. مجلة الخدمة الاجتماعية, 78(1) , 135-175.
- العنزي، مطلة خالد. (2023). آثار تمكين المرأة على دورها في الأسرة. مجلة الخدمة الاجتماعية, 78(1) , 135-175.
- فتحي، رفعت، ومتولي، يوسف. (2021)، الدور الاقتصادي للوقف وإمكانية تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030، مجلة الإدارة والاقتصاد، (128)، 119-145.
- قادري، مليكة (2018)، دور الحوكمة البيئية في تفعيل التنمية المستدامة، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، 3(2) , 150-168.
- قدري، سامية. (2022). تمكين المرأة المصرية: قراءة سوسيوتاريخية. المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل, 2(4) , 27-38.
- قدري، سامية. (2022). تمكين المرأة المصرية: قراءة سوسيوتاريخية. المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل, 2(4) , 27-38.
- الكعبي، سهام مطشر. (2020). تمكين المرأة… الفرص والتحديات. مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، (56) , 53-66.
- كيشار، ياسمين صلاح عبد الرازق . (2021). دراسة ذكية لمؤشرات الاستدامة الاجتماعية کجزء من مؤشرات التنمية الاجتماعية في مصر. مجلة الإسكندرية للعلوم الزراعية, 66(5), 177-197.
- اللعبون، جميلة، محمد العصيمي، حسين العمري، لمى، & محمد المطيري. (2023). أثر تمكين المرأة السعودية في تحقيق التنمية المستدامة ودور الخدمة الاجتماعية في دعمها. مجلة کلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية, 31(2) , 293-316.
- ليلى غضبان، (2021) دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة الاقتصاد الصناعي 350 – 344.
- المالكي، صفية مبارك المالكي. (2024). تمكين المرأة والتوافق الزواجي في ظل رؤية 2030: دراسة وصفية حول تمكين المرأة والتوافق الزواجي في المملكة العربية السعودية بمنظور رؤية 2030. مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية, 8(2) , 50-73
- . المليحان، عبدالله محمد عبدالله. (2019). مدى تمكين المرأة في العمل الإداري في المجتمع السعودي. مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص ، 77 – 115.
- محمد, & عاطف حافظ سلامة. (2023). تکامل الوظيفة الدينية والإيواء السياحي والنقل في رؤية السعودية للتنمية المستدامة 2030م. مجلة المجمع العلمي المصري, 98(98), 185-226.
- نصرالدين، فيفيان. (2023)، الاقتصاد الريعي ومدى تأثيره على بعض مؤشرات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية (2000-2021)، مجلة جامعة سرت للعلوم الإنسانية، 13(2) , 15-01.
- يحيي، & سهام فوزي. (2024). تمكين المرأة المصرية بعد عام 2014. مجلة الثقافة والعلوم للدراسات الانسانية, 1(1) , 34-90.
- ياسين، أحلام عبدالهادي، و غريب، نور عدنان. (2023). واقع تمكين المرأة في جامعة تشرين من وجهة نظر العاملات فيها: دراسة ميدانية. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج45, ع5 ، 743 – 767.
- Shamlawi, H., & Saqfalhait, N. (2019).. Dirasat: Human and Social Sciences, 46(1). Retrieved from https://archives.ju.edu.jo/index.php/hum/article/view/103541