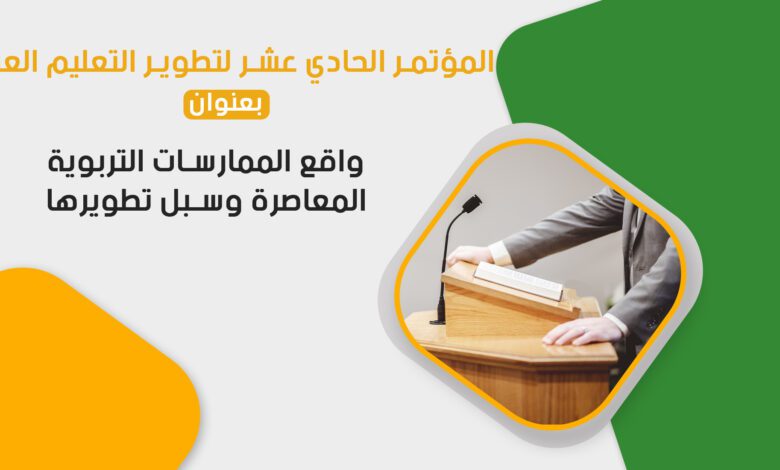
أنماط القيادة التربوية الإبداعية في دول الغرب ومدى اتفاقها مع القرآن الكريم والسنة النبوية
أنماط القيادة التربوية الإبداعية في دول الغرب ومدى اتفاقها مع القرآن الكريم والسنة النبوية
الباحثة/ عائشة محمد مبارك آل مبارك
مساعدة مدير مكتب وفاء بمنطقة عسير
المملكة العربية السعودية
مقال مقدم لمجلة SCP العالمية
إحدى مؤسسات مجموعة محمد القاضي العالمية
1440 ه/2019م
الملخص:
لقد حازت القيادة التربوية الإبداعية اهتمام العديد من الباحثين في دول الغرب ، وهي واحدة من الموضوعات الأكثر مناقشة على نطاق واسع في أغلب الدول الغربية من العالم ، هناك اتفاق بين التربويون والمختصون في شئون التربية والتعليم بأنه القيادة التربوية هي لبنة الأساس للعملية التعليمية فهي التي تحدد المعالم وتوجه وتنظم الجهود في سبيل تحسين المجال التربوي.
وقد تناولت الباحثة في هذه الدراسة تجارب الدول الغربية واهتمامها بالقيادة التربوية الإبداعية ، وكذلك أنماط القيادة التربوية الإبداعية ومدى اتفاقها مع القرآن الكريم والسنة النبوية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن معظم أنماط القيادة التربوية الإبداعية في دول الغرب تتفق مع القرآن الكريم والسنة النبوية ، كما تمثلت الشروط العامة للقيادة الإبداعية في القرآن الكريم والسنة النبوية بالقصدية ، والإبداع ، والتأمل الخلاق، والمصداقية، والاستيعاب، والقوة المادية والفكرية، وهذا ما أشارت إلية القيادة الابداعية في تجارب دول الغرب.
المقدمة:
الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس وكرم أهل هذا البلد بالبيت العتيق ، والصلاة والسلام على خير البرية المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد:
هناك اتفاق بين التربويون والمختصون في شئون التربية والتعليم بأنه القيادة التربوية هي لبنة الأساس للعملية التعليمية فهي التي تحدد المعالم وتوجه وتنظم الجهود في سبيل تحسين المجال التربوي والسمو والارتفاع به إلى أعلى المراتب لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة لذلك يجب أن تكون على درجة كبيرة من الإبداع والتميز.( A Multi-Context, 2015: 3)
ولقد تزايد الاهتمام بموضوع القيادة التربوية الإبداعية لكونها أصبحت أمراً ضرورياً وحيوياً في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها ظاهرة العولمة والتغيرات التقنية المتسارعة والمنافسة الشديدة وثورة المعلومات ، ولكي تضمن المنظمات التربوية نمو القدرات الإبداعية لإدارتها عليها أن تتبنى أنماطاً قيادة تدرك أهمية الإبداع و تشجعه وتوفر العوامل اللازمة لاستمراره ونموه، بحيث تعمل هذه القيادات على توجيه سلوك الأفراد نحو استكشاف الفرص وتوليد الأفكار الجديدة والتحقق منها بالأساليب العلمية وتحمل المخاطرة في سبيل دعمها وتطبيقها لكي يصبح الإبداع سلوكاً راسخاً يمارسه العاملون في المجال القيادي التربوي بشكل دائم.
ويتضح بأن حاجة الإدارة التربوية إلى القادة الأكفاء من ذوي العلم والابداع والابتكار لا تكاد تعادلها حاجة؛ حيث تعتبر من أولى أولويات العملية التربوية، لأنه ثبت بالتجربة أن إنتاجية الإدارة التربوية تتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بنوعية القيادة التي تتولاها، لذلك أصبح الإبداع يمثل أحد أهم العوامل الرئيسية الواجب توافرها لدف عجلة نجاح المجال التربوي. ومن هنا أصبحت القيادة الإبداعية من أهم العوامل التي تقود العالم الآخر وتؤدي بالمؤسسات والمنظمات إلى امتلاك ميزة تنافسية في مواجهة التحديات التربوية العظيمة التي فرزتها العولمة وعكسها الانفتاح على الغرب بكافة تفاصيل الحياة وشتى المجالات ومنه المجال التربوي. Moten, 2011: 2))
وتواجه القيادة التربوية في العالم الإسلامي جملة من التحديات، التي فرضت نفسها بحكم العديد من القضايا، أبرزها ظـاهرة العولمة، والتحدي التقني والمعلوماتية، بالإضافة إلى غياب فلسفة واضحة محددة، نابعة من تراث هذه الأمة، وأصالتها، وتاريخها، ولعل أخطر هذه التحديات، ما يسعى الغرب إلى فرضه على واقعنا القيادي في المنظمات التربوية ، من خلال عولمة نظامنا الإداري لهذه المنظمات، رغم ما يواجـه هذا النظام من أزمات، إلا أن هذا الأمر سيزيد من تعقيد أوضاعنا الإدارية والقيادية ، ولربما يقودنا إلى متاهة، نتخلى من خلالهـا عـن قيمنا، وتراثنا الحضاري، وثقافتنا، لا بل إلى تغيير فكرنا، بما يتيح للغرب السيطرة على مقدراتنا وخيرات بلادنا، بل وعلى عقولنا وتفكيرنا.
يقول الله تعالى في كتابه : ]هوَ الذِي بَعثَ فِي الْأُمِّيِينَ رسُولاً مِنهُمْ يَتلُو عَلَيهِمْ آيَاتهِ وَيزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُم الْكِتابَ وَالْحِكْمةَ وَإِنْ كَانوا مِنْ قَبلُ لَفِي ضلالٍ مُبينٍ[ [الجمعة:2] .
فقد أشارت الآية السابقة على أن البشرية كانت قبل البعثة بحاجة إلى منقذ ومخلص لها من الأنظمة التي جاهرت بظلمها ، وأعلنت إفلاسها ، ومن القوانين التي رسخت جذور الاستبداد، وحمت الجريمة ، واحتضنت كل محدث ، وأخرست كل محق ، وكتمت أنفاس الحق سنين طويلة .
وكانت النفوس بحاجة إلى قائد عادل ، ومرب جليل مشفق ، يغسل عنها أدران الرذيلة ، ويطهر الأرض ، ويزكي القلوب . كانت الدنيا تئن تحت وطأة أمراض عقدية ، وسياسية ، واجتماعية ، وإدارية ، وأخلاقية ، واقتصادية ، وكادت تختنق في قبضة الظلم والظالمين . فبعث الله إليها من أعاد الحق إلى نصابه ، وأرسى دعائم العدل ، و قرر حقوق الإنسان ، وأقام دولة عريضة ذاتَ نظام اسلامي قوي محكم متين .
وكان محمد e هو المنقذ لهم ، وهو الرحمة ، وهو السراج المنير ، لقوله تعالى : ]يَا أَيُّها النَّبِي إِنّا أَرْسَلْناكَ شَاهداً وَمُبَشراً وَنذيراً * وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً منِيراً[[الأحزاب:45-46].
أقام – عليه الصلاة والسلام – دولة الإسلام ، و بين لأمته كل أسباب بقاء هذه الدولة قوية ، عزيزة الجانب ، محفوظة الكرامة والمهابة والسمعة ، لا يتجرأ عليها ، ولا ينال من أهلها ، ولا يسلبُ حقوقها عدو أو حاسد .
وإن من أعظم ما شملته عناية المصطفى e في هذا المجال ، اختيار القائد الصالح المبدع المتحلي بسمات القائد الإداري المسلم.
انطلاقاً مما سبق ترى الباحثة بضرورة تناول موضوع أنماط القيادة التربوية الإبداعية في دول الغرب ومدى اتفاقها مع القرآن الكريم والسنة النبوية ، مع الحرص على ما امتازت به الشريعة الإسلامية في هذا المقام، وبيان تفوق وسمو نظرة الشريعة الإسلامية إلى القائد التربوي المبدع ، عن نظرة الأنظمة الأخرى.
ومن هنا فإننا مطالبون اليوم قبل الغد بإعادة تقويم واقع القيادة التربوية ، وأن نسترجع مرتكزات قيادية ابداعية ، كانت قد قادت أمتنا مـن الضلال إلى النور، وحققت رغم ضعف الإمكانات وشح الموارد انتصارات هائلة، لن نتمكن نحن حـتى اليـوم بكـل إمكانياتنا أن نحقق جزءاً يسيراً منها، إلا إذا عدنا إلى منطلقنا الإسلامي في قيادتنا التربوية ،عندها سـوف نـتمكن مـن مواجهـة التحديات بكل أبعادها ومجالاتها ، ولذلك فإننا معنيون في هذا الوقت بالذات أكثر مما مضى، إلى إعادة النظر في فلسفتنا لإدارة المنظمات التربوية ، بما ينسجم مع واقعنا الإسلامي، مرتكزين على القـرآن الكـريم، والسنة النبوية الشريفة، واجتهادات علماء الأمة، الذين أذهلوا العالم بإنجازاتهم في المجالات كافة، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتحدد أنماط القيادة التربوية الإبداعية في دول الغرب ومدى اتفاقها مع القرآن الكريم والسنة النبوية.
الطريقة المستخدمة:
تتناول الباحثة في هذا القسم تجارب الدول الغربية واهتمامها بالقيادة التربوية الإبداعية ، وكذلك أنماط القيادة التربوية الإبداعية ومدى اتفاقها مع القرآن الكريم والسنة النبوية.
تجارب الدول الغربية واهتمامها بالقيادة التربوية الإبداعية:
لقد حازت القيادة التربوية الإبداعية اهتمام العديد من الباحثين في دول الغرب ، وهي واحدة من الموضوعات الأكثر مناقشة على نطاق واسع في أغلب الدول الغربية من العالم (Kuchler,2008). حيث وصف جونغ وهارتوغ (2007) القيادة التربوية الإبداعية بأنها عملية للتأثير على المرؤوسين لتحقيق مجموعة الأهداف المرجوة ومنها الابتكار والتجديد والابداع، مما يساعد القادة على تشجيع وتحفيز ودعم وتعريف أتباعهم من أجل الحصول على نتائج مبدعة تنعكس على الأداء ككل. (Javed, 2017: 5 ).
ويتمتع مفهوم القيادة الإبداعية بتاريخ طويل ومفيد في العلوم التنظيمية. حيث نادىSelznick في كتابه “القيادة في الإدارة” عام (1984)، بأن السلوك الإداري العقلاني يعزز الكفاءة ويزيد من التفكير والابداع والبحث المستمر عن العديد من البدائل في ظل الظروف الصعبة، ولا يمكن تجديد أي منظمة كانت ومهما اختلف نشاطها إلا من خلال القيادة الإبداعية. ( A Multi-Context, 2015: 3)
وقد اهتمت دول الغرب بتحدي الصعوبات من أجل الإبقاء على قدرتها في السيطرة والتأثير في الأجيال التي تواجه العديد من التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة التغيير، وزيادة التعقيد، وتفاقم حالة الغموض وعدم اليقين، الناتج عن التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة، ويتوجب على المنظمات التربوية توسيع مدى مسئوليات القيادة التربوية لتشمل القيادة التربوية الإبداعية ، ويعد الإبداع التربوي من أهم مقومات المنظمات التربوية الناجحة والمتميزة في أدائها وإنجازها، والتي تسعى لإحداث نقلة نوعية وتغييرات جوهرية في أساليب أعملها الإدارية، ودعم الأفراد العاملين فيها وتشجيع السلوك الإبداعي لديهم، بحيث تصبح ذات كفاءة وفعالية أعلى ( Leithwood, 2004: 5)
وقد خاضت العديد من دول الغرب التجارب المختلفة في القيادة التربوية الإبداعية وكان البحث مستمراً على كيف للقائد أن يشرك مزيداً من الموظفين في عملية القيادة، وتدريبهم على كيف يصبحون قادة تربويين مبدعين ، حيث قام كل من ريتشارد هيوز وكاترين بيتي بافتتاح مركز (القيادة الإبداعية) للمديرين التنفيذيين كدليلاً إرشادياً لتطبيق عملية القيادة التربوية الإبداعية التي تهم القادة في كل مستويات المنظمة التعليمية. Moten, 2011: 2))
ويرى (Dimmock, 2010) بضرورة الاهتمام بالقيادة التربوية الابداعية لأنها عامل مهم في تحسين تعلم الأجيال، كما وأشار بضرورة التطرق إلى القيادة المدرسية (التربوية) الإبداعية لأن هذا يعد أمراً بالغ الأهمية لإعداد أجيال قادرة على حل المشكلات المعقدة والفوضوية المرتبطة بالعيش في عالم تنافسي عالمياً، وقد أشار إلى أن المدارس تعتبر المكان الأول لمواجهة التحديات المعاصرة التي تزداد يوماً بعد يوم .
وتعتبر فرنسا من الدول التي تطمح وتتطلع إلى الصدارة في كل شيء ولن يكون لها ذلك إلا من خلال التركيز على الإبداع والابتكار التربوي لغرض تحقيق الميزة التنافسية، وأولت الحكومة الفرنسية اهتماماً كبيراً بهذا المجال حيث ألقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كلمته الشهيرة في المؤتمر الأول للابتكار الأوروبي في 9 ديسمبر 2009 قال فيها: “نأمل بأن يكون عام 2009 هو عام الابتكار والابداع في أوروبا”. واقترح إنشاء الأكاديمية الأوروبية للعلوم والتكنولوجيا لكي تهتم بالتربية والإبداع والقيادة الإبداعية، وشدد على تعزيز الجهود المالية للدولة في مجال البحوث والمجال التربوي، ومن ثم مجال القيادة الإبداعية.( Sheila, 2007: 15)
أما عن التجارب اليونانية في تنمية مستوى القيادة التربوية الإبداعية ، فقد جاءت دراسة (Reppa & other , 2010) والتي تناولت تنمية مستوى الإبداع الإداري لدى مدراء ومديرات المدارس اليونانية وأثره على التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، وقد اتبعت هذه الدراسة منهج البحث النوعي القائم على إجراء مقابلات نوعية معمقة مع 6 مديرين (3 في اليونان، 4 في قبرص)، و 18 ولي أمر من (6 مدارس مختلفة بواقع 3 من المدرسة الواحدة). وتمحورت أسئلة المقابلات حول أثر مستوى المدير الإبداعي وممارساته على جودة التواصل بين المدرسة وولي الأمر ، ومن خلال تحليل بيانات الدراسة التي تم التوصل إليها أوضحت أن مستوى الإبداع الإداري لدى مدراء ومديرات المدارس هو العامل الأهم في تأسيس قنوات الاتصال بين المدرسة والأسرة، كما أوضحت النتائج أن الاتصال المباشر مع أولياء الأمور هو من أهم مظاهر الإبداع لدى مدير المدرسة، واطلاع ولي الأمر على المشكلات التي تعترض تعليم أولاده، مناقشة خطط المدرسة الحالية والمستقبلية وتقبل الأفكار والانتقادات من ولي الأمر.
وقد أجرت اثاناسولا وريبا وماكري وكاليبوي وفسكارس Athanasoula, Reppa, Marki, Kalliopi & Psycharis, 2010) دراسة في اليونان هدفت للتعرف على مستوى الإبداع التربوي لدى قادة المدارس وأثره على التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، حيث بينت الدراسة أن مستوى الإبداع التربوي لدى قائد المدرسة هو العامل الأهم في تأسيس الاتصال والتواصل مع المدرسين وأولياء الأمور، كما بينت الدراسة أن مظاهر الإبداع التربوي لدى القائد تتضمن الاتصال المباشر مع ولي الأمر، واطلاعه على كل ما يخص أولاده، كما انعكس الابداع التربوي على كيفية مناقشة خطط المدرسة الحالية والمستقبلية وتقبل الأفكار والانتقادات من ولي الأمر.
أما عن التجارب التركية في تنمية القيادة التربوية الإبداعية فقد قام كل من اوزمن ومورتجولو Ozmen and Muratoglu, 2010)) بدراسة في تركيا هدفت للتعرف إلى الكفايات الإبداعية لمديري المدارس خاصة في مجال تطبيق المعرفة واستراتيجيات الإدارة، وقد بينت الدراسة أن أهم الكفايات الإبداعية التي يجب أن يمتلكها المدير هي: إدارة المعرفة الفعالة، القدرة على تشكيل فريق العمل الفعال، ممارسة الاتصال الإداري، تشكيل شبكات الدعم الاجتماعي، وكفايات التنظيم والإدارة. وبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في التصورات حول طبيعة الكفايات الإبداعية التي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة.
أما عن التجارب بدولية كينيا في تنمية القيادة التربوية الإبداعية فقد تناولت (Ann & Peter, 2018) دراسة لتجارب ثلاث مديرات في مدارس ثانوية بدولة كينيا لاكتساب فهم أعمق لممارسة القيادة التربوية الإبداعية، وأكدت الدراسة بأن القادة التربويون يواجهون مشاكل مختلفة في الدول النامية بشكل فريد عن نظرائهم في البلدان الغربية، وأكدت النتائج بضرورة تطوير القيادة على أساس المعرفة والابداع، وأوصت الدراسة بمزيد من الابحاث على نطاق أوسع مع تنوع أكبر من المشاركين.
ويعتبر الأمريكيين هم أكثر الناس ميلاً إلى الابداع والابتكار، والإبداعات الجديدة خلال القرن الواحد والعشرين كانت جلها أمريكية، ولعل ذلك نتج عن تخصيص أمريكيا2.8% كأضخم ميزانية للبحث والتطوير من أكبر ناتج قومي إجمالي في العالم يزيد عن 2 تريليون، لقد كان الميل الأمريكي ولا تزال آثاره نحو الابداع في كافة المجالات وتمسكت أمريكا بالإبداع عند القادة لأنهم يؤثرون في الأفراد بشكل كبير، وركزت على القيادة التربوية الإبداعية في تلك البحوث حتى تستطيع الاستمرار على نفس القدرة الموجودة من خلال خلق أجيال إبداعية. (Malcolm, 2014: 146)
أما عن التجارب الأمريكية في تنمية القيادة التربوية الإبداعية فقد قام وفراي (Wfry, 2006) بدراسة للكشف عن العلاقة بين مستوى الإبداع التنظيمي لدى مدير المدرسة الأمريكية والتعلم الفعال، كما وتناولت الدراسة وصف المؤشرات الدالة على جودة الاتصال والحوار بين مدراء المدارس والأفراد خلال العمليات الإبداعية وتأثير ذلك على عملية التعلم، وقد طبقت الدراسة على (13) مشروعاً مدرسياً في (13) مدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد اعتمد الباحث على أسلوب المقابلة المعمقة، وقد قام بمقابلة (12-8) فرداً في كل مشروع منهم مدير مدرسة ، واستغرقت الدراسة ثمانية متغيرات رئيسية: دور القائد، وخصائص العملية، وطبيعة عملية صنع القرار، ومستوى المشاركة، ومعايير قياس الأداء، وتسلسل عملية التعلم، والتعلم على المنظمة، والأوضاع التنظيمية الملائمة لتطبيق نوع التعلم، وقد كشفت الدراسة أنه من خلال تطبيق الأساليب الإبداعية لا بد من اتباع نمط المحادثة ذو الجودة ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة عملية التعليم والتعلم في المدرسة ، كما يكمن دور القائد في تعليم وتدريب الأفراد على طرق الاتصال الصحيحة، ورفع مستوى المشاركة في عمليات صنع القرارات.
كما وجاءت دراسة سانجر وليفين (Sanger & Levin, 2005) بهدف الكشف عن طبيعة الإبداع الإداري الذي يمارسه مدراء ومديرات المدراس بأمريكيا ، وكذلك الكشف عن الآليات التي ينبثق منها الإبداع التنظيمي، وتمثلت عينة الدراسة من (26) مديراً أمريكيا حصلوا على جوائز الإبداع الإداري على مدار (20) عام من بداية أعمالهم ، وتم الحكم عليها من خلال استشارة الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في الشؤون الإدارية، وقد كشفت الدراسة أن الإبداع الإداري ينشأ عن التطور في المعرفة والخبرة وكيفية الاستفادة منها في إيجاد طرق جديدة ، كما تعتبر عملية تحليل السياسات المعمول بها في المدارس وتعديلها أكثر فعالية من تبني سياسات جاهزة من خارج المدرسة.
وقد قام (Javed,2017) بدراسة تأثير أساليب القيادة التربوية على السلوك الإبداعي، حيث تناول ترجمة لأساليب القيادة التربوية المختلفة، وأثرها على السلوك الإبداعي، وأشارت الدراسة إلى أن أسلوب القيادة التربوية يؤثر بشكل إيجابي على الإبداع مما يخلق قيادة إبداعية.
كما وأشارت دراسة (Jiajun,2016) إلى أن هناك اهتمام من قبل الباحثين حول العلاقة بين الإبداع والقيادة وكيفية مساهمة الإبداع في القيادة التربوية الفعالة، وكيف تساهم القيادة التربوية في الإبداع الجماعي والتربوي أيضاً، وأشار إلى أن معرفة هذا الترابط يصعب تحديده ويبقى مبهم ولكن بعد مراجعة الأدبيات المستندة إلى الأسس النظرية والأدلة التجريبية التي تكشف بوجود التقاطع بين الإبداع والقيادة وتعطي توضيحاً لفهم هذه العلاقة بأن القيادة تعطي نتائج إيجابية أكثر بالإبداع، وأن الابداع لدى القادة له نكهة أخرى تختلف عن أي مبدع آخر مما ينعكس على كافة مستويات العمل وكافة الموضوعات في كل مستوى من تلك المستويات.
وقد اهتمت دراسة نوريس (Norris & Etal, 2011) بتناول كيفية تحقيق الابداع للقيادات التعليمية المستقبلية من المسجلين في برنامج إعداد الإداريين ، وقد بينت هذه الدراسة ضرورة أن يكون المقرر الدراسي حافزاً ابداعياً للمشاركين ، وأن تكون البرامج الإبداعية من أولئك الذي يتصفون بالقدرة الحدسية ، والقدرة على نقل وتحويل المهارات الإبداعية إلى مواقع العمل.
كما إن الابداع في التجربة اليابانية جدير بالاهتمام والدراسة لما له من آثار كبيرة جعلت من اليابان دولة عظيمة وقوة اقتصادية كبيرة بعد أن كانت مدمرة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قامت في الفترة الماضية بالتركيز على القيادة لديها، على أفراد تقود المرحلة القادمة وجعلت منهم مبدعين فتمثلت لديها القيادة الإبداعية التي تسعى للتحسين المستمر بشكل أساسي لمواجهة كافة التحديات. ( Sheila, 2007: 17)
أنماط القيادة التربوية الإبداعية في دول الغرب ومدى اتفاقها مع القرآن الكريم والسنة النبوية:
يميل معظم الأشخاص نحو اعتماد أسلوباً معيناً واحداً كطريقة طبيعية في التعامل مع الآخرين، ولكن القادة التربويين لكي يكونوا مرتاحين ولقيامهم بعدة أدوار فإنهم يستخدمون العديد من الأساليب في نفس اللحظة، ولديهم المهارة والقدرة على استخدام عدة أساليب في ذات الوقت، يصبح بدقيقة واحدة ما بين ديكتاتورياً، ومن ثم مستمعاً للأسباب ومن ثم ديمقراطياً يتفهم الموقف ويضع الحلول. (Robert, 2015: 2)
ولكن في دول الغرب القادة بشكل عام ليسوا بمستوى واحد يناسب الجميع، فمنهم الديكتاتوري المتسلط ومنهم الديمقراطي ومنهم الملهم ومنهم الفظ تتحكم بهم المواقف والأحداث، ولكن القادة التربويون المبدعين يتمثل بهم الجزء الجميل من الشخصية الملهمة المشجعة ، فالقائد يهلم ويمد العظمة في الآخرين.( David, 2016: 2)
تتنوع في شخصية القائد التربوي المبدع في دول الغرب العديد من الأنماط والتي يطمح بأن يحقق من خلالها انعكاس على فريق العمل لكي يؤديه على أكمل وجه ، وتتمثل أنماط القيادة التربوية الإبداعية بستة أنماط كما يلي:
- القائد العمود:
ويكون الشعار الخاص به: الانضباط – وليس فقط العمل الشاق – يؤتي ثماره.
القائد العمود قوي وثابت، يقود بالقدوة الحسنة بدلاً من القوة، قد يكون واحداً من ألمع الناس في بيئة العمل ، لكن هذا ليس ما يجعله بارزاً ، كما أنه أكثر القادة انضباطاً، حيث أنه حتى الإبداع يتطلب بنية محددة مثل القوالب والجداول وجداول البيانات، يسعى هذا القائد دائماً بأن يكون قائداً إبداعياً لا ينسى، حيث يلهم من خلال التفاني. ( David, 2016: 3)
ويتفق هذا القائد مع ما جاء في القرآن والسنة النبوية ، حيث إن من أهم السمات القيادية التي عرفتها الإدارة الإبداعية الإسلامية في صدر الإسلام، القدوة الحسنة، والإخاء والبر والرحمة والإيثار، وكان الرسول e هو القائد والمشرع، وقد اجتمعت فيه كل الصفات القيادية فكان القدوة الحسنة ، لقول الله سبحانه وتعالى:] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [ (سورة الأحزاب ، الآية 21)
كما ويتفق انضباط القائد العمود في قيادته ما جاء في غزوة بدر ، حيث كان النبي ﷺ يعدل صفوف أصحابه وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار، وهو مستتل – متقدم- من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استو يا سواد، فقال: أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل، قال: فأقدني، فكشف رسول الله ﷺ عن بطنه، وقال: استقد، قال: فاعتنقه فقبَّل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمسَّ جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عيه وسلم بخير.
- القائد المُمَكن:
ويكون الشعار الخاص به: أنا أثق بك.
القائد الممكن يعطي الموظف الفرصة ويجعل العمل مبدعاً أكثر، هذه هي واحدة من أكثر أساليب القيادة تعاطفاً، والتي تسعى جاهدة إلى تفويض المهام على أساس نقاط القوة لدى الأفراد، والثقة بأنهم أفضل محترف إبداعي لهذا المنصب، حيث يلهم التمكين من خلال الثقة بخبرات الآخرين وتشجيع الاكتفاء الذاتي. (Robert, 2015: 2)
ويتفق هذا القائد مع ما جاء في السنة النبوية ، حيث أنه من أسرار العظمة والإبداع في القيادة التي تمتع بها رسول الله – ﷺ – معرفته بقدرات مرؤوسيه الدقيقة وثقته بهم ، فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال : ” أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أُبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينًا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح “
- القائد المنطقي.
ويكون الشعار الخاص به: افعل ما يعقل.
القائد المبدع المنطقي هو مفكر وببراعة لحل المشاكل الصعبة، يأتي هذا القائد الإبداعي إلى الطاولة مع حلول، وغالباً ما يتخذ القرارات التي تحافظ على كفاءة الفريق، وهو يرى بوضوح أقصر مسافة بين نقطتين، إنها قيادة بنزاهة، وتلهم الآخرين لإلقاء نظرة صادقة على أنفسهم وعملهم. (Robert, 2015: 3)
ويتفق هذا القائد مع ما جاء في السنة النبوية، حيث كان الرسول ﷺ يعرف مكامن التفوق لدى صحابته ويوظفها التوظيف الحسن كل حسب قدراته وطاقاته. وذلك كما حصل مع حسَّان بن ثابت: «اللهم أيّده بروح القدس»، وقال عمرو بن العاص «ما عدل بي رسول الله ﷺ وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابه في حربه منذ أسلمنا».
ولقد كان ﷺ قائداً مبدعاً، فها هو يهتم بإعداد قادة المستقبل، وهو أمر عادة لا يقوم به إلا القليل النادر من القادة إن لم نجزم بانعدام ذلك في أغلب الأوقات، فقد «أمّر – ﷺ – أبا بكر بالصلاة بالناس حين مرضه صلى الله على وسلم وأصر على ذلك» وكما «أمّره على موسم الحج في العام التاسع».
- القائد الحالم:
ويكون الشعار الخاص به: القوة والشجاعة وأنه لا شيء مستحيل.
من المحتمل أن يجذب القائد الحالم إلى قيادة بلا هوداة وبشجاعة كبيرة، قائد معتمد على الحدس والرغبة في تجاوز المعيار المقبول، القائد الحالم يرى ما لا يفعل الآخرون، هو زعيم تقوده الاحتمالات، وهو قائد مؤثر لا يمكن إنكاره، يلهم من خلال إظهار الآخرين ألا يستقروا أبداً ويحاسب من يقصر في عمله. ( David, 2016: 4).
ويتفق هذا القائد مع ما جاء في القرآن والسنة النبوية ، حيث إن القرآن الكريم أوضح ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وضرورة محاسبة من يقصر في عمله حتى تعم المصلحة العامة وتتحقق الأهداف، كما جاء في قوله تعالى :] وقفوهم إنهم مسئولون[ (الصافات ، الآية 24)
أما فيما يخص قوة هذا القائد يتفق مع قوله تعالى:] يا يحيى خذ الكتاب بقوة[ (مريم ، الآية 12) ، كما يتفق مع قوله تعالى:] إن خير من استأجرت القوي الأمين[ (القصص ، الآية 26)
وقد جاء في السنة النبوية قوله ﷺ لأبي ذر الغفاري ” يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة”. (رواه مسلم في صحيحه) فلم ينقص أبو ذر العلم ولا الأمانة ولا الجراءة في الحق.
- القائد المُتلهف.
ويكون الشعار الخاص به: سأفعل هذا مجاناً.
هذا القائد الإبداعي مكرس بشكل كبير لعمله ومشاريعه الجانبية الإبداعية فهو يعرف نفسه كفنان أو كاتب، لا يحتاج إلى مسوق أو معلن له، وهو يعمل دون مقابل ودون ثمن لذلك العمل، يكون سعيداً وهو يعمل مجاناً، ولديه قناعة افتراضياً ويلهم الآخرين من خلال حماسته اللامتناهية. ( David, 2016: 4)
ويتفق هذا القائد مع ما جاء في القرآن والسنة النبوية ، ولنتأمل موقف سليمان عليه السلام ورده القوي وثباته واصراره في دعوة ملكة سبأ للإسلام ورفضه هديتها ، وهذا ما يشير إلى طهارة القلب والعمل الخاص لوجه الله دون مقابل وعدم الالتفات لمغريات الدنيا مهما عظمت ، ويتضح هذا في قوله تعالى: ]قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ[ (سورة النمل، الآية 36(
أما في السنة النبوية فقد تمثلت القيادة في العديد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها القائد المتلهف حيث كان الجيل الصغير من صحابة رسول الله متلهفة على القيادة والمحاربة حيث تولى الصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنه القيادة وهو في الثامنة عشر من عمره، وذلك بأمرٍ من الرسول ﷺ ، إلا أن الرسول توفي قبل نفاذ أمره، فولّى أبو بكر الصديق أسامة بن زيد قائداً للجيش، وكانت المعركة التي قادها ضد الروم، إلا أنه رغم صغر سنه انتصر، وكان بعض الصحابة قد طلبوا من الرسول أن تكون القيادة لمن هو أكبر من أسامة في العمر، إلا أن الرسول قال لهم: “ما بال أقوام يقدحون في أن وليت أسامة على الجيش؟ وأيم الله أن كان للإمرة لخليق، وإنه لمن أحب الناس إلي، فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم”، وبعد ذلك الموقف أطلق على أسامة حِبُّ النبي عليه الصلاة والسلام.
- القائد الكامل .
ويكون الشعار الخاص به: الأفضل دائماً (الكمال) أو لا شيء.
هو قائد بلا هوادة فيها يسعى للكمال دائماً، في بعض الأحيان يُنظر إلى هذا الأسلوب القيادي على أنه جامد أو لا هوادة فيه، لن يقبل بالمستوى القليل أو حتى الكبير بل الكبير جداً بدرجة الكمال فهو يسعى دائماً إلى الكمال في العمل، هو المثالي الذي يلهم الآخرين على عدم تقديم مبرر أو الدفاع عن العمل لأنه لا يحتاج ذلك التبرير من درجة كماله. (Robert, 2015: 3)
ويتعارض هذا القائد مع ما جاء في القرآن الكريم ، فقد أشارت عدة آيات كريمة بأن الكمال لله وحده ، وأنه مهما اجتهد الانسان وعمل بحزم ونشاط لا يصل إلى درجة الكمال ، وهذا ما أشار اليه قوله تعالى ] فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [ (الروم، الآية 30) ، وقد جاء في قوله تعالى: ]أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ[ (الملك، الآية 14) ، وتدل الآية السابقة على الكمال المطلق لله عز وجل في صفة العلم.
وكذلك مما يدل على إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل عندما ذكر آلهة المشركين بين أن عبادتها باطلة، حيث إنها اتصفت بصفات النقص، والإله لا يمكن أن يكون ناقصاً، ومثال ذلك: يقول الله عز وجل في قصة محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه: ]يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا[ (مريم ، الآية 42) ، فقوله: ] يا أبت لم تعبد ما لا يسمع[ هذا نقص، ] ولا يبصر[ هذا نقص، ]ولا يغني عنك شيئاً[ هذا نقص ثالث، والله عز وجل قد بين أن الآلهة المعبودة من دونه باطلة؛ لأنها ناقصة، فهذا يدل على أنه هو الإله الحق، وأنه لا بد أن يكون كاملاً، ولهذا استدل عليهم أئمة السنة بمثل هذه الأدلة على إثبات الصفات، فمثلاً: يثبتون صفة السمع بقوله: ]يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ[ فالإله لابد أن يكون سميعاً، ويثبتون صفة البصر بقوله: ]ولا يبصر[، ويثبتون صفة الملك والأفعال لله عز وجل بقوله: ]وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا[.
النتائج:
من خلال تصفح الأدب في المجال القيادي التربوي في دول الغرب والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الخاصة بالقيادة بشكل عام والقيادة الإبداعية الفذة بشكل خاص تم التوصل إلى النتائج التالية:
- الرسول محمد ﷺ هو خير مثال على القائد التربوي المبدع.
- تتفق معظم أنماط القيادة التربوية الإبداعية في دول الغرب مع القرآن الكريم والسنة النبوية.
- تمثلت الشروط العامة للقيادة الإبداعية في القرآن الكريم والسنة النبوية بالقصدية ، والإبداع ، والتأمل الخلاق ، والمصداقية ، والاستيعاب ، والقوة المادية والفكرية ، وهذا ما أشارت إلية القيادة الابداعية في تجارب دول الغرب.
- لاشك أن الفكر القيادي التربوي في دول الغرب تأثر مثل غيرة من المجالات والقطاعات بثورة العلوم والتكنولوجيا ، وتأثر بكل ما جاء به عصر العولمة من متغيرات ومستجدات لم تكن معروفه من قبل على صعيد الأعمال والمنظمات.
- أشارت الدراسات والتجارب التي تناولت القيادة التربوية الابداعية في دول الغرب أن القائد التربوي الناجح الذي يسعى الى الارتقاء والوصول بمنظمته وأعماله إلى القمة يجب أن يكون قائداً ابداعياً ، ويحيط بكل مستجدات العصر ومتغيراته ويتابع تطور العلوم والمعارف والأفكار ويدرك الحديث منها ويتماشى معه ويواكب روح العصر بأفكاره ومعلوماته ولا يبقى حبيس الماضي والأفكار التقليدية لأنه سوف يتراجع ويبقى في ذيل القائمة ويجد أنه من الصعب عليه تحقيق أهدافه وغاياته ، وهذا يتفق مع القيادة الإسلامية التي أوضحتها السنة النبوية.
- أشارت السنة النبوية أن القائد التربوي الابداعي لابد أن تتوفر فيه صفات تبرز مدى كفاءته في تحقيق أهداف المنظمة التي يقودها ، وهذا ما يتفق مع ما أشارت الية التجارب التي قامت به الدول الغربية.
- اتساع دور المنظمات التربوية في دول الغرب وكبر حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها وتنـوع العلاقـات الداخلية وتشابكها وتأثرها بالبيئة الخارجية من مؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية لهـي أمور تستدعي مواصلة البحث والاستمرار في إحداث التغيير والتطوير، وهذا أوجب ضرورة توفر القيادة التربوية الابداعية الواعية من أجل مواكبة التطور ، وهذا ما يدعو اليه القرآن الكريم والسنة النبوية.
- صناعة القادة التربويين المبدعين في دول الغرب أمر ليس باليسر ، ويتطلب جهد كبير ممن يمثلون القيادة العليا في كافة المنظمات التربوية ، وهذا ما أشارت الية السنة النبوية والآيات القرآنية.
- القائد التربوي المبدع في دول الغرب تتوفر فيه خصائص ذاتية ” فطرية “: كالتفكير والتخطيط والإبداع والقدرة على التصور ، ومهارات إنسانية ” اجتماعية “: كالعلاقات والاتصال والتحفيز ، بالإضافة إلى مهارات فنية ” تخصصية “: كحل المشكلات واتخاذ القرارات ، وهذا ما أشارت الية السنة النبوية والآيات القرآنية ، فقد أوضحت السيرة النبوية سمات القائد المبدع التي يجب أن يتصف بها القيادين.
- هناك ملامح بارزة واضحة للقائد التربوي المبدع في دول الغرب تتمثل في سلوكياته وتعاملاته في تحقيق أهداف المنظمة التربوية التي يقودها ، كما أنه من صفات القائد التربوي المبدع في دول الغرب الحساسية للمشكلات والطلاقة في الكلمات وطلاقة التداعي وطلاقة الأفكار وطلاقة التعبير ، كما تتوفر فيه المرونة والأصالة والبصيرة ، وهذا ما يتفق مع القرآن الكريم والسنة النبوية.
- أوضحت السيرة النبوية لنبينا محمد ﷺ قيادته الابداعية في الغزوات التي قادها ، كما نلاحظ ذلك في المواقف الحياتية المختلفة لإدارته للشؤون الدولة الاسلامية التي بناها عليه الصلاة والسلام ، وبتركيزنا على الجانب القيادي الإبداعي في حياته ﷺ من خلال استعراض بعض المواقف من سيرته العطرة وأحداثها العظيمة ، في تلك البيئة المتغيرة والمتحولة من الظلمات إلى النور. وتلك المواقف تبين وتوضح عدداً من السمات والخصائص النبوية المتمثلة في شخصه عليه أفضل السلام.
التوصيات:
من خلال النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:
- توجيه المدراء والقياديين في المنظمات التربوية عامة نحو الاقتداء بالرسل الكرام عليهم السلام وفي مقدمتهم الرسـول المربـي محمد ﷺ وتشجيعهم على قراءة سيرهم العطرة بتأنٍ حتى يكتسبوا القيم والسمات التي تجعل منهم قادة تربويين مبدعين.
- العمل على تعزيز ورفع مستوى أداء القادة التربويين في كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة من خلال الحـاقهم بالـدورات التدريبية في مجال القيادة ولاسيما القيادة التربوية الإبداعية، على أن تأخذ هـذه الـدورات صفة الاستمرارية والمتابعة الجادة.
- أن يولي صانعو القرار في المنظمات التربوية المختلفة الابداع القيادي ما يستحق من أهمية عند اختيارهم لمن يشغل منصب قيادي، واعتماد معايير وآليات تضمن وصول أصحاب الكفاءات والمبدعين إلى هذه الوظيفة.
المراجع:
- A Multi-Context Conceptualization (2015). Creative Leadership :The Academy of Management Annals, 2015 Vol. 9, No. 1, 393–482, http://dx.doi.org/10.1080/19416520.2015.1024502
- Ann, E. & Peter, R. (2018). Educational Leadership in Post-Colonial Contexts: What Can We Learn from the Experiences of Three Female Principals in Kenyan Secondary Schools? Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Toronto, ON M5S 1V6, Canada
- Athanasoula, A., Reppa, A., Makri, E,. Kalliopi, B and Psycharis, S. (2010). School leadership innovations and creativity: The case of communication between school and parents. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (10): 2207–2211.
- David, P. (2016) . Six Leadership Styles for Creative Leaders, Helping creative entrepreneurs world-wide become even more successful, https://www.davidparrish.com/six_leadership_/
- Dimmock, C.;Walker, A.(2010). Developing comparative and international educational leadership and management: A cross-cultural model. School Leadersh. Manag, No. 30, 143–160.
- Javed A. (2017). Effect of Leadership Styles on Employees’ Innovative Behaviour: The Mediating Role of Employees’ Creativity www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.9, No.28, 2017
- Jiajun, G. (2016) Creativity and Leadership in Organizations: A Literature Review, CAEATLVIATY, vol. 3, Issue 1.
- Kuchler, J. C., Plucker, J. A., & Baer, J. (2008). Essentials of creativity assessment. Ho- boken, NJ: John Wiley & Sons Inc. European Journal of Business and Management
- Leithwood, K.; Louis, K.S.; Anderson, S.; Wahlstrom, K.(2004) How Leadership Influences Student Learning. Review of Research;Wallace Foundation: New York, NY, USA.
- Moten, A. R.(2011). Leadership in The West and The Islamic World: A Comparative Analysis, World pplied Science Journal , Vol. 15, No. (3).
- Malcolm, G. (2014), Spark of innovation, education broadcasting corporation new York.
- Norris Cynthia & Elat (2011) ” Developing Creative Leaders for
empowered schools”. National forum of educational administration & supervision journal volume 14 P.P (14-28). - Ozmen, F & Muratoglu, V. (2010).The competency levels of school principals in implementing knowledge management strategies the views of principals and teachers according to gender variable. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (20): 5370–5376
- Robert Half, (2015). Six Most Inspirational Leadership Styles ,https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/6-most-inspirational-leadership-styles , January 25, 2016 at 4:00pm
- Reppa, A., & other (2010). School leadership innovations and creativity: The case of communication between school and parents. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (10): 2207–2211.
- Sanger, T., & Levin, W.(2005). Increasing Employees creativity by training their managers. Industrial and commercial training, Vol. 33,No .2, p.p. 63-68.
- Sheila, M. (2007) Innovation : Oregon innovation index , Oregon economic and community Develepenents. institute for Portland state university. or 3/2/2008, P: 01
- Wfry, R. (2006). The Relationship between Principals innovative style And teachers perception of Principals Effectiveness, Dissertation Abstract International. 456 (07). P. 3100
قيم ورقة العمل الأن
راجع ورقة العمل قبل التقييم
راجع ورقة العمل قبل التقييم




