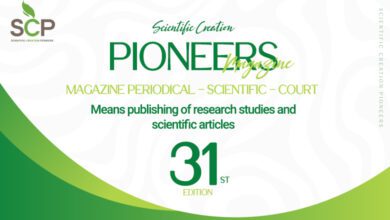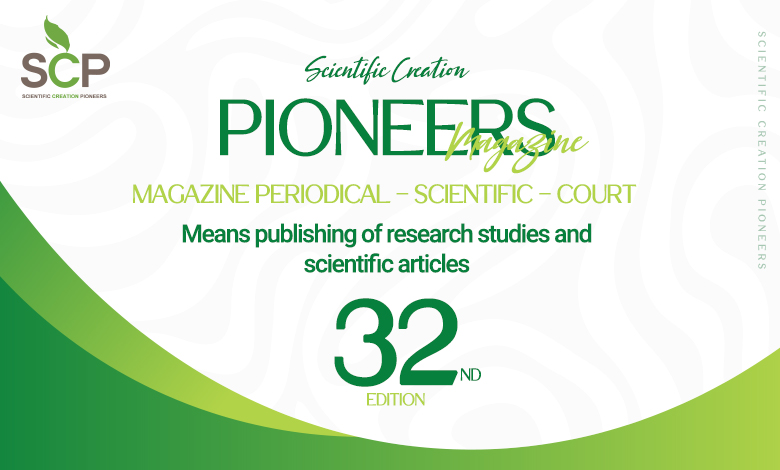
التجديد الديني عند الإمام الشافعي رحمه الله المنهج والأصول
Religious renewal when Imam Shafi'i
ملخص العربي
الشافعي رضي الله عنه أحد أولئك الأئمة المعتبرين في صرح التجديد الإسلامي، بما قدم للأمة من تأليف وعمل فكان من أعلام السلف العاملين ومذهبه في الفقه كما هو معلوم أحد الأربعة المذاهب التي سارت أجيال الإسلام مهتدية بهديها .
ولما كانت العقيدة في أصلها حقيقة الفقه الأكبر والأساس الأعظم الذي ينبني عليه مفاهيم العبادة وتجلياتها العملية رأيت أن أخص هذا البحث بتوضيح معالم التجديد العقدي عند الإمام الشافعي ؛ من خلال ما قدمه من فهوم تجديدية للتعاليم الشرعية في اهم مؤلفاته عميمة النفع . فقد ظهر موافقا لسنن السلف في التمسك بالكتاب والسنة في تقرير العقيدة، شديد التمسك بالهدي النبوي في عرضه لأصول الاعتقاد التي هي أساس الدين وركيزته الكبرى ؛ مع ما تميز به طرحه الفكري من جهود مبرزة في التجديد الديني .
فالتجديد العقدي عند الإمام الشافعي رحمه الله له مقامان مقام أظهر فيه وجوب التمسك بالمنهج السلفي في التلقي عن القرآن الكريم والسنة المطهرة، والآخر في تطبيق تلك القاعدة بما عرضه من فهم لحقائق التنزيل وما تحمله نصوصه من دلالات وفهوم يقوم على أساس التكليف والطاعة .
ومنهجي المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي لمؤلفات الإمام الشافعيt ؛ والمنهج التحليلي لاستخراج أقواله الخاصة ببيان حقيقة التجديد عنده ومفاهيمه التطبيقية ، وما يمكن أن يعرض لأجلها من جهود في الرد على الشبهات التي تخالف حقيقتها ؛ حيث تعرض المسائل في أبواب العقيدة لبيان حقيقة التجديد لديه كما هو معلوم من مناهج أهل السنة والجماعة والتي برزت في آراء الإمام الشافعي .
وقد خرجت من البحث بخلاصة قيمة وهي أن التمسك بالأصول لا يقضي بالتفريط في مشاريع التجديد التي يفرضها الواقع المتجدد والإمام رحمه الله بما أسسه في هذا المجال يعد أسوة لكل من أراد أم يكونلبنة في هذا المضمار الواسع. كلمات مفتاحية : الشافعي ، تجديد ، دين ، منهج ، خطاب
Arabic summary
Al-Shafi’i, may God be pleased with him, is one of those imams who are considered in the edifice of Islamic renewal, with what he presented to the nation in terms of writing and work.
And since the faith is in its origin the reality of the greatest jurisprudence and the greatest foundation upon which the concepts of worship and their practical manifestations are built, I decided to devote this research to clarifying the features of the doctrinal renewal of Imam Al-Shafi’i; Through his innovative understanding of the teachings of Sharia in his most important works of general benefit. It appeared in agreement with the Sunnahs of the predecessors in adhering to the Book and the Sunnah in establishing faith, and strongly adhering to the prophetic guidance in presenting the foundations of belief that are the basis of religion and its major pillar; With what was distinguished by his intellectual presentation of prominent efforts in religious renewal The doctrinal renewal of Imam Al-Shafi’i, may God have mercy on him, has two positions, one in which he showed the necessity of adhering to the Salafi methodology in receiving from the Holy Qur’an and the purified Sunnah, and the other in applying that rule with what he offered of understanding the realities of downloading and the implications and understandings of its texts that are based on assignment and obedience.
And my approach followed in this research is the inductive approach of the works of Imam Al-Shafi’i; And the analytical approach to extract his sayings to clarify the reality of his innovation and its applied concepts, and the efforts that can be presented for it in responding to suspicions that contradict its truth; Where issues are presented in the chapters of faith to show the reality of his renewal, as is known from the approaches of the Sunnis and the community, which emerged in the opinions of Imam Shafi’i..
I came out of the research with a valuable conclusion, which is that adhering to the fundamentals does not require negligence in the renewal projects imposed by the renewed reality, and the imam, may God have mercy on him, with what he established in this field, is an example for everyone who wants to be a brick in this broad field.
Shafi’i, renewal, religion, approach, speech keywords
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد
لما أتم الله تعالى النعمة على هذا الأمة ببعثة سيد المرسلين وختم به النبوة إلى يوم الدين ؛ جعل من تمام منته بتمام بعثته أن هيأ لهذا الدين أئمة وحفظة أثبتوا تعاليمه وثبتوا قواعده برسوخهم في العلوم الأولى التي أخذت عن المعلم الأول نبينا محمد صلى الله عيه وسلم ، والفضل في هذا لله أولا فهو الذي شاءت إرادته أن تبقى رسالة الإسلام خالدة لا تعقبها رسالة ؛ فلا غرو أن نرى أثر هذا التسخير في حفظ الدين برجال أعلام بقي ذكرهم ولا زال غضا طريا ؛ ونذكر من هؤلاء أئمة السلف الأخيار الذين باكروا التاريخ بمؤلفاتهم القيمة والتي خطت لأجيال من بعدهم معالم التجديد والثبات التي هي أساس البقاء واستمرار الوجود على النحو الأول المتقدم ، فلا يملك من أراد الحق إلا أن يعترف لها بالأكملية ؛ في زمن تكاثرت فيه الدعاوى بتجديد الدين على أي نحو يستمر معه الامتداد الزمني ؛ ربما دون التفات كاف لأحقية هذا الامتداد ومدى سلامته من مخالفة الممتد منه . إن الصحة أصل السلامة والعافية تاج يطلبها العليل؛ ومطلبها مع كثرة التعرجات أمر ملح يحسن طلبه وتتبع وجوده .
ومن هنا أتت أهمية هذا الموضوع وفي اختيار الإمام الشافعي محلا لعرض جهود الأئمة الأعلام في تجديد الدين وربما يزداد الأمر تعينا إذا كان الأساس المرام هو تجديد العقيدة والإيمان وإذا كان أصل التجديد في هذا الباب حق أشار إليه الحديث النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الخَلَقُ؛ فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ» [1].
والحديث وإن صرح بأهمية تجديد الإيمان بطريق الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليزداد المؤمن إيمانا فإن تجديده مع تطاول العهد وظهور البدع وحصول الافتراق أمر متعين يحسن اعتباره في أولويات التأليف السني . واعتبار جهود الأئمة الأوائل في هذا المقام مما بشرت به الأحاديث الشريفة فقد ثبت عنه أنه قال « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » [2].
فهذا الحديث الشريف يعد معلما في هدي التجديد حيث أشاد به المصطفى صلى الله عليه وسلم بجهود من يأتي من بعده متأسيا بهديه متمسكا بسنته مبينا أن الحفظ والمعية والقبول والفلاح سيلحق فعله وعمله المبذول في خدمة التجديد الدين وبعثه بما يفسر به حقيقة ذلك التأييد الذي فضل به من سار على موافقة هذه السنة الربانية والبشارة النبوية .
فالشافعي رحمه االله أحد أولئك الأئمة المعتبرين في صرح التجديد الإسلامي، بما قدم للأمة من تأليف وعمل فكان من أعلام السلف العاملين ومذهبه في الفقه كما هو معلوم أحد الأربعة المذاهب التي سارت أجيال الإسلام مهتدية بهديها .
ولما كانت العقيدة في أصلها حقيقة الفقه الأكبر والأساس الأعظم الذي ينبني عليه مفاهيم العبادة وتجلياتها العملية رأيت أن أخص هذا البحث بتوضيح معالم التجديد العقدي عند الإمام الشافعي ؛ من خلال ما قدمه من فهوم تجديدية للتعاليم الشرعية في اهم مؤلفاته عميمة النفع . فقد ظهر موافقا لسنن السلف في التمسك بالكتاب والسنة في تقرير العقيدة، شديد التمسك بالهدي النبوي في عرضه لأصول الاعتقاد التي هي أساس الدين وركيزته الكبرى ؛ مع ما تميز به طرحه الفكري من جهود مبرزة قرعت أسماع التاريخ في مقام التأصيل والبيان لأحكام الإسلام بأصولها وتفرعاتها على نحو أظهر فيه بديع التمسك بالسنة مع تجديد في الفهم عنها والعمل لأجل إحيائها في نفوس المستقبلين لها .
فالتجديد العقدي عند الإمام الشافعي رحمه الله له مقامان مقام أظهر فيه وجوب التمسك بالمنهج السلفي في التلقي عن القرآن الكريم والسنة المطهرة، والآخر في تطبيق تلك القاعدة بما عرضه من فهم لحقائق التنزيل وما تحمله نصوصه من دلالات وفهوم يقوم على أساس التكليف والطاعة .
وكان منهجي المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي لمؤلفات الإمام الشافعيt ؛ والمنهج التحليلي لاستخراج أقواله الخاصة ببيان حقيقة التجديد عنده ومفاهيمه التطبيقية ، وما يمكن أن يعرض لأجلها من جهود في الرد على الشبهات التي تخالف حقيقتها ؛ حيث تعرض المسائل في أبواب العقيدة لبيان حقيقة التجديد لديه كما هو معلوم من مناهج أهل السنة والجماعة والتي برزت في آراء الإمام الشافعي .
وقد سبق هذا البحث بدراسات متنوعة، اذكر منها :
1ـ منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ، رسالة دكتوراة د محمد عبد الوهاب العقيل . وقد عرض فيه المؤلف لآراء الإمام الاعتقادية وأبرزها بصورة تفصيلية .
2ـ آراء الإمام الشافعي العقدية في كتابه الأم ، بحث مقدم في مؤتمر عن الإمام الشافعي ، ل أ وجدي محمد الزيان ، وهو بحث مخصص بإبراز ام المسائل العقدية في كتابا لأم للشافعي .
3ـ موقف الشافعي من علم الكلام ومناهج المتكلمين ، ل إبراهيم ديبو ، بحث في مجلة التجديد العدد 29عام 1432هـ .
4ـ التجديد العقدي عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، رسالة دكتوراة من الباحث موسى بن علي صيرفي . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
5ـ أصول البيان بين الإمام الشافعي والإمام الشاطبي : التأسيس والتجديد ، رسالة دكتوراة من الباحث : ادريس رويبة ، جامعة المولى إسماعيل ، كلية الآداب .
وقد تميز بحثي هنا بتركيزه على الجانب التقعيدي لمنهج الإمام الشافعي رحمه الله في تجديد الدين الإسلامي . أسأل الله التوفيق والسداد .
وأتت الخطة على هذا النحو :
المبحث الأول : تعريف بالإمام الشافعي ومنهجه في التجديد
المبحث الثاني : خصائص التجديد عند الإمام الشافعي
المبحث الثالث : نماذج من تجديد الإمام الشافعي
المبحث الأول : تعريف بالإمام الشافعي ومنهجه في التجديد
أولا : تعريف بالإمام الشافعي
1ـ اسمه : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، القرشي المطلبي الشافعي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف المذكور، وباقي النسب إلى عدنان معروف، لقي جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم.
2ـ مناقبه : كان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم، واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة والعربية والشعر حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين ما لم يجتمع في غيره، حتى قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي، وقال عبد الله بن أحمد[3].
وَفِي (مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ) لِلآبُرِيِّ : سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ بنَ عَبْدِ الوَاحِدِ الهَمَذَانِيَّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عِيْسَى، سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ بنَ سُلَيْمَانَ يَقُوْلُ: ُلِدَ الشَّافِعِيُّ يَوْمَ مَاتَ أَبُو حَنِيْفَةَ – رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى .
وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ مَالِكاً وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً – كَذَا قَالَ، وَالظَّاهِرُ أنَّهُ كَانَ ابْنَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي وَالِي المَدِيْنَةِ، فَكَلَّمَ مَالِكاً، فَقَالَ: اطلُبْ مَنْ يَقْرَأُ لَكَ.
قُلْتُ: أَنَا أَقرَأُ. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، فَكانَ رُبَّمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ قَدْ مَرَّ: أَعِدْهُ. فَأُعِيدُهُ حِفْظاً، فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ، ثُمَّ سَأَلْتُه عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَأَجَابَنِي، ثُمَّ أُخْرَى .
وَيُرْوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَقَمْتُ فِي بُطُوْنِ العَرَبِ عِشْرِيْنَ سَنَةً، آخُذُ أَشعَارَهَا وَلُغَاتِهَا، وَحَفِظْتُ القُرْآنَ. [4]
3ـ مؤلفاته : ومن كتبه (المسند – ط) في الحديث، و (أحكام القرآن – ط) و (السنن – ط) و (الرسالة – ط) في أصول الفقه، منها نسخة كتبت سنة 265 هـ في دار الكتب، و (اختلاف الحديث – ط) و (السبق والرمي) و (فضائل قريش) و (أدب القاضي) و (المواريث) ولابن حجر العسقلاني (توالي التأسيس، بمعالي بن إدريس – ط) في سيرته، ولأحمد بن محمد الحسني الحموي المتوفى سنة 1098 كتاب (الدر النفيس – خ) في نسبه، بدار الكتب (5: 178) وللحافظ عبد الرؤوف المناوي، كتاب (مناقب الإمام الشافعيّ – خ) وللشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة (الإمام الشافعيّ – ط) في سيرته، ولحسين الرفاعيّ (تاريخ الإمام الشافعيّ – ط) ولمحمد أبي زهرة كتاب (الشافعيّ – ط) ولمحمد زكي مبارك رسالة في أن (كتاب الأم لم يؤلفه الشافعيّ وإنما ألفه البويطي – ط) يعني أن البويطي جمعه مما كتب الشافعيّ. وفي طبقات الشافعية للسبكي[5].
**********
ثانيا : منهج الإمام الشافعي في تجديد الدين
التجديد في الدين حقيقة بشرت بها الأحاديث وأتت بمدحه والإعلاء من شأنه كما تبين معنا ، ولهذا نجد أن الكثير من علماء الإسلام اجتهد في تحري مفاهيم التجديد ؛ نيلا لهذا الشرف وتكرمة لهذا الأمة حيث ابتليت العصور الإسلامية بعد النبي عليه الصلاة والسلام بتفشي البدع والمحدثات التي أتى التحذير منها في دلائل التشريع صريحا بينا ؛ وحتى تعلم حقيقة التجديد فإنه لابد من معرفة معنى التجديد في اللغة أولا ؛ حيث تشير المعاجم إلى أن التجديد يطلق على إحداث الشيء بعد اندراسه, وفي المصباح :”الشيء “يَجِدَّ” بالكسر “جِدَّةً” فهو “جَدِيدٌ” وهو خلاف القديم و”جَدَّدَ” فلان الأمر و”أَجَدَّهُ” و”اسْتَجَدَّهُ” إذا أحدثه “فَتَجَدَّدَ” .[6]
“وتجدَّد الشيءُ صار جديداً وأَجَدَّه وجَدَّده واسْتَجَدَّه أَي صَيَّرَهُ جديداً”[7]، وبهذا فإنه” لا يكون التجديد إلاّ بعد استهدام”[8].
وهذا المعنى اللغوي هو مقصود التجديد في الاصطلاح فإن البدع والمخالفات تهدم الدين وتحارب بقاءه ، فيأتي التجديد ليذب عن بناء الإسلام بإعادته على القواعد الصحيحة التي بني عليها أولا ، وبهذا فإن التجديد الديني في الاصطلاح هو القيام بهذه المهمة البنائية الجليلة التي تتسم باقتفاء هدي الأنبياء في دعوتهم للتوحيد مع اختلاف العصور والأزمنة والجماعات ، فكلما صار الناس إلى الشرك شاءت عناية الله أن يخص البشرية بفضل الرسالة لتعيد المعتقد إلى حقيقة التوحيد.
وهذا هو مفهوم التجديد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » [9].
جاء في شرح الحديث أن تجديد الدين إنما يتم بالتزام الطريقة الإسلامية والمبالغة في الاحتياط لحفظها ؛ بإعلاء أعلامها وإحكام أحكامها ورفع منارها ,وتأييد سننها , وتبيينها للناس فالمجدد يجدّد لها دينها أي يبين السنة من البدعة ويذل أهلها[10].
وعليه فإن التجديد لا مفهوم له إلا مع الاختلاف والتباعد عن حقائق الدين ومن ثم طلب العودة إلى تلك الحقائق على الوجه المنبغي من مسالك التجديد التي سنها علماء الأمة الأوائل؛ فإنما تتبين حقائق التجديد بعد الدروس والتصدي لذلك ببذل الجهد على الطريقة المشروعة المتبعة هدي النبي وآله؛[11]يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :” فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولى قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر؛ فاظهر الله به في الإسلام ما كان غريبا “.[12]
وحتى تتضح مفاهيم التجديد من حيث المنهج والموضوع؛ اجتهد الكثير من العلماء في تحديد مجدد كل قرن، حيث دار على حقيقة واحدة وهي أثره في العودة بالمسلمين إلى حقيقة الإسلام الأولى التي عهدها النبي عليه الصلاة والسلام ببلاغ الشرعة ونفي البدعة، ولهذا كان أكبر آثار المجددين بلاغ الدين بحقائقه وتفاصيله العلمية والعملية؛ مع قمع البدع وألوان الشرك ودعوة الناس إلى التزام منهج السني في ذلك كله . لذا رأى اهل العلم عدم حصره في شخص معين وأنه يصدق على كل من نفع الأمة بالدعوة إلى حفظ السنة وقمع البدعة وظهر اثره مميزا ملموسا في تآليفه وتعليمه . [13]
قال ابن كثير : قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم .[14]
***
وهنا يتأكد الحديث عن مفهومية التجديد عند الإمام الشافعي، أما عن اختياره فهو من الظهور بما لا يكاد يخفى على أحد من الأمة حيث برز اسمه على رأس أربعة مذاهب من عصور مبكرة ، فالإمام الشافعي هو الذي ينسب إليه المذهب المعروف باسمه، ومن ثم فاختياره على أنه مجدد يصدق وصفه بالتجديد أثره البالغ في بلاغ الدين وفهمه والذب عن حياضه ، وقد شهد لهذا بهذا الفضل أئمة السلف الأوائل ، روى الإمام البيهقي: أن الإمام أحمد عند ذكر الشافعي روى حديث: ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها )، ثم قال : فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة الأخرى . وروي هذا أيضا عن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم [15].
فكون الشافعي مجدد لهذه الأمة فحل اتفاق؛ حيث اشتهر لقبه بـ (ناصر السنة) لمكانته الجليلة في ذبه عن حياض الدين ونصرته للسنة وقمعه البدع في ذلك الزمان[16]وهنا إنما يتوجه الحديث إلى الكشف عن مكامن الإبداع في طرح الإمام التجديدي في مؤلفاته ؛ فهو وإن بدا متحقق في سيرته ؛ إلا أن مؤلفات الإمام تحوي الكثير من حقائق التجديد فيما قدمه من تحقيقات لمسائل الدين العلمية والعملية الخبرية والأمرية، فحين نكشف عن أسس التجديد لدى الإمام الشافعي نجد أنها تتمحور في جانبين جانب النظرية وجانب التطبيق، فالإمام رحمه الله أظهر بزوغا عظيما في كلا المجالين ، وكتابه الرسالة يؤكد على هذه الأصالة التجديدية لدى الإمام حيث استقر الرأي على فضل هذا الكتاب وعموم الانتفاع به ، قال تلميذه المزني : ” قرأت الرسالة خمس مائة مرة ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة وفي رواية عنه قال أنا أنظر في الرسالة من خمسين سنة ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا واستفدت شيئا لم أكن عرفته”[17].
إن كتاب الرسالة هو الكتاب الأول في أصول التشريع الإسلامي ، ولم يكن بيان الإمام بمعزل عن قضايا الاعتقاد في عرضه للأصول التشريعية ، فالعمل قرين العلم وتصحيحه مراده الأول ؛ وبأسلوب بياني فريد تميزه سلاسة العبارة وجودة التعبير وجدة الأسلوب خط الإمام الشافعي منهج التجديد في بناء الفكر الإيماني والمعتقد السليم في محورين أساسين : المحور الأول : العودة بالمنهج الدلالي المعرفي إلى التمسك بالقرآن والسنة والاستغناء بهما عما سواهما وتعظيم شأنهما ، المحور الثاني : تحديث وسائل المعرفة الأخرى على تنوع مسالكها بين البيان والعقل لفهم الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وحسن الاستنباط منهما . [18]
فالتجديد ظاهر في مشروعه الدلالي الذي جدد فيه الجانب المعرفي للمسائل العملية؛ حيث سلك مسلك الجمع بين مدرسة الحديث التي تظهر عناية بالغة في السنة وحفظها والتزام الصحيح منها، ومدرسة الرأي التي تميل إلى تعظيم مسلك الفهم واستعمال العقل في الترجيح بين الأحكام، فتأصيله لمنهج الاستدلال تجديد بين حيث الالتزام بنصوص الكتاب والسنة مع تخديم المنطق والبيان في فهمها. وهنا نجد تجديد صريح في الغاية والوسيلة
ومع التزام تام بأصول التجديد الديني الذي يحقق معنى التمسك بالقواعد والأسس وعدم الحيدة عنها في شيء بما يتوافق مع حفظ السنة والثبات عليها ، فالتجديد الإسلامي الصحيح عنده ينفي البدعة ويؤكد على معنى الاتباع والطاعة . وإذا علم هذا الأصل تبين أن مفهوم التجديد عند الإمام يقوم على أساس التمسك والثبات بحقائق الدين ومصادره التشريعية الأصيلة حيث التمسك التام بالوحي المحفوظ الكتاب الكريم والسنة المطهرة ؛ وهذا هو منهج المجددين من علماء الإسلام على مر الأزمان .
*****
(المبحث الثاني)
خصائص التجديد عند الإمام الشافعي
في تلك الآونة التي عاشها الإمام الشافعي تعرض المجتمع للوثة الاعراض عن القرآن والسنة والالتفات إلى مسالك محدثة حصل بها الافتتان، حيث ظهر علم الكلام وتفشى مسلك الجهمية في التأويل وظهر الرأي وتعظيم مسالك القياس في الاجتهاد، فانضوى الإمام الشافعي للمذهب السني الأصيل الذي لزم الحق المنبغي في مسلك التلقي والاستدلال؛ فبدى تجديد الإمام في مسلكين أصيلين ؛ أولهما التجديد في لغة الخطاب بالعودة إلى أصالة فهم الحرف والمنطوق البياني واستعماله الصحيح تلقيا عن الصحابة وتابعيهم وعملا بهديهم وسنتهم ، والثاني : التجديد في مسلك التلقي والانقياد بما تتضمنه معاني الخطاب الديني وذلك بطلب العودة إلى التمسك بحقائق الكتاب والسنة الصحيحة واعتمادهما على أنهما مكمن النجاة وطريق الهداية، وهذا ظاهر في مؤلفاته التي تعدد فيها تعظيم هذا المسلك وتقريره على أنه أصل إيماني عظيم يجب التزامه والاعتصام به حتى تخلص الطريقة من البدعة المحدثة التي ورد تحذير الشارع منها عظيما .
فالإمام رحمه الله أولا يعلن حجية الكتاب على جهة المصدرية الأولى في مفهم معاني الإيمان وحقائق التشريع لهذا الدين؛ فيصرح بوجوب الاكتفاء بهدي القرآن في معالجة النوازل الحادثة والتي يلزم لها الحكم مجددا ليتناسب مع مقام حدوثها ، فيكشف بذلك عن عظمة هذا الدين في شموليته وصلاحيته لكل زمان ومكان . يقول في ذلك :
” قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيها.
قال الله تبارك وتعالى: (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) (إبراهيم 1)
وقال: (وأنزلنا إليك الذكر لتبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم ولعلهم يتفكرون) (النحل 44)
وقال: (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمةً وبشرى للمسلمين) (النحل 89)
وقال: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنتَ تدري ما الكتابُ، ولا الإيمانُ، ولكن جعلناه نوراً نَهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (الشورى 52).[19]
فهذه جملة من الأدلة الشاهدة على وجوب الاعتصام بالكتاب الكريم وبيان أن فيه الكفاية في كل ما يحتاجه المجتمع الإنساني لتحقيق الهداية والإيمان وملازمة الصراط المستقيم الذي هو مسلك النجاة في الآخرة وسبيل تحقيق الهداية إليها في الدنيا .
ثم في غير موضع يبين أن هذا الفضل العظيم لكتاب الله إنما تحقق لكمال صفات القائل به تبارك وتعالى ؛ فحفظه الله تعالى له من أن يناله تحريف واختلاف ، قال الشَّافِعِي :” أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه، يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [20] وبهذا تحققت الهداية التامة حيث اتفقت فيه حقائق الصدق وموافقة الحق ” وقال : (لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) فَهَدَى بِكِتَابِهِ , ثُمَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ – صلى الله عليه وسلم بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ”[21].
فالاحتجاج بالقرآن الكريم والتمسك به لمعرفة حقائق الدين وأصوله من مقتضيات الإيمان به ؛ وهذا الأصل الإيماني الذي ظهر فيه تجديد الإمام الشافعي له بإقامة مشروعه الأصولي على أساسه نبراسا لأئمة السلف وأعلام الأمة من علمائها العاملين المجددين ، ظهر في مؤلفاتهم التي قررت حقائق الإسلام وردت عنه البدع المحدثة على اختلافها وتنوعها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على البدع الكلامية الفلسفية المنتشرة :”كل من سمع القرآن من مسلم وكافر علم بالضرورة أنه قد ضمن الهدى والفلاح لمن اتبعه دون من خالفه كما قال تعالى { الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين }”[22].
“وقال : {الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد } فمثل هذا في القرآن كثير مما يبين الله فيه أن كتابه مبين للدين كله موضح لسبيل الهدى كاف لمن اتبعه لا يحتاج معه إلى غيره، يجب اتباعه دون اتباع غيره من السبل . فتنتفي البدعة ويتحقق الكمال .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: ( إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)[23] “[24].
ونقل كلام الإمام الشافعي في تعريفه للبدعة بما يناسب هذا المعنى :” قال الشافعي رضي الله تعالى عنه البدعة بدعتان بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ضلالة ” .[25]
***
وقد ظهر تجديد الإمام الشافعي في إبراز لغة الخطاب في أصول الدين ومبانيه ، حيث التقعيد للمنطق العربي والتعويل عليه في معاني الأدلة من الكتاب والسنة.
قال الشافعي: “والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعةِ الأصول، متشعبةِ الفروع : فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القُرَآن بلسانه، متقاربة، الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ تأكيدَ بيانٍ من بعض. ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب”[26].
واستدل على حجية اللغة العربية في فهم مدارك الخطاب بالآيات الكريمة كما في قوله تعالى : (حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) (الزخرف 1 – 3)
وقال : (قرآناً عربياً غيرَ ذي عِوَجٍ لعلهم يتقون) (الزمر 28)
قال الشافعي: “فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه – جل ثناؤه – كلَّ لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه” .[27]
فنوه بالاستزادة من علوم اللغة لخدمة الفهم فكان هذا تجديدا بارزا في لغة الخطاب ، يقول :”وما ازداد من العلم باللسان، الذي جعله الله لسانَ مَنْ خَتَم به نُبوته، وأنْزَلَ به آخر كتبه: كان خيراً له. كما عليه تَعَلَّمُ الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيتَ، وما أُمِر بإتيانه، ويتوجه لِما وُجِّه له. ويكون تبَعاً فيما افتُرِض عليه، ونُدب إليه، لا متبوعاً”[28].
مع اعتماد مصدر اللغة وعدم الحيدة عن مواكبة الأصول والقيم البيانية التي عرفت بطريقة الناطقين بها تحديدا الصحابة الكرام لمحل الإيمان وخلوص المنطق من شوائب التخليط، قال الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة :”إنهم فوقنا في كل عقل وعلم وفضل وسبب ينال به علم أو يدرك به صواب ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا أو كما قال رحمة الله عليه”[29].
***
وهذا أيضا منهجه في الاحتجاج بالسنة المطهرة في وقت نأي عنها بسبب اشتهار الكثير من الاحاديث الضعيفة والمكذوبة فأعاد الإمام الشافعي رحمه الله بكلماته القوية في كتاب الرسالة الأولية إليها في حجية اعتماد النقل بشرط الصحة والتثبت ؛ قال “الشافعي: ” ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله”
وهذا ما أشاد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج الأئمة السابقين من وجوب انتهاج مسلك الأخذ عن الرسول r مع ما ينبغي من الاحتراز في النقل عنه, فتميز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة , وترد الأقوال المكذوبة والأخبار الموضوعة؛ حفاظا على السنة المطهرة, فـ”السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها؛ هي سنة رسول الله في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات, وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي r الثابتة عنه في أقواله وأفعاله, وما تركه من قول وعمل, ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان”.[30]
وقد استدل الإمام الشافعي لهذه الطريقة بدلائل الكتاب الكريم ، منه قوله تعالى: ( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُزَكِّيهِمْ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) [البقرة: 129] .
وقال جل ثناؤه: ( كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، وَيُزَكِّيكُمْ، وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) [البقرة:151] “[31].
فنوه لبيان أولية السنة المطهرة بالكشف عن مكانتها أولا في القرآن الكريم حيث نوهت هذه الآيات بشأن الاجتجاج بها مصدرا معصوما مع القرآن الكريم واستشهد الإمام لهذا المعنى بما تقدم من الآيات الدالة على الجمع بين القرآن والسنة في المصدرية مؤكدا هذا المعنى من قوله تعالى: ” وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ” [الأحزاب: 34] .
يقول الإمام :”فذكر الله الكتاب، وهو القُرَآن، وذكر الحِكْمَة، فسمعتُ مَنْ أرْضى من أهل العلم بالقُرَآن يقول:[32] الحكمة سنة رسول الله لأن القُرَآن ذُكر وأُتْبِعَتْه الحكمة، وذكرَ الله منَّه على خَلْقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يَجُزْ – والله أعلم – أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنةُ رسول الله. وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتَّم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول: فرضٌ، إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله لِمَا وصفنا، من أنَّ الله جَعَلَ الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به”[33].
فدلالة الاقتران بين شعب الإيمان تدل على أن التفريط فيما كان أصلا فيها يعد ناقضا لما تحقق منها أولا [34].
وهنا بعموم الأدلة التي صرحت بطاعة الرسول ووجوب اتباعه وأن هذا يفيد معنى متضمنا لمكانة السنة لأنها محلا لأقوال الرسول وأوامره ونواهيه الموجهة لاتباعه فلزم من الأمر بطاعته اعتماد ما كان مصدرا لها من سنة النبي القولية والفعلية بل التقريرية أيضا لمكان الإتساء به عليه الصلاة والسلام . قال تعالى : (مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) [النساء: 80] .
يقول الإمام الشافعي :” فأعْلَمَهم أنَّ بَيْعَتهم رسولَه بيعتُه، وكذلك أعْلمهم أنَّ طاعتَهم طاعتُه”[35].
وفي إبراز الإمام لهذا المعنى العظيم في وجوب الاعتصام بالسنة نجده يسلك مسالك عدة في فهم دلالة الآيات ومن ذلك منهج الاستنباط وذلك بإيضاح المعاني المستفادة من النصوص القرآنية والتي تدل بدلالة قوية وغير مباشرة حتى يؤكد أن هذا المعنى مرادا في خطاب الشارع بأوجه متعددة ؛ وبذلك يتبين أن التجديد في الخطاب الديني عند الشافعي توجه بعناية للتجديد في فهم دلالات النصوص بالإشارة إلى معانيها الظاهرة والخفية .
قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء : 65] .
فبعد إيراده سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام قضاه للزبير رضي الله عنه [36].يقول :” وهذا القضاء سنة من رسول الله، لا حُكْمٌ منصوص في القُرَآن.
والقُرَآن يدل – والله أعلم – على ما وصفْتُ، لأنه لو كان قضاءً بالقُرَآن كان حُكماً منصوصاً بكتاب الله، وأشبَهَ أن يكونوا إذا لم يُسَلِّموا لحكم كتاب الله نصًّا غيرَ مُشْكِل الأمر، أنَّهم ليسوا بِمُؤمنين، إذا رَدُّوا حكمَ التنزيل، إذا لم يسلموا له[37].
وفي بيانه لمكانة السنة ووجوب اتباعها من عامة المسلمين المكلفين باتباع الرسول والتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ؛ يلفت الانتباه إلى سلامة هذا المنهج من عامة المزالق إذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لكتابه لا تخالفه وتعارض شيئا مما جاء به بل هي مبينة موضحة لما تقرر بدليله.
ويقرر هذا المعنى بدلالة الاجماع فإن العلم بأن سنة رسول الله الأصل فيها أنه موافقة لا يمكن بحال أن تخالف كتاب الله مما يعلم عند المعنين من اهل العلم الظاهرين في هذا المقام[38].
بل يزيد في إعلاء هذه المعنى ببيان أهمية السنة من كونها قد تاتي مخففة ميسرة لمعاني القرآن الظاهرة ومن ذلك توضيح نصاب الزكاة في المال وأنواعه الواجبة فو لم تكن السمة مبرزة لهذا الجانب لحصل اضطراب وخلط كبير فالسنة عاصمة لأمر التمسك بكتاب الله تعالى .فـ “لولا دِلالةُ السُّنَّةِ كان ظاهرُ القُرَآن أنَّ الأمْوالَ كلَّها سَوَاءٌ، وأنَّ الزكاةَ في جَمِيعِهَا دون بعْضٍ”[39].
وقد أطنب الإمام في هذا الأصل وبين وجوها كثيرة كلها تقرر العلاقة المتكاملة بين الكتاب والسنة في بيان حقائق الدين وأركانه العظمى من الصلاة والصيام والحج ، حيث تفيد السنة في تخصيص العلام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وتقييد المطلق والتفصيل والتحقيق فلا يكون أمرا مجملا في القرآن الكريم إلا وفي السنة ما يبينه ويفيد معناه تطبيقا في سنة الرسول القولية او الفعلية مما ينعكس معه الوثوق من أهمية اتباع السنة وأن التجديد لا يتحقق إلا بالعودة للتمسك بها باعتماد ما صح منها خبرا وفهمه تطبيقا وانتهاجه اهتداء وسنة [40].
****
(المبحث الثالث)
نماذج من تجديد الإمام الشافعي
الإمام رحمه الله قدم رسالة عظيمة النفع في وجوب التزام طريقة الرسول وصحابته الكرام في الإيمان بركائز الدين وأصوله الكبرى وتفاصيله وشرائعه[41] ، بطريقة تجديدية أفرد فيها البيان الديني بلغة أصولية شاهدة على حقائق التقعيد وتطبيقاته ؛ حيث اعتمد الشافعي رحمه الله مسالك التوضيح والبيان والارشاد إلى مآخذ الدلالة من لغة الخطاب العربية في تحرير الشواهد الدالة على الأحكام الواردة في نصوص الآي ؛ مثاله ما تضمن وجوب الإقرار بحقائق التصديق بركائز الدين وكلياته اليقينية الكبرى؛ ففي باب التوحيد والإيمان بالله تعالى وربوبيته؛ نجده ينوه بدلالة العموم على تقرير الإيمان بالله تعالى واعتقاد شمول ربوبيته في خلقه .
قال تعالى : ( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) ” [الزمر:62] .
وقال تبارك وتعالى: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) [إبراهيم:32] ،
وقال: ” وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (6) ” [هود]
يقول الإمام في ضوء هذه الآيات الكريمة :” فهذا عام، لا خاصَّ فيه. فكل شيء، من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك: فالله خَلَقَه، وكل دابة فعلى الله رزقُها، ويَعْلم مُستقَرَّها ومُسْتَوْدعها[42].
وفي هذا المسلك يقرر الإمام رحمه الله أنواع ربوبية الله تعالى لخلقه بدلالة العام والخاص[43]، فالعام ما دل على اشتمال المخلوقات بوصف الخلق فكلهم داخل في معنى مربوبيتهم لخالقهم تبارك وتعالى . وفي اختصاص بعضهم بوصف التقوى خص منهم من تفضل عليهم بعنايته وربوبيته الخاصة؛ حيث نوه إلى هذه المعاني المعلومة من قوله تعالى: ( إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات : 13)
يقول :”فأمَّا العموم منهما، ففي قول الله: ” إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (13) ” [الحجرات] ، فكل نفس خوطبت بهذا، في زمان رسول الله، وقبله وبعده، مخلوقةٌ من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل.
والخاص منها في قول الله: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) ؛ لأن التقوى تكون على من عَقَلَها، وكان من أهلها من البالغين من بني آدم، دون المخلوقين من الدوابّ سِواهم، ودون المغلوبين على عقولهم منهم، والأطفال الذين لم يبلغوا وعُقِل التقوى منهم.
فلا يجوز أن يُوصف بالتقوى وخلافها إلا من عَقَلها وكان من أهلها، أو خالفها فكان من غير أهلها. وهذا المعنى محكي عن أهل العلم المتقدمين والمتأخرين [44].
وفي تقرير برهان الفطرة يقرر دلالة اللغة في دخول التخصيص على أفراد العموم ؛ إذ المعلوم ان الناس في الأصل مجبولين على الإيمان والتوحيد وأن ما دخل فيهم من الشرك خرج منهم مخرج الغالب فلا ينافي أصل وصف من ثبت على التوحيد أولا مع ما ظهر غالبا من الوقوع في الشرك .
ففي قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) [الحج:73] .
يقول:” وبيِّنٌ عند أهل العلم بلسان العرب منهم: أنه إنما يُراد بهذا اللفظ العامِّ المخرجِ بعضُ الناس، دون بعض؛ لأنه لا يُخاطَب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلَهًا، تعالى عما يقولون عُلُوًّا كبيرا؛ لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم، وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها”[45].
ففي تخصيصه بدلالة إمكان التخصيص على أفراد العموم ؛ أخرج من هم دون البلوغ لوضوح حجية الفطرة في قلوبهم ومن هم في حكم الاتباع الذين لا يملكون التصريح بمخالفة العامة . فهذا تحكيم للغة العرب في فهم الخطاب الديني مجددا دون إحداث وبدعة [46].
***
وبمثل هذه الايحاءات الدلالية ذات الطابع البلاغي ؛ يقرر مكانة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليها من وجوب اتباع سنته والاحتكام لشرعته وإقامة منهجه ؛ فقد اقتضى كمال بلاغ المصطفى عليه الصلاة والسلام وعصمته فيه معقولية الإذعان والتسليم له عليه الصلاة والسلام ؛ بأن يطاع فيما علم أنه مبلغا إياه عن ربه وقد عصم فيه من الوقوع في الزلل والريب
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ) [المائدة:67] .
وقال: ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي: مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [الشورى:52]
وقال: ( وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ) [النساء:113] .
يقول :” فأبان الله أنْ قدْ فرَضَ على نبيه اتباعَ أمره، وشهِدَ له بالبلاغ عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نَشْهَدُ له به، تَقَرُّبًا إلى الله بالإيمان به، وتوَسُّلاً إليه بِتَصْديق كَلِمَاتِه.[47]
ومع النصوص التي دلت دلالة صريحة على ثبوت الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام؛ ينبه الإمام إلى مسالك البيان ؛ فبدلالة الاقتران يلفت الانباه إلى وجوب الإيمان بالرسول وأنها من الإيمان بالله تعالى؛ وأن طاعة الرسول واجبة وأنها من جنس طاعة الله .
قال تبارك وتعالى: ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا: ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ. إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ) [النساء:171] .
وقال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ) [النور:62] .
وهذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في دعوة الناس لدينه ومن ذلك قال: (أتَيْتُ رسولَ اللهِ بِجَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ رَقَبَةٌ، أَفَأَعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: أَيْنَ اللهُ؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ: وَمَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: فَأَعْتِقْهَا)[48].
يقول الشافعي:” وضع الله رسوله من دينه وفرْضِه وكتابه، الموضعَ الذي أبان – جل ثناؤه – أنه جعله عَلَمًا لدينه، بما افترض من طاعته، وحرَّم من معصيته، وأبان من فضيلته، بما قَرَن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. ..فجعل كمال ابتداء الإيمان، الذي ما سواه تَبَع له: الإيمانَ بالله ورسوله. فلو آمن عبد به، ولم يؤمن برسوله: لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداً، حتى يؤمن برسوله معه”[49] .
مشيدا بحديث صريح في هذا المعنى ؛ ثبت أنَّ النبيَّ قال: ( لاَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولَ: لاَ أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ ) [50] .
قال الإمام الشافعي” فَقَدْ ضَيَّقَ رسولُ الله على الناسِ أنْ يرُدُّوا أمْرَهُ، بِفَرْضِ اللهِ عليهم اتِّباعَ أَمْرِهِ”[51].
****
والإمام رحمه الله يورد شواهد وأدلة كثيرة على الاعتناء بقواعد البيان والدلالة وأن الخطاب الديني إنما يتوجه فهمه بحقائق الإيمان بالوحي على جهة الكمال والشمول فلا يصح فيه العبث ولا التحكم ولا إرادة البعض دون العض الآخر بل يقرر مكانة الجمع بين دلائل الكتاب والسنة على نحو من الترتيب فالقرآن أولا ثم السنة المطهرة؛ وعلى هذا الأساس العظيم يتحقق الإيمان المنبغي على الوجه المرضي ؛ ففي تقرير حكم الوصية العام الوارد في الآيات ينبه الإمام إلى أن النسخ والتخصيص قد يرد ؛ وبه يصح توجيه الجمع بين مشروعية الوصية والميراث.
ففي قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة:180] .
يقول :”فأنزل الله ميراثَ الوالِدَيْن ومن ورث بعدَهما ومَعَهما من الأقْرَبِين، وميراثَ الزوج من زوجته، والزوجةِ من زوجها. فكانت الآيتان محتملتين لأن تُثْبِتا الوصيةَ للوالدَيْن والأقربين، والوصيَّةَ للزوج، والميراثَ مع الوصايا، فيأخذون بالميراث والوصايا، ومحتملةً بأن تكون المواريث ناسخةً للوَصَايَا. فلَمَّا احتملتْ الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طَلَبُ الدِّلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصاً في كتاب الله، طَلَبُوه في سنة رسول الله، فإن وَجَدوه فما قَبِلُوا عن رسول الله، فَعَنْ اللهِ قَبِلُوهُ، بما افْتَرَضَ مِن طاعته. ووَجدْنا أهلَ الفُتْيَا، ومَنْ حَفِظْنَا عنه مِنْ أهل العلم بالمَغَازِي، مِنْ قُريش وغيرهمْ: لا يختلفون في أنَّ النبي قال عامَ الفَتْحِ: ” لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ “، ويَأْثُرُونه عَنْ مَنْ حَفظوا عنه مِمَّنْ لَقُوا من أهل العلم بالمغازي. فكان هذا نَقْلَ عامَّةٍ عنْ عامَّة، وكان أقوى في بعض الأمْرِ من نقْلِ واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مُجتمعين.”[52]
وفي اعتماده مثل هذه الدلالة المعتمدة على الاستقراء للنصوص الواردة في فهم المراد من الخطاب الشرعي نجده يؤكد على الاحتراز من الانغلاق في الفهم ونفي مايسمى بحرية النص مطلقا ؛ فلا فهم لنص من نصوص الشارع بعيدا عن استقراء ما هو في موضوعه لأن لغة الخطاب تتفق في المصدر فلابد من فهمها بناء على الجمع والتوحيد .
مثاله عند قوله تعالى : ( وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) [البقرة: 24] ، يقول ففدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعضُ الناس، لقول الله: ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى. أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) [الأنبياء:101] .
الخاتمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . فبعد أن ألقيت الضوء على مشروع الإمام الشافعي التجديدي الذي أراده لنصرة السنة وإعادة رونق التشريع لها مع ما أجاد به وأفاد من أنواع الاستدلال البلاغي الصولي في عرض حقائق التأصيل لمنهج الإتباع في هذا البحث أود أن أورد خلاصة النتائج التي توصلت لها على النحو التالي :
ـ يعد الإمام الشافعي أحد عظماء الإسلام في تأصيلهم لحقائق فهم الخطاب الديني متأثرا ببزوغه البياني واللغوي فكان في ذلك أسوة لكل من اتى بعده حيث السلامة والوضح في اعتماده منهج التلقي من الكتاب والسنة وعدم الحيدة عنهما إلى المناهج المحدثة آنذاك .
ـ الاعتماد الظاهر من الإمام في تحريره لمقامات الهداية ودواعي التحقيق بدلائل القرآن الكريم وتحري أوجه الاستشهاد بها في المقام الذي أوردها بشانه مما يفيد كثيرا في فهم المنهج الصحيح عند تحقيق المسائل وإرداة معرفة أوجه الصواب.
ـ الاعتدال الذي نبغ فيه الإمام بين المنهج العقلي والمنهج النقلي حيث أظهر مواكبة علمية بيانية لما اشتهر في عصره من تعظيم العقل دون أن يكون في ذلك تأثيرا على مسلكه السلفي الأصيل في التزام النصوص وحصر التلقي عنها , وذلك بتخديم المنطق والفهم لحجيتها الدلالية دون العكس كما ظهر ذلك في الأزمنة المتأخرة في مشاريع المجددين المجدفين.
ـ ظهر الإمام في مشروعه التجديدي متأسيا بهدي السلف في تعظيم السنة والأثر وتعظيم الحديث الشريف والعناية بالأخذ في السنة الصحيحة في تطبيق الدين والتزام شرائعه. وقد ظهر ذلك جليا في العديد من مواطن استشهاده للأحكام الشرعية وتقريره لما تدله من معاملات أو عبادات .
والحمد لله أولا وآخرا .
المصادر والمراجع
درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية الحراني : دار الكتب العلمية – بيروت – 1997 م. تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن
ـ االمُعْجَمُ الكَبِير للطبراني ، أبو القاسم الطبراني تحقيق: فريق من الباحثين.
ـ المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية – بيروت ـ الطبعة: الأولى، .1990
ـ السلسلة الصحيحة الكاملة محمد ناصر الدين . الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ، الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف)
ـ سنن أبي داود ، سليمان السِّجِسْتاني ـ المحقق: محمد عبد الحميد: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت
ـ المعجم الأوسط، أبو القاسم الطبراني ، المحقق: طارق محمد , عبد المحسن الحسيني : دار الحرمين – القاهرة.
ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، المحقق: محمد عثمان الخشت : دار الكتاب العربي – بيروت ، الطبعة: الأولى، 1405
ـ حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأعيان ابن الحمصي، أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري
الناشر: دارالنخل للطباعة والنشر والتوزيع شسارع فردان – بناية الصباح وصفي الدين
الطبعة الاولى: 1421 هـ – 2000 م
ـ سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبي ـ المحقق : شعيب الأرناؤوط : مؤسسة الرسالة
الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ / 1985 م
ـ الأعلام ، الزركلي الدمشقي: دار العلم للملايين ، الطبعة: الخامسة عشر – أيار / مايو 2002 م.
– المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي : المكتبة العلمية – بيروت.
ـ لسان العرب،ابن منظور الأنصاري : دار صادر – بيروت ، الطبعة: الثالثة – 1414 هـ
ـ جامع الرسائل : تقي الدين ابن تيمية الحراني ، المحقق : د. محمد رشاد سالم : دار العطاء – الرياض ، الطبعة : الأولى 1422هـ – 2001م
ـ التيسير بشرح الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين المناوي : مكتبة الإمام الشافعي – الرياض
الطبعة: الثالثة، 1408هـ – 1988م
ـ مجموع الفتاوى، بن تيمية الحراني ، المحقق: عبد الرحمن بن قاسم: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام النشر: 1416هـ/1995م
ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد ببن حجر العسقلاني : دار المعرفة – بيروت، 1379
ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي القاهري: المكتبة التجارية الكبرى – مصر
الطبعة: الأولى، 1356
ـ معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي ، المحقق: عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، الطبعة: الأولى، 1412هـ – 1991م
ـ مناقب الشافعي للبيهقي ، أبو بكر البيهقي ، المحقق: السيد أحمد صقر : مكتبة دار التراث – القاهرة، الطبعة: الأولى، 1390 هـ – 1970 م.
ـ تاريخ دمشق، بابن عساكر ، المحقق: عمرو العمروي: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
عام النشر: 1415 هـ – 1995 م
-المجموع شرح المهذب : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، الناشر: دار الفكر
ـ تهذيب الأسماء واللغات،محيي الدين النووي : دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
ـ جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر ، المؤلف: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الرياض، الطبعة: الأولى، 1426 هـ – 2005 م
ـ الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي ـ المحقق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، 1358هـ/1940م
ـ تفسير الإمام الشافعي، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي، تحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان : دار التدمرية – السعوديةالطبعة الأولى: 1427 .
ـ الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي :دار المعرفة – بيروت، سنة النشر: 1410هـ/1990م
ـ درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية الحراني ، تحقيق: محمد رشاد سالم: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1411 هـ – 1991 م
ـ صحيح ابن حبان، محمد بن حبان الدارمي، البُستي، المحقق: محمد علي سونمز: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى 1433 هـ- 2013 م
ـ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، محمد ناصر الدين الألباني .
ـ الإيمان الأوسط ، المؤلف: تقي الدين ابن تيمية الحراني ،المحقق: محمود أبو سن
: دار طيبة للنشر – الرياض، الطبعة: الأولى 1422 هـ
ـ الدر المنثور، جلال الدين السيوطي : دار الفكر – بيروت
ـ الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن الآمدي، المحقق: عبد الرزاق عفيفي: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان
-القسم : التفاسير
الكتاب: تفسير العثيمين ، محمد صالح العثيمين: دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض
الطبعة: الأولى، 1425 هـ – 2004 م
ـ صحيح مسلم المسند الصحيح ، مسلم بن الحجاج ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي
: دار إحياء التراث العربي – بيروت
ـ سنن الترمذي ، الترمذي، أبو عيسى ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف : دار الفكر للطباعة والنشر.
-مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني ، المحقق: مكتب البحوث بجمعية المكنز، جمعية المكنز الإسلامي.الطبعة: الأولى، 1431 هـ .
ـ المسند ، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان1400 هـ.
***********
فهرس إجمالي للموضوعات
المقدمة……………………………………………………………………………………………….4
تعريف بالإمام الشافعي……………………………………………………………………………..5
منهجه في التجديد………………………………………………………………………………….7
خصائص التجديد عند الإمام الشافعي…………………………………………………………….10
نماذج من تجديد الإمام الشافعي…………………………………………………………………..13
الخاتمة…………………………………………………………………………………………….14
فهرس المصادر والمراجع……………………………………………………………………….15
[1] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : (13/69) والحاكم في مستدركه : كتاب الإيمان : (1/45) وصححه الألباني في السلسلة برقم : 1585 .
[2] أخرجه أبو داود في سننه ,: 31 – كتاب الملاحم ، 1 – باب ما يذكر في قرن المائة ، حديث 291 ، :(4/480). والطبراني في الأوسط : (6/324), وهو حديث صحيح انظر مجمع الزوائد للهيثمي :(1/212), والمقاصد الحسنة للسخاوي:(203), وقال السيوطي : (اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح … : (1/74). وقال الألباني : والسند صحيح ، ورجاله ثقات ، رجال مسلم [27] . سلسلة الأحاديث الصحيحة :(2/150), رقم 599.
[3] وفيات الأعيان (4/ 163)
[4] سير أعلام النبلاء: (10/ 12)
[6] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , لأحمد لفيومي, : 52. الطبعة الأولى المكتبة العلمية .
[7] لسان العرب لابن منظور, ط الأولى , دار صادر :(1/563).
[8] جامع الرسائل لابن تيمية, ط الأولى , دار العطاء :(5/297).
[9] سبق تخريجه : 4.
[10] شرح الجامع الصغير للمناوي : 3ـ539., ط الثالثة , مكتبة الإمام الشافعي
[11] مجموع الفتاوى : (18/297) .
[12] المرجع السابق :(18/297).
[13] انظر فتح الباري , ابن حجر , مكتبة الرياض الحديثة:(13/295).
[14] فيض القدير , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى : (2/357).
[15] معرفة السنن والآثار للبيهقي : (1/208) . ومناقب الشافعي للبيهقي : (1/55) .
[16] انظر تاريخ دمشق لابن عساكر : (1/25) .
[17] المجموع شرح المهذب : (1/9)، وانظر تهذيب الأسماء واللغات : (1/47) .
[18] انظر جمهرة مقالات أحمد شاكر : (1/157) .
[19] الرسالة : 20.
[20] تفسير الإمام الشافعي (1/ 182)
[21] الأم : (9/57) .
[22] درء تعارض العقل والنقل : (5/374) .
[23] أخرجه ابن حبان في صحيحه : رقم :10: (1/186) , وابن ماجه , رقم : 48: (1/56) . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه : (1/118) .
[24] المرجع السابق :(10/304) . انظر مجموع الفتاوى :(2/4) .
[25] درء التعارض :؛ (1/249) .
[26] الرسالة : (1/21) .
[27] الرسالة : (1/47) .
[28] الرسالة : 49.
[29] درء التعارض : (5/73) .
[30] مجموع الفتاوى ، ابن تيمية : (3/378) .
[31] الرسالة للشافعي (1/ 76)
[32] انظر في أقوال السلف في هذا المعنى : جامع البيان : (20/ 267)
[33] الرسالة :(1/79).
[34] الإيمان الأوسط ، ابن تيمية : 63.
[35] الرسالة : (1/82) .
[36] انظر الدر المأثور في التفسير بالمأثور ، للسيوطي :(2/584).
[37] الرسالة :(1/83ـ 146) .
[38] الرسالة :146.
[39] المرجع السابق : 146.
[40] انظر الرسالة : 222.
[41] انظر درء تعارض العقل والنقل : (1/249).
[42] الرسالة : 56.
[43] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : (2/328) .
[44] انظر تفسير العثيمين : 100.
[45] الرسالة :60.
[46] انظر درء تعارض العقل والنقل :(1/377).
[47] الرسالة : 86.
[48] أخرجه مسلم في صحيحه : باب تحريم الكلام في الصلاة ، رقم : 33: (1:381)
[49] الرسالة :73.
[50] أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، رقم 23876: (39/302). والشافعي في مسنده برقم : 32:ص : 20؟ والترمذي في سننه ، رقم : 2663:(5/37)، وصححه الألباني .
[51] الرسالة :226.
[52] الرسالة : 137.